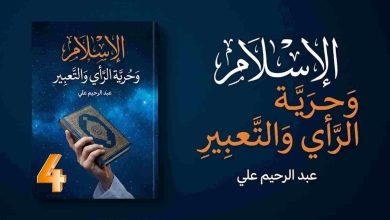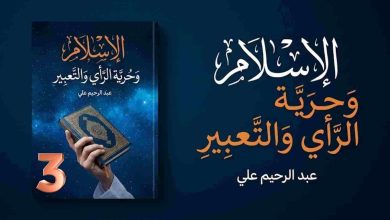تستمر ذكرياتي الطفولية تتراقص في ذهني، محملة بالصور التي لن تُمحى أبداً، حيث لا تقتصر تلك اللحظات على مجرد مشاهد، بل تخلّد في نفسي تاريخاً عميقاً وعلاقات تشابكت فيها القيادة الشعبية مع حب الوطن.
منذ تلك السنوات البعيدة التي عشتها في أسيوط، كانت هناك زيارات رؤساء مصر في احتفالات العيد القومي للمحافظة، تلك التي تركت أثراً لا يُنسى.
لعلني لا أستطيع أن أنسى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981، وتلك التي تلتها في عام 1986 عندما زار الرئيس الراحل حسني مبارك أسيوط.
أكتب هذا المقال اليوم لأنني أحمل في قلبي شعوراً متناقضاً بين الفخر والحزن .. فبينما كانت تلك الزيارات بمثابة احتفاء بتاريخ المحافظة وأبطالها، فإنها كانت أيضاً تذكيراً بصراعات السياسة في مراحل زمنية مختلفة، والتي عبرت عن تغيرات أيديولوجية وتحولات عميقة في المجتمع المصري.
أتذكر كيف اصطففنا نحن، أبناء أسيوط، صغاراً وكباراً على الطرقات، نرتدي الـ تي شيرتات “الفانلات” المطبوع عليها صور رؤسائنا، وهم في نظرنا آنذاك أبطال الأمة.
في زيارة السادات، عام 1981 كان الجميع في انتظار قدومه من مطار منقباد الحربي، حيث كنا نهتف بكل حماسة “بالروح بالدم نفديك يا سادات“.
كنت في الصف الأول الابتدائي، ومشهد الجماهير الطامحة في مشاهدة رئيس الجمهورية كان مثيراً ولا يُنسى. كان الموكب الرئاسي يمر أمام أعيننا، وكأننا نرى حدثاً تاريخياً بأعيننا الصغيرة، وكأن الصورة التي كنا نشاهدها على شاشات التلفزيون قد انتقلت إلى واقعنا المباشر.
وكأننا نلتقي ببطل خارق جاء ليخلصنا من كل همومنا. في تلك اللحظة، كنا نؤمن بأن زيارة الرئيس تعني أن قلوبنا في أيدٍ أمينة، وأن بلدنا بخير طالما أننا تحت قيادة كهذه.
وبعد سنوات قليلة، كرر التاريخ نفسه، ولكن مع رئيس آخر، الرئيس حسني مبارك، في عام 1986 .. قد تكرر المشهد نفسه، وارتدى الجميع صورته على ملابسهم، وعاد الهتاف “بالروح بالدم نفديك يا مبارك“.
كانت الحشود تتوافد من جميع أنحاء أسيوط، وكأن هذا الاحتفال بالعيد القومي هو مهرجان الأمل والتفاؤل. وأعتقد أنه في ذلك الوقت، كانت صور الرؤساء تمثل بالنسبة لنا رمزاً للاستقرار والوحدة الوطنية،
حتى وإن كان الواقع يعكس غير ذلك .. كنا نؤمن بأن وجودهم على رأس القيادة يعني ضمان استقرارنا وأمننا كمواطنين في هذه الأرض الطيبة.
لكن ما أريد أن أطرحه هنا ليس مجرد تذكر تلك الزيارات الرئاسية، بل البحث في مغزى هذه الاحتفالات التي تحمل في طياتها معانٍ أكبر من مجرد احتفال بسيط.
فمحافظة أسيوط، بموقعها الجغرافي والتاريخي، تظل شاهدة على بطولات شعبها عبر العصور. ففي 18 أبريل من كل عام،
نحتفل بذكرى ثورة بني عدي ضد الاحتلال الفرنسي، التي سطر فيها أهل القرية أروع صور البطولة والصمود. ورغم قسوة تلك اللحظات التي سقط فيها الشهداء وامتزجت الأرض بالدماء، فإن ذلك التحدي لم يكن مجرد فداء للوطن، بل أيضاً تحدياً للظروف الصعبة التي مر بها شعب مصر في تلك الحقبة.
تكمن القوة الحقيقية في إصرارهم على مقاومة المحتل، تلك المقاومة التي جعلت من تاريخ أسيوط جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الوطن.
أود أن أقول إن زيارات الرؤساء، على الرغم من طابعها الرسمي والإعلامي، كانت تحمل في طياتها رسائل أعمق تتعلق بالهوية الوطنية.
لكن في الوقت ذاته، لم أستطع أن أتجاهل الفجوة التي كانت تزداد اتساعاً بين الشعب والقيادة. لقد كانت هذه الزيارات، على الرغم من طابعها الاحتفالي، تثير في داخلي العديد من التساؤلات.
هل كانت هذه الزيارات تعبيراً حقيقياً عن الاهتمام بمشاكلنا كأبناء لهذه المحافظة؟ أم كانت مجرد طقوس تكررت كل عام دون أن تحل المشاكل المزمنة التي كانت تواجهنا؟
أذكر كيف كانت أسيوط بحاجة إلى تحسين خدماتها، مثل التعليم والصحة، ولكننا كنا نراهن على الوعود الرسمية التي لم تكن تتجاوز حدود الاحتفال.
تلك الاحتفالات التي كانت محملة بالأمل في البداية، تظل في ذهني اليوم كتذكير بحقائق أكثر مرارة .. فقد كانت زيارات الرؤساء مجرد حدث على هامش الأحداث الكبرى التي شهدتها مصر، وكانت تلك الوعود تتلاشى تدريجياً لتصبح جزءاً من التاريخ، بدون تأثير ملموس على واقع الحياة اليومية لأبناء أسيوط.
عندما أعود اليوم إلى تلك الذكريات، أرى بوضوح كيف كانت تلك الزيارات محاولة لتخفيف الاحتقان الشعبي دون أن تؤدي إلى أي حلول حقيقية.
أصبحت الوعود جزءًا من الماضي، وأصبحت الزيارات مجرد تقاليد ترسخت في الذهنية المصرية دون أن تغير شيئًا في الحياة اليومية.
لكن لا أريد أن أُختم مقالتي على هذه الملاحظات القاسية فقط .. فذكريات الطفولة التي تتعلق بتلك الزيارات تظل حية في ذهني، لأنها كانت بمثابة رسائل أمل وأمل لمستقبل أفضل.
ورغم أننا، نحن أبناء أسيوط، قد عايشنا تلك اللحظات السياسية بمزيج من الحماس والقلق، إلا أننا لا نزال نؤمن بأهمية الوفاء لتاريخنا وحفاظنا على هوية هذه الأرض التي أنجبت أبطالاً في مختلف العصور.
إن تلك الذكريات تظل جزءاً من وجداننا، رغم أنها تحمل في طياتها العديد من التساؤلات التي لم تجد إجاباتها بعد.