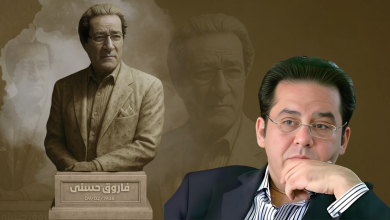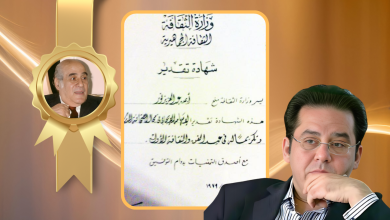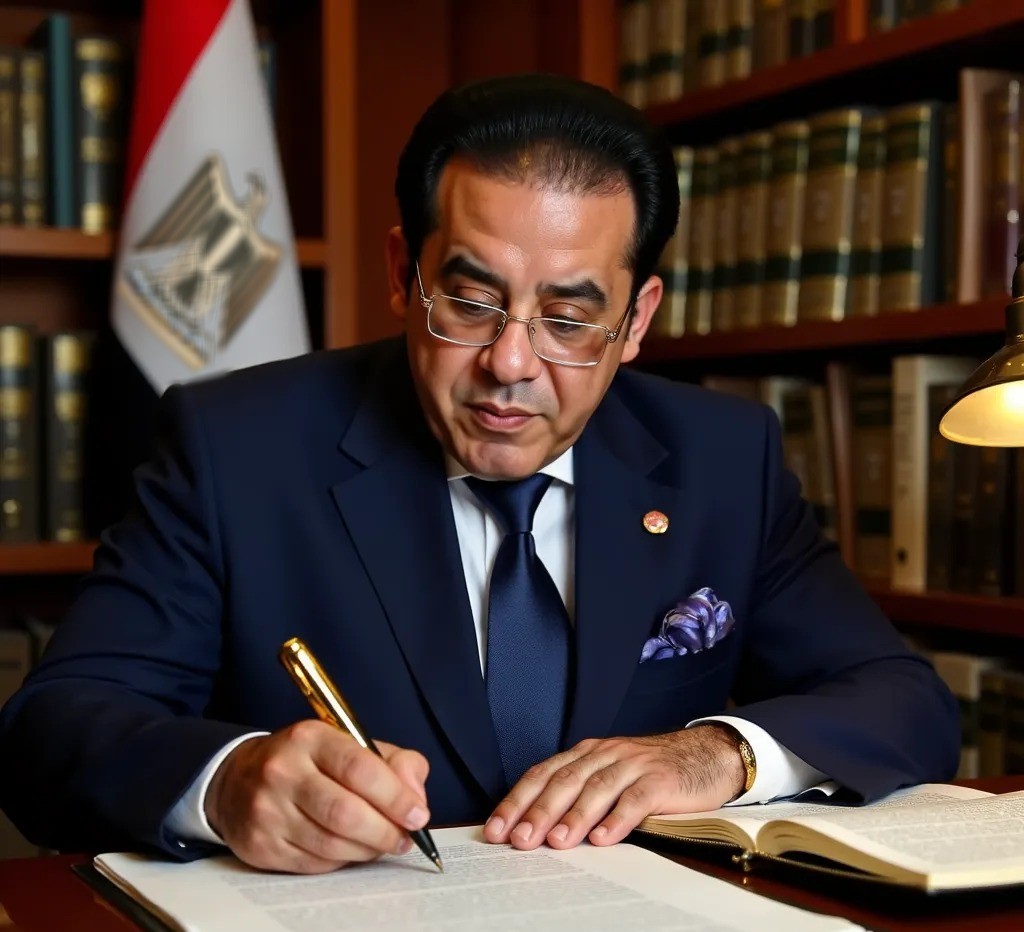
طالعتُ بإعجابٍ شديد مؤلَّفًا جديدًا وعميقًا للمفكّر العربي الكبير د. عزمي بشارة، بعنوان «مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات».
أحد عشر فصلًا، تمتدّ على ما يزيد عن أربعمئة وخمسين صفحة، تنقلك من حقل الفلسفة السياسية إلى مروج علم الاجتماع، لتكتشف أن الدولة ليست بناءً من حجرٍ وسلطةٍ فقط، بل كائنٌ حيٌّ من أفكارٍ ومخاوف، من قيمٍ ومصالح، من بشرٍ يحلمون أن يكونوا مواطنين لا رعايا.
في هذا العمل الفريد، لا يُعيد عزمي بشارة تعريف الدولة، بل يُعيد تفكيك صورتها في وعينا الجمعي.
يواجهنا بسؤالٍ لم نجرؤ يومًا على طرحه: هل نحن من صنع الدولة، أم أنّ الدولة هي التي أعادت تشكيل وعينا حتى ظننّا أننا نصنعها؟
تلك هي لحظة الحقيقة التي يقف عندها كلّ من أراد أن يفهم معنى السيادة وعمق المواطنة، لا ككلماتٍ دستورية، بل كجوهرٍ وجودي لعلاقة الإنسان بالسلطة.
يتنقّل بشارة بين عقولٍ كبرى: من هيغل الذي منح الدولة عقلًا، إلى كارل شميت الذي جعل منها عقيدة، إلى ماكس فيبر الذي منحها شرعية الهيمنة باسم “الاحتكار المشروع للعنف”.
غير أنه، في نهاية المطاف، يعود إلى الإنسان — هذا الكائن الذي ظلّ خارج معادلة السلطة رغم أنه أصلها وغرضها. هنا تبرز عبقرية المؤلف، إذ يعيد وصل ما انقطع بين الفلسفة والسياسة، بين القانون والأخلاق، بين الدولة والضمير.
يكتب بشارة عن الدولة الحديثة بوصفها تجربة إنسانية في البحث عن التوازن بين القوة والعدل، بين النظام والحرية. يرى أن الخطر لا يكمن في حدود الدولة، بل في حدود وعيها بذاتها.
فالسيادة التي لا تعرف سيادة القانون، تتحول إلى طغيانٍ صامتٍ يبتلع كلَّ ما هو إنساني، والمواطنة التي لا تقوم على الكرامة، ليست انتماءً بل استعبادٌ ناعم تحت راية الانتماء.
في زمن العولمة، حين صارت الخرائط أكثر سيولة من الأفكار، يعيد الكتاب إلى الواجهة سؤالًا ظننّا أننا تجاوزناه: هل ما زالت الدولة ممكنة؟
يجيب المؤلف ببرود الفيلسوف وحرارة المصلح: نعم، لكنها لم تعد دولة السيادة المطلقة، بل دولة الإنسان الذي يدرك هشاشته، ويعي أنّ الكرامة الفردية هي آخر ما تبقّى من سيادته.
الأهمّ في هذا العمل ليس ما يقوله المؤلف عن الدولة، بل ما يفتح عيوننا عليه داخلنا نحن. فحين تتأمل الدولة من منظورٍ نقديٍّ إنساني، تكتشف أنّ كلّ فلسفة الحكم هي في جوهرها فلسفة في معنى الإنسان نفسه.
الإنسان الذي يخطئ حين يظن أن الدولة تُنشأ بالقوانين فقط، بينما تُبنى حقًا بالقيم، ويخطئ أكثر حين يتوهّم أن سقوط الدولة يكون بانهيار مؤسساتها، بينما يبدأ فعلًا بانهيار ضمائر من فيها.
لهذا الكتاب سحرٌ خاص، لا لأنه يتحدث عن “نظام الحكم”، بل لأنه يُعرِّي الفرق بين الدولة كفكرة تجمعنا، و”النظام” كسلطة تفرّقنا.
وبينما تموت أنظمةٌ وتتهاوى إمبراطوريات، تبقى الدولة فكرةً أخلاقيةً تقف على ساقَي العدالة والحرية.
إنّ «مسألة الدولة» ليست أطروحة فلسفية فحسب، بل هي تأملٌ طويل في مصير الإنسان حين يُبتلع داخل مؤسساته.
عملٌ يذكّرنا بأن الدولة التي لا تحمي حرية مواطنٍ واحد، فقدت شرعيتها قبل أن تفقد سيادتها، وأنّ الفكر – لا الجغرافيا – هو الذي يحدّد حدودها الحقيقية.
وفي زمنٍ صار فيه الولاء أثمن من الكفاءة، والخوف أرسخ من القانون، يجيء هذا الكتاب كمرآةٍ نادرةٍ تضعنا أمام سؤالٍ مرٍّ وجميل في آن: هل نريد دولةً قوية… أم دولةً عادلة؟
وهل ما زال في مقدورنا أن نحلم بدولةٍ تحيا فينا، لا دولةٍ نحيا فيها؟