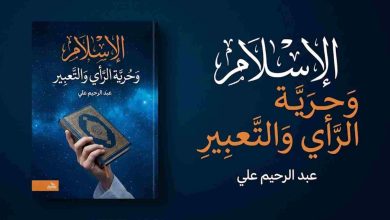ثمانٍ وعشرون تسمية أُعلنت باعتبارها دعمًا للمؤسسة التشريعية، لكنها جاءت كإشارة عكسية، لا تضيف وزنًا ولا تُعيد اعتبارًا لبرلمان كان في أمسّ الحاجة إلى أسماء تمنحه بعض الحيوية والقدرة على الإقناع.
التعيينات الأخيرة لم تحمل روح التصحيح، بل كرّست الإحساس بأن الداخل يُدار بمنطق الحدّ الأدنى. أسماء بلا أثر سياسي واضح، ولا تنوّع يُذكر، ولا رسالة تطمين بأن هناك مراجعة حقيقية لطبيعة الدور المنتظر من البرلمان.
كان المنتظر أن تُشكّل هذه الخطوة جسرًا نحو استعادة قدر من المشروعية، فإذا بها تتحوّل إلى عبء إضافي. قرارات لا تُخطئ فقط في الاختيار، بل تُخطئ في التوقيت، وتكشف عن انفصال مزمن بين حاجة المؤسسة وما يُقدَّم لها.
هذا الاختلال داخل البرلمان ليس تفصيلًا معزولًا، بل امتداد لمنهج أوسع. منهج يُراكم الحركة في الخارج، ويُفرغ الداخل من معناه، ويُعامل السياسة بوصفها ملفًا قابلًا للتجميد لا ضرورة لإحيائه.
بينما تتحرك الدولة إقليميًا بثقة، يبقى الداخل أسير قرارات تُدار بذات العقلية الإدارية التي ترى في المؤسسات واجهات لا مساحات فعل. وهكذا يتقدّم الدور الخارجي، ويتآكل الأساس الداخلي بصمت.
التجارب التاريخية لا ترحم هذا الخلل. الدول التي اكتفت بالثقل الخارجي دون تجديد مؤسساتها دفعت الثمن لاحقًا، حين اكتشفت أن الشرعية لا تُعوّض بالحضور، ولا تُستعاد بالتعيين.
الاقتصاد يُدار بالأرقام، لكن السياسة لا تُدار بلا معنى. وحين يُفصل المساران، تتحوّل الأزمات إلى دورات متكررة، وتصبح المعالجات مؤقتة مهما بدا القرار حاسمًا.
ما تحتاجه الدولة ليس أسماء تُملأ بها المقاعد، بل مسار يُعاد فتحه. مسار يعيد للبرلمان وظيفته، وللسياسة وزنها، وللداخل مكانته التي لا يُغني عنها أي نجاح خارجي.
من دون هذا التوازن ستبقى التعيينات رسائل سلبية، وسيظل الداخل الحلقة الأضعف في معادلة يُراد لها أن تبدو متماسكة، وهي في جوهرها مائلة.