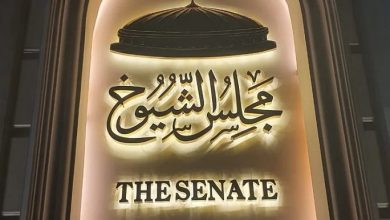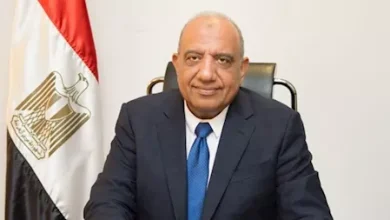السيسي يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية ويحدد الجهات المخولة رسمياً بها

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رسمياً بعد موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق بهدف ضبط الخطاب الديني ومنع الفوضى التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن الفتاوى غير المنضبطة
أوضح القرار أن إصدار الفتاوى العامة لن يكون متاحاً إلا لجهات محددة وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والجهات الأخرى التي يحددها القانون بشرط الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة إصدار الفتاوى
أشار القانون إلى أن إصدار الفتاوى من غير المرخص لهم سيُعد مخالفة صريحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً
أعلن التشريع أن أحكامه تأتي لضمان حماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المغلوطة أو تلك التي تخدم أغراضاً شخصية أو جماعاتية ما يسهم في تقويض الاستقرار المجتمعي
أكد المشرع أن القانون يستهدف مواجهة الفوضى التي أعقبت انتشار بعض القنوات والمنصات غير المرخصة التي تسمح لأشخاص غير مؤهلين بإصدار فتاوى تُحدث بلبلة دينية وتضليل للرأي العام
لفت القانون إلى أن الجهات الرسمية الدينية ستتولى فقط إصدار الفتاوى المتعلقة بالقضايا العامة وليس الشخصية وستُعطى الأولوية للمراجع العلمية المعتمدة وضوابط البحث الفقهي
صرح مصدر برلماني أن صدور هذا القانون يُعد خطوة تشريعية هامة ضمن خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف الديني الذي يستند غالباً إلى تفسيرات خاطئة للشرع
أضاف أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء سيقومان بتشكيل لجان علمية متخصصة للفتوى لضمان وجود مرجعية موثوقة ومؤسسية للفكر الديني المعاصر
نوه خبراء قانونيون بأن تنفيذ القانون سيواجه تحديات في الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية التي تنشر فتاوى دون ترخيص لكن تم التنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأداء
زعم البعض أن القانون سيحد من حرية التعبير الديني لكن المشرعين أكدوا أن الهدف هو حماية الدين من التلاعب وليس تقييد الممارسة الدينية المشروعة وفق الأطر الرسمية
أردف أحد علماء الأزهر أن حصر الفتوى في مؤسسات معتمدة لا يهدف إلى احتكار الفقه بل إلى تأصيله وتقنينه بما يتوافق مع الواقع وحماية للمجتمع من الانقسام
استدرك مسؤول في دار الإفتاء أن القانون لا يشمل الفتاوى الخاصة التي تتم بين الأفراد في خصوصياتهم بل ينحصر فقط في الفتاوى التي تُعلن على العامة عبر وسائل الإعلام والمنصات