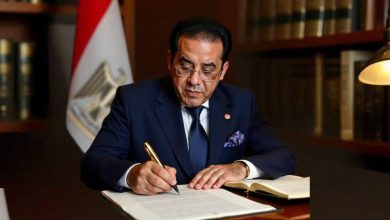عماد الدائمي يكتب : تونس أمام مفترق طرق: بين النموذج الإسباني والتجربة البرتغالية

مفترق حاسم في تاريخ تونس تمرّ تونس
اليوم بلحظة فارقة من تاريخها، لحظة لم يعد فيها الواقع قابلًا للاستمرار، ولا السلطة قادرة على إنتاج حلول، ولا المجتمع مستعدًا لتحمّل مزيد من الفشل والانتظار.
إنها لحظة تشبه في معالمها الكبرى المراحل السابقة لتحوّلات تاريخية كبرى، مثل نهاية دكتاتورية سالازار في البرتغال سنة 1974 عبر انقلاب عسكري سُمّي آنذاك بـ “ثورة القرنفل”، أو نهاية حقبة دكتاتورية فرانكو في إسبانيا في 1977 عبر توافق سياسي واسع اشتهر باسم “اتفاق مونكلوا”، أو تفكك النظام العنصري في جنوب أفريقيا مطلع التسعينيات عبر مسار تفاوضي سلمي أدى إلى إطلاق سراح نيلسون مانديلا وانتخابه رئيسًا، ثم إقرار دستور ديمقراطي جديد أنهى نظام الفصل العنصري.
لحظة لا تُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية أو المواعيد السياسية، بل بالتحولات العميقة في المزاج العام، وفي بنية السلطة وفي موقع الدولة من مجتمعها، ومن محيطها الدولي.
لقد أصبحت الأرقام فاضحةً إلى حدّ لم يعد ينفع معه التمويه أو الإنكار: الدين العام تجاوز 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي العملة الصعبة لم يعد يكفي سوى ثلاثة أشهر من التوريد، والبطالة تضرب 38٪ من خريجي الجامعات، بينما يغادر البلاد سنويًا أكثر من ألف طبيب وثلاثة آلاف مهندس، ناهيك عن عشرات آلاف الشباب الذين يركبون البحر هربًا من مستقبل مسدود.
لكنّ الأخطر من المؤشرات الاقتصادية، هو ما أصبحنا نلمسه من اهتراء المؤسسات، وتفكك الدولة في صمت، وتحول الأجهزة الصلبة من حامية للاستقرار إلى رهينة لسلطة بلا رؤية، وسط تآكل الثقة وانكماش الأمل، وتحوّل المجتمع إلى جزر منفصلة من الغضب أو اللامبالاة.
تونس اليوم ليست فقط في أزمة سياسية أو مالية، بل هي في مواجهة تهديد وجودي شامل يُنذر بسيناريو انهيار بطيء، أشبه بما حصل في فنزويلا أو لبنان.
اتفاق مونكلوا: النموذج الأنسب لتونس
في مواجهة هذا الانهيار متعدد الأبعاد، لا يبدو أن الحل يمكن أن يأتي من طرف واحد أو من مبادرة معزولة، بل من توافق وطني واسع يعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويعيد توزيع الأدوار والمسؤوليات على قاعدة إنقاذ البلاد لا تقاسم الغنائم.
في هذا السياق، تبرز تجربة “اتفاق مونكلوا” في إسبانيا عام 1977 كالنموذج الأقرب لما تحتاجه تونس اليوم. في لحظة انتقالية حرجة أعقبت وفاة الدكتاتور فرانكو، اجتمعت الحكومة بقيادة “أدولفو سواريث” والمعارضة بمختلف أطيافها، على رأسها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE، والحزب الشيوعي PCE، والنقابات العمالية الكبرى مثل UGT وCCOO، في قصر مونكلوا، مقر رئاسة الحكومة، للتوقيع على اتفاق تاريخي هدفه إنقاذ الدولة وتفادي الفوضى.
كان الاتفاق شاملًا، تضمن حزمة إصلاحات اقتصادية صارمة؛ (إصلاحات مالية وضريبية، وإجراءات لخفض العجز الحكومي)، إلى جانب إصلاحات اجتماعية؛ (تعزيز الحريات، وإصلاح الضمان الاجتماعي)، وخريطة طريق سياسية لصياغة دستور ديمقراطي جديد، بالإضافة إلى عفو عام عن السجناء السياسيين.
الرسالة الأعمق في اتفاق مونكلوا كانت واضحة: لا أحدَ قادرًا بمفرده على إنقاذ الوطن. لا حكومة ولا معارضة ولا نقابات ولا جيش ولا مؤسسات أمنية. الإنقاذ لا يكون إلا بتنازلات متبادلة، وشجاعة جماعية للانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التعايش الوطني.
أهم ما ميّز ذلك الاتفاق التاريخي، أنه لم يكن مجرد تسوية تقنية، بل ميثاقًا أخلاقيًا ووطنيًا ارتفعت فيه مصلحة الدولة فوق الحسابات الحزبية والأيديولوجية. تنازل الجميع، وخرج الجميع منتصرًا؛ لأنه في اللحظات المصيرية، لا أحد يربح إذا انهارت الدولة.
وأفضل ما قيل في ذلك الاتفاق كلام الروائي الإسباني خافيير سيركاس: “التحول الحقيقي لا يعني أن ينتصر طرف على آخر، بل أن تنتصر الدولة على الفوضى”.
اليوم، تونس بحاجة إلى مونكلوا تونسي: اتفاق بين أجهزة الدولة والنخب السياسية تشارك فيه النخب الاقتصادية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني، يعيد صياغة الأولويات: الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الجبائية، والحريات العامة، وتحييد المؤسسات، والانتقال الديمقراطي المتدرج.
هذا الخيار، رغم صعوبته، يبقى الأفضل؛ لأنه يُبقي على الدولة، ويُشرك الجميع، ويُطمئن الداخل والخارج، ويضمن استقرارًا طويل الأمد بدل ترحيل الأزمة.
ثورة القرنفل: الإنقاذ من داخل الدولة
لكن في حال استمرّ الانسداد، وتعذر التوافق، ورفضت السلطة الاستجابة للحد الأدنى من شروط الحوار، فقد يلجأ البعض إلى استحضار خيار بديل من الذاكرة السياسية المقارنة: “ثورة القرنفل” في البرتغال سنة 1974.
في تلك التجربة، كانت البلاد ترزح تحت نظام استبدادي عسكري عجوز، فاقد للشرعية، فقررت مجموعة من الضباط الشباب داخل القوات المسلحة أن الوقت قد حان لإنهاء عبث الحكم، واستعادة كرامة الدولة.
لم يكن هناك مجتمع مدني فاعل، ولا طبقة سياسية منظمة، بل فقط شعور بالواجب الوطني لدى فئة من داخل الدولة رفضت الاستمرار في حماية سلطة متهالكة، وقررت إنقاذ الدولة من نظامها قبل أن تفقد مشروعيتها نهائيًا.
وفي صباح 25 أبريل/ نيسان 1974، نزل المواطنون إلى الشوارع دعمًا لحركة الضباط الشباب. وفي مشهد رمزي خالد، وضعت بائعة زهور زهرات قرنفل حمراء في فوهات بنادق عدد من الجنود، فتحولت البنادق من أدوات قمع إلى أدوات حماية للانتقال الديمقراطي، وسُمّيت الثورة بـ”ثورة القرنفل”، تعبيرًا عن طبيعتها الهادئة والنبيلة. فأُسقط النظام دون عنف، وبدأت البرتغال مسارًا ديمقراطيًا جديدًا.
لكن هذا النموذج، رغم رمزيته، يظل استثناءً تاريخيًا مرتبطًا بسياقه الخاص، ولا يمكن اعتباره خطة عمل أو حلًا قابلًا للتعميم.
الدرس المستفاد هنا ليس تشجيع أي تدخل عسكري أو انقلابي، بل التأكيد على أن استمرار تعنّت النخبة الحاكمة وعجزها عن الإنقاذ مع غياب المبادرة من خارج الدولة، قد يدفع أجهزة الدولة إلى إنقاذ ذاتها من الداخل، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية؛ حفاظًا على الاستقرار. ومع ذلك، فإن الحل الأمثل يبقى دائمًا في الإصلاح السلمي والمبادرات المدنية التي تحول دون الوصول إلى مفترق طرق خطير.
بين مونكلوا والقرنفل: فرصة تونس التي لا يجب أن تُهدَر
إذا كان نموذج “مونكلوا” الإسباني يمثل مسارًا للنضج السياسي يقوم على الحوار الوطني والتوافق بين القوى المختلفة، فإن تجربة “ثورة القرنفل” في البرتغال تظل استثناءً تاريخيًا لمواجهة نظام استبدادي منهار.
الفارق الجوهري بينهما هو أن الأول يعتمد على الإرادة الجماعية والمبادرات المدنية، بينما الثاني جاء كتدخل استثنائي من داخل أجهزة الدولة نفسها؛ لحماية مؤسساتها من الانهيار، لا سعيًا للسلطة، بل دفاعًا عن وجود الدولة عندما تُهدر شرعيتها.
تونس اليوم أمام خيارين: مسار توافقي شبيه بمونكلوا يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر إصلاحات حقيقية، أو مخاطر الانزلاق إلى فراغ سياسي ووضع تتآكل فيه السلطة دون بديل بشكل قد يدفع بعض الأطراف إلى البحث عن حلول غير ديمقراطية.
ولتجنب السيناريوهات الخطيرة، يمكن اعتماد خريطة طريق إصلاحية مستلهمة من نموذج “مونكلوا”، لكنها مكيفة مع الواقع التونسي، تقوم على سبع محطات متكاملة:
أولًا: تشكيل مجلس وطني للإنقاذ يضم تحالفًا من قوى مدنية مؤمنة بضرورة التغيير، وطي صفحة الشعبوية والتوجه نحو ديمقراطية فاعلة وإصلاحات هيكلية، ويكون دوره الرئيسي التفاوض مع أجهزة الدولة وضبط أجندة الإنقاذ وإدارة المسار الانتقالي، وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع وفق معادلة جديدة لا تُعيد إنتاج الفشل السابق.
ثانيًا: إطلاق حوار وطني إدماجي يهدف إلى التوصّل لتفاهم سياسي واضح على طبيعة المرحلة المقبلة، وأدوار مختلف الأطراف وآليات التعايش فيما بينها. إعلان
الحوار المطلوب يجب أن يكون مسارًا مؤسسيًا حقيقيًا يُبنى على أسس الاحترام المتبادل، دون استقواء أو إكراه كما كان مسار حوار صائفة 2013، ويُترجم إلى عقد اجتماعي جديد.
ولضمان فاعليته، يجب أن يشارك فيه من يملكون الشرعية السياسية والاجتماعية باعتماد معايير موضوعية، لا على قاعدة التوازنات والتقسيمات القديمة.
ثالثًا: اعتماد إصلاحات اقتصادية عاجلة وعادلة لوقف مسار الانهيار والتصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة. المطلوب خطة إنقاذ اجتماعية واقتصادية ترتكز على حماية الفئات الهشة، والتحكم في التضخم، وترشيد الدعم، وإعادة الثقة للمؤسسات عبر إصلاح جبائي عادل، واستعادة نسق الاستثمار لتوفير مواطن شغل، وتحفيز القطاعات الإنتاجية. على غرار ما تضمّنه اتفاق مونكلوا، فإن مصداقية التغيير تبدأ من إجراءات تعيد التوازن بين السوق المبادرة والدولة العادلة المعدِّلة.
رابعًا: إطلاق سراح مساجين الرأي، وإنهاء التتبعات ضد ضحايا المحاكمات ذات الطابع الانتقامي أو الابتزازي ضمن عفو عام، إذ لا مجال لأي توافق حقيقي دون مصالحة سياسية وأخلاقية مع ضحايا التعسف. وهذا يتطلب إصلاحات فورية لمنظومة العدالة، وإرساء مجلس أعلى للقضاء يكون قادرًا على تطهير السلطة القضائية ورفع المظالم.
كما يتطلب الأمر فتح المجال العام، ورفع القيود عن وسائل الإعلام مع ضمان المسؤولية والتعديل، وإعادة الأحزاب إلى الفضاء العام دون ترهيب أو ابتزاز. المجال العام هو شريان الحياة الديمقراطية، وإذا بقي مُغلقًا، فلن يكون لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي معنى أو عمق.
خامسًا: تحييد المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة الثقة فيهما، بعدما تعرّضتا إليه من توظيف سياسي أفقدهما حيادهما وأربك علاقتهما بالمجتمع. استعادة ثقة التونسيين بأجهزة الدولة تمرّ عبر إصلاح وظيفي وأخلاقي يجعلها حامية للجمهورية لا خادمة للأفراد. على غرار ما حدث في البرتغال إثر “ثورة القرنفل”، فإن تحرّر الأجهزة من الولاء الأعمى يُعيد لها كرامتها وشرعيتها أمام شعبها.
سادسًا: اعتماد تنقيحات دستورية محدودة في نص دستور 2014 عبر مسار تشاركي. تنقيحات تستفيد من دروس تجربة العشرية الماضية، وتضمن تجنب إعادة مناخات الفوضى الهدامة والتناحر بين مؤسسات الدولة، والاختراقات التي أفسدت ديمقراطيتنا الوليدة، وجعلت جزءًا من الشعب يبحث عن الخلاص في أطروحات شعبوية رثّة. سابعًا: تعبئة الموارد الوطنية بالتوازي مع إطلاق حوافز استثمارية فعلية لبناء شراكات تنموية جديدة، وجلب استثمارات وطنية ودولية تُشغّل الشباب وتُنعش الجهات، وتُعيد دم الحياة للاقتصاد الحقيقي. لأن الاستثمار هو الرئة الثانية لنجاح الانتقال. وهذا من أهم الدروس الواجب استخلاصها من تجربة مرحلة ما بعد الثورة. بهذه الرؤية المتكاملة، يمكن لتونس أن تتجنب خيارات اليأس، وتبني طريقًا ثالثًا بين الانهيار والانغلاق. فطريق مونكلوا ليس حلمًا بعيدًا، بل فرصة حقيقية لتأسيس جمهورية جديدة على أسس عقلانية وتشاركية وواقعية.
وإذا لم تُلتقط هذه الفرصة، فقد يجد التاريخ نفسه مضطرًا للعودة إلى السيناريو البرتغالي، حين استشعرت الأجهزة أن حماية كيان الدولة أهم من حماية حاكم متسلّط.
على الأجهزة أن تختار: حماية النظام أم الدولة؟
إن اللحظة التاريخية لا تختبر فقط النخب السياسية، بل تمتحن كذلك الأجهزة السيادية. اليوم، على الأمنيين والعسكريين والإداريين أن يسألوا أنفسهم: هل ولاؤهم لسلطة فردية مؤقتة، أم لدولة دائمة؟
هل واجبهم حماية نظام يضعفهم ويزج بهم في معارك سياسية،
أم حماية مؤسسة الدولة التي تمنحهم شرعيتهم وكرامتهم؟ هل من مصلحتهم ومصلحة البلاد مسايرة نظام شعبوي مغامر فاقد للشرعية والأهلية يعمل على تقسيم التونسيين، وخلق شروط فتنة قد تعصف بالدولة والمجتمع، أم من مصلحة الجميع إنهاء هذا الوضع الخطير الذي يهدّد بالانفجار؟ أيهما أفضل: أن يضعوا أيديهم في أيدي قوى البلاد العقلانية والواعية والمعتدلة من أجل إنقاذ الوضع بشكل استباقي قبل فوات الأوان،
أم الانغلاق والسلبية وإضاعة الفرصة السانحة اليوم والاضطرار ربما غدًا لخطوات مغامرة ليست داخلة في عقيدتهم في صورة أصبح التهديد الوجودي للدولة محققًا ومن الإجرام غضّ الطرف عنه؟
متى تدرك الأجهزة أن تونس لا تحتاج إلى انقلاب. بل تحتاج إلى إدارة عقلانية من داخل الدولة تدفع نحو التغيير بدل مقاومته، نحو الإصلاح بدل الانهيار، ونحو شراكة وطنية بدل المواجهة.
خاتمة: اللحظة ما تزال ملكًا لنا “يبدو الأمر مستحيلًا دائمًا.. حتى يُنجز”، هكذا قال نيلسون مانديلا. قد يبدو التوافق بعيد المنال، لكن موازين القوى في تونس ما تزال قابلة لإعادة التشكيل، وما تزال هناك فسحة حقيقية للتحرك نحو مخرج وطني سلمي وآمن.
إن تونس أمام فرصة تاريخية لتدارك مسار الانحدار، من خلال الالتقاء حول الوطن لا حول المواقع، وبناء مشروع إنقاذ جماعي ينهض من رحم الأزمة.
لسنا أمام خيار بين الأبيض والأسود، بل أمام مفاضلة بين الأفضل الممكن والمخاطر المحفوفة بالاضطرار. المقارنة بين “مونكلوا” و”القرنفل” ليست دعوة إلى مفاضلة جاهزة، بل هي تذكير بأن التوافق الوطني، رغم صعوبته، يظل السبيل الأنجع لتجنّب الخيارات المكلفة وغير المضمونة، وبأن الفرصة الذهبية للحل التوافقي السلمي لن تظل متاحة إلى الأبد.
فليكن التدارك إراديًا قبل أن يُصبح اضطراريًا، والمسؤولية الآن ليست فقط على السلطة، بل على جميع مكونات الوطن. وكما قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: “أسوأ قرار في الأزمات هو عدم اتخاذ قرار”.