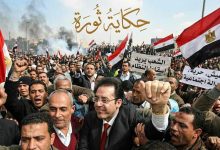الدكتور أيمن نور يكتب: أول حب وأول مواجهة وأول تحدٍ وأول اعتقال

ورقه شخصية جدا من مذكراتي: –
كانت مدرسة الملك الكامل في المنصورة، لا تشبه سواها من المدارس .. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مدخلًا سريًا لعوالم كانت أول جسر ممتدّ بين الطفولة والبلوغ الفكري، بين الصباحات المدرسية والنضوج السياسي المبكّر، في أروقة هذه المدرسة، تنفّست أول معنى للقيادة.
منذ الصف الأول، كنتُ أحمل حقيبة مدرسية، وفيها بيان انتخابي مكتوب بخط فكري غير متماسك، لكنه يحمل نَفَسًا أكبر من عمره.
علي غير المعتاد فزت من الصف الاول برئاسه اتحاد طلاب المدرسة، ثم اتحاد الإدارة، ثم اتحاد المحافظة، ثم اتحاد طلاب الجمهورية. وفي كل مرة كنت أرتقي سُلّمًا لم أصنعه، بل صنعته خطاي.
لم أكن أبحث عن المنصب، بل عن المدى .. عن الحرية، عن المساحة التي أكون فيها (أنا)، وليس غيري. معبرا عن نفسي، عن قناعاتي الإنسانية البسيطة، غير المركبة أيديولوجيا، او المتقعره بعبارات كتب مترجمه، تتحدث عن أوطان أخري لا تشبهنا.
مدرسة الملك الكامل كانت ترقد في منطقة تقع بين حي توريل – الراقي – و حيجديلة، وكانت هذه المنطقه الوسطي، تشهد – وقتها – بدايات لامتداد عمراني، لكنها خلت من مسجد قريب يحتضن السكان الجدد وقت الصلوات،وكانت المدرسة أيضا بلا مصلي للطلاب.
وقتها فكرت في إنشاء مسجد في مساحة خلفية من ارض المدرسة يخدم طلابها وقت الدراسة وأهالي المنطقة في غير أوقات الدرس و تحمّس زملائي في الاتحاد، ووقف بجواري شباب صادقون: نبيل، علاء، مجدي، وآخرون.
وقف أمام مقترحنا، مدير المدرسة الأستاذ رشدي عبد الباري، كان الرجل يساريًّا عتيدًا، يرى في المسجد مشروعًا اجتماعيًا خارج حدود دور المدرسه.
لم يكن الرفض عنيفا، لكنه كان مؤلمًا، لأننا كنا تعودنا من الرجل مساحات من الحرية والتسامح حتي فيتظاهراتنا وفاعلياتنا المناهضة للتطبيع العلاقات مع إسرائيل .
استعنت بصفتي كرئيسًا لاتحاد طلاب الجمهورية، وخاطبت الوزير مصطفى كمال حلمي، الذي كان رائد طلاب الجمهورية. وجاءني الرد بالموافقة، على شرط أن نبنيه بالجهود الذاتية.
بدأت رحلة لا تشبه طفولتنا. جمعنا التبرعات في صناديق خشبية من صنع أيدينا، ووقفنا بها على أبواب المساجد بعد صلوات الجمعة، وطرقنا أبواب أهل الخير.
وكان من بينهم رجل نبيل هو المهندس محمود عبد العزيز، عضو مجلس الآباء، بالمدرسة والذي تكفّل بالبناء حين ضاقت أيدينا.
المسجد كان أول وطن نُشيّده بأظافر صغيرة. لم يكن فقط حجرًا ومئذنة، بل كان أول نصر نعيشه بأقدام حافية .. وأملٍ لا يرتدي ربطة عنق.
قبل هكذا صدام مبكر، كان لدي تجربة شخصية أقل عنفا وأكثر ألما و رومانسيه، وهي تجربة أول حب في حياتي، فلم يأتِ هذا الحب في العاشرة من عمري، كنص في كتاب القراءة .. بل كدعاءٍ خافت في قلب طفل.
كانت من بورسعيد، من أسرة مهجّرة بعد نكسة 67، وسكنت في شارع مجاور لنا في حي توريل بالمنصورة.
كانت العلاقة العائليه وطيده، و كنا نلتقي كل صيف في مصيف جمصة، نصنع من الرمال قصورًا، ومن الصمت اعترافات. لم نقل شيئًا، لكن كل شيء قيل.في صمت مهيب.
كنت أصغر منها بأيام، لكنها كانت أكبر من أي فتاة عرفتها. لم تكن فقط أول من حرّك بصمت وابتسامه طفوليه قلبي، بل هي أول من عرّفني أن الحب لا يُقال .. بل يُرتَجف.
واستمر هذا الشعور، حتى عامي الثاني عشر وتحديدا حتي لحظة سفري للالتحاق بالمدرسة الصيفية ميلفيلد سكول، وكانت عودة أسرتها في نفس هذا الصيف إلى بورسعيد .. فكانت النهاية التي لم نكتبها.
وبعد سنوات، وفي ذات المصيف، “جمصه”طرق بابي شعور آخر، أكثر وضوحًا، ونضوجا، فتاة من عائلة برلمانية كبيرة، تسكن أسرتها بجوار فيلتنا رقم 11،
كنت في السنة الأولى الثانوية، وكنا في ذات السنه الدراسية. وحين أصبحت رئيسًا لاتحاد طلاب الجمهورية، التحقت هي بالتجربة ذاتها.
في العام التالي، ليتم تصعيدها من المدرسة، لاتحاد طلاب محافظة القاهرة، لاتحاد طلاب الجمهورية.كانت بيننا مشاعر، متفتّحة، نبتت في تربة من الثقة والمودّة.
تبادلنا الاهتمام والرعاية أثناء تواجدنا معا بمقر الاتحاد بمركز فتايات الزمالك، ثم تبادلنا الرسائل بخجلٍ منمق، وبدفء يشبه دفء شهور الصيف في جمصة قبل الغروب.
الحكاية نضجت، وكادت أن تُتوّج بموافقة الأهل، لولا أن جاءت الواقعة التي قلبت الموازين. كتبت بيانًا في اتحاد طلاب الجمهورية، أدانت فيه استقبال السادات لشاه إيران، بعد ثورة شعبه. البيان نُظر إليه كإهانة للضيف، وتم اعتقالي لأيام.
تلك الأيام القليلة كانت كافية لإطفاء كل شيء. كانت أسرة الفتاة تمر بأزمة سياسية بالفعل، بعد اعتقال قريب لهم في أحداث الحرم المكي، فكان وجودي في حياتها وقتها بمثابة “حبٌّ ملحٌ على جرحٍ مفتوح”. لا يُنسى، ولا يُحتمل.
انسحبت هي بصمت، دون خصام، ودون تفسير .. ووجدت نفسي في الزنزانة، لا أفتقد فقط الحريّة بقدر ما أفتقد ما هو اهم.
كتبت يومها في دفتري: “لم يكن القيد هو المؤلم .. بل الفقد، حين يأتي ممن كنت أعتقد أنها تحبّك أكثر من حبك لنفسك.
أدركت وقتها أن السجن ليس دائمًا أربعة جدران، بل يمكن أن يكون خذلانًا من الزمن، أو انسحابًا بلا وداع او تفسير مقنع.
مشهد من الدراما الإغريقية القديمة مر علي في ختام فصولاً من مسرحيه الحياة.
بين المسجد الذي شيدناه بإيمان الصبية، والحب الذي عاش ومات في صمت، والاعتقال الذي جاء كمطرٍ فوق جناحين صغيرين .. كانت تلك السنوات تنحتني كتمثال يُتشكل، بلا مطرقة، بل بأظافر الوقت.
لم أبدأ رحلتي السياسية كما يتوهم البعض من قاعة البرلمان، بل بدأت من فيلا صغيرة تطل على البحر في جمصة، ومن بيان مطبوع على ماكينه استنسل مكتوب بآلة كتابة قديمة، ومن حب لم يفصح عنه إلا اليوم !
وارتباط لم يكتمل .
و من أول تحدٍ، وأول خسارة، وأول انتصار .. بدأت حكايتي ولم تنتهي بعد، ،وتبقي بعض النهايات مره كالقهوه الساده لكنها تجعلك مستيقظا..