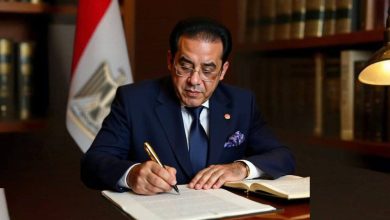مقدمة: هشاشة نظام السيسي اقتصاديًا ومؤسسيًا
يعاني نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليًا من هشاشة غير مسبوقة على الصعيدين الاقتصادي والمؤسسي. فبعد سنوات من سياسات مالية توسعية ومشروعات عملاقة ممولة بالديون، ترزح مصر تحت عبء ديون هائل يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار ، وبلغت مدفوعات خدمة الدين (فوائد وأقساط) حوالي 42.3 مليار دولار في عام 2024 وحده، وهو رقم قياسي لم تشهده مصر من قبل .
وفي الوقت نفسه، تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى قرابة 35 مليار دولار فقط ، مما يقلّص قدرة الدولة على الدفاع عن عملتها أو تمويل وارداتها الحيوية. هذه الأزمة المالية تجلّت آثارها بوضوح في معيشة المواطن؛ إذ ارتفع التضخم لمستويات فلكية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المدن ذروته عند 38% في سبتمبر 2023  قبل أن يتراجع قليلًا مع نهاية 2024، ولكنه بقي في خانة العشرينات العليا. ونتيجة لذلك، تآكلت القوة الشرائية للجنيه المصري بشكل حاد؛ فقد انخفضت قيمته من حوالي 15 جنيهًا للدولار عام 2020 إلى نحو 48 جنيهًا للدولار بحلول أكتوبر 2024  – أي فقدت العملة ثلثي قيمتها خلال أربع سنوات فقط.
هذا الانهيار أدّى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية ودفع بملايين المصريين نحو هاوية الفقر المدقع. وقد ارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% بنهاية 2022 بحسب تقديرات البنك الدولي ، وتشير تقديرات مستقلة إلى أنها ربما تجاوزت 36% في 2023 نتيجة تداعيات الجائحة وحرب أوكرانيا وتعويم العملة . وإزاء هذه الأرقام الصادمة، لم يكن غريبًا أن تتجنب السلطات نشر بيانات الفقر لعام 2023؛ إذ كشف تقرير صحفي أن جهاز الإحصاء الرسمي امتنع عن إعلان النتائج بسبب أوامر أمنية عليا بعد أن أظهرت المسوح ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الفقر يفوق ما يمكن للدولة تبريره  .
على الصعيد المؤسسي والسياسي، بنى السيسي حكمه على أساس من القمع الأمني الشامل وتحجيم المجال العام إلى الحد الأدنى، ما جعل نظامه يفتقر لأي حاضنة سياسية شعبية حقيقية. فمنذ استيلائه على السلطة عام 2013، عطل الحياة الحزبية وقضى عمليًا على المعارضة المدنية؛ حيث استبدل الأحزاب السياسية بائتلافات شكلية تديرها الأجهزة الأمنية  ، وقام باعتقال أو تهميش معظم قيادات العمل السياسي بما في ذلك حتى من أيدوا انقلاب 2013. ورغم تشبيهه أحيانًا بنظام مبارك، فإن السيسي فشل في بناء حزب حاكم قوي أو شبكة ولاءات سياسية كالتي تمتع بها سلفه عبر الحزب الوطني .
ونتيجة لذلك وجد النظام نفسه دون قاعدة مدنية منظمة تستطيع امتصاص الغضب الشعبي أو تنظيم التأييد في أوقات الأزمات  . يعتمد السيسي بشكل شبه حصري على جهاز الدولة الأمني والعسكري في الحكم، مع تمكين غير مسبوق للمخابرات الحربية وإسناد أدوار سياسية واقتصادية واسعة للقوات المسلحة. صحيح أن هذه القبضة الحديدية منعت أي معارضة علنية تُذكر خلال السنوات الماضية، لكنها أيضًا جعلت النظام ضيق القاعدة ومفرط المركزية، حيث تتركز صناعة القرار في يد دائرة ضيقة حول الرئيس.
مثل هذا النموذج من الحكم شديد الشخصنة يكون عرضة للانهيار المفاجئ إذا ما اهتزت ركائز الاستقرار (الأمن والاقتصاد والدعم الخارجي) في آن واحد، إذ لا يمتلك آليات مرنة لامتصاص الصدمات. السؤال لم يعد هل سيسقط نظام السيسي، بل متى وكيف سيحدث ذلك السقوط؟ فيما يلي نستعرض أربعة سيناريوهات محتملة لنهاية هذا النظام، يضاف إليها سيناريو خامس مركّب يجمع كل العوامل، مدعومين بأحدث الأرقام والمؤشرات (2024–2025) التي تؤكد هشاشة الوضع الراهن.
السيناريو الأول: السقوط الشعبي (ثورة الجياع)
أزمة معيشية خانقة: سيدة مصرية تتسوّق في سوق شعبي للخضار بالقاهرة وسط ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء الأساسية.
أخطر ما يواجه أي نظام سلطوي هو انفجار الغضب الشعبي العفوي عندما تصل المعاناة حدًّا لا يُطاق. وفي حالة مصر السيسي، بات شبح “ثورة الجياع” يلوح في الأفق مع تفاقم الأزمات المعيشية للمواطن العادي. فقد بلغت معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وضربت أسعار الغذاء والخدمات أرقامًا قياسية . ارتفعت أسعار المواد الأساسية ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في غضون عامين فقط، ولم يعد كثير من المصريين قادرين على تأمين احتياجاتهم اليومية من الخبز والسكر والزيت.
وقد اعترف رئيس الوزراء نفسه بأن البلاد تواجه “أصعب أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث” . في هذا السياق، اضطرت الحكومة لاتخاذ قرار شديد الحساسية سياسيًا تمثل في رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 1988، حيث تمت مضاعفة سعر الرغيف أربع مرات دفعة واحدة (من 5 قروش إلى 20 قرشًا) في يونيو 2024 . هذا القرار – الذي وصفته فايننشال تايمز بأنه مجازفة قد تفجر اضطرابات اجتماعية – جاء في بلد يشكل الخبز فيه عصب القوت اليومي للملايين. فحتى بعد الزيادة، يبقى سعر الرغيف المدعوم بحدود $0.004 فقط، لكن مجرد رفعه بنسبة 400% أثار موجة غضب وذعر بين الفقراء ومحدودي الدخل  .
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوسوم غاضبة خلال أيام، وتحول الحديث علنًا عن احتمال اندلاع “انتفاضة خبز” جديدة شبيهة بما جرى عام 1977 عندما انتفض المصريون ضد رفع الدعم. الفرق هذه المرة أن الأوضاع أشد قتامة؛ فثلث السكان تقريبًا (نحو 35 مليون مواطن) يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من سوء التغذية ، بينما يتلقى حوالي 69 مليون مصري دعمًا تموينيًا لشراء الخبز وفق آخر الإحصاءات  – أي أن ثلثي الشعب يعتمدون على الخبز المدعوم للبقاء على قيد الحياة.
إن استمرار الغلاء الفاحش وانهيار القدرة الشرائية يخلق خليطًا انفجاريًا قد يؤدي لانفجار اجتماعي في أي لحظة. ورغم القبضة الأمنية الشرسة التي نجحت حتى الآن في وأد أي تحرك احتجاجي في مهده، فإن التاريخ القريب يعلّمنا أن الجوع كافر؛ فحين يبلغ السيل الزبى قد تخرج جموع الناس إلى الشوارع غير عابئة بالرصاص ولا السجون.
ولنا في يناير 2011 عبرة، حين انتفض المصريون ضد نظام مبارك تحت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية بعد سنوات من التهميش الاقتصادي – مع أن الظروف حينها كانت أقل حدة من الكارثة المعيشية الحالية. اليوم، ومع تضاؤل الطبقة الوسطى وسقوط شرائح جديدة تحت خط الفقر  ، يغدو خطر الانفجار الشعبي أكبر من أي وقت مضى. قد تبدأ الشرارة من طوابير الخبز إذا عجزت الدولة عن توفير القمح المستورد أو رفعت الدعم كليًا تحت ضغط الإفلاس.
وقد تندلع من الأرياف المهمشة أو الأحياء العشوائية المكتظة حين يعجز الآباء عن إطعام أطفالهم. وما يزيد احتمال هذا السيناريو هو غياب قنوات التعبير السياسي السلمي؛ فمع إغلاق منافذ الانتخابات والصحافة الحرة والنقابات المستقلة، لم يتبقَ للمواطن المقهور متنفس سوى الانفجار في الشارع. باختصار، ثورة الجياع في مصر لم تعد افتراضًا نظريًا، بل هي احتمال واقعي يتزايد كل يوم تأخير في إنقاذ الاقتصاد. وإذا اندلعت هذه الانتفاضة، فقد تكون عارمة وعفوية إلى حد يخرج عن سيطرة أجهزة الأمن المعتادة، خاصة إذا انضم إليها ملايين اليائسين من مختلف الطبقات.
السيناريو الثاني: السقوط العسكري (انقلاب من الداخل)
من المفارقات أن النظام الذي يحكم بقبضة الجنرالات قد يسقط في نهاية المطاف على أيدي المؤسسة العسكرية نفسها. فالجيش المصري هو العمود الفقري لنظام السيسي، لكنه أيضًا حامِل لواء الدولة الذي قد يضطر للتدخل إذا رأى أن البلاد تنزلق نحو فوضى تهدد وجودها. تاريخيًا، لعب الجيش دور صمام الأمان الذي يتدخل عند الأزمات الكبرى: في فبراير 2011، حين بلغ الغضب الشعبي ذروته، اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة التضحية بمبارك حفاظًا على النظام ككل .
وفي يوليو 2013، أطاح وزير الدفاع (السيسي نفسه آنذاك) بالرئيس المنتخب محمد مرسي تحت ذريعة إنقاذ البلاد استجابة لاحتجاجات شعبية. واليوم، إذا واجه نظام السيسي انتفاضة جياع واسعة أو انهيارًا اقتصاديًا شاملًا، فقد يجد الجيش نفسه مرة أخرى أمام خيار صعب: إما الوقوف مع الرئيس ضد الشعب وما قد يستتبعه ذلك من مجازر وفوضى، وإما إزاحة السيسي أملاً في امتصاص الغضب وإعادة ترتيب البيت من الداخل.
لا شك أن السيسي أدرك هذه المعادلة منذ وقت مبكر وعمل على تحصين نفسه داخل المؤسسة العسكرية قدر الإمكان. فقد أجری عمليات تدوير وتغيير مستمرة في قيادات الجيش والمخابرات لضمان الولاء، وعيّن المقربين منه في مواقع حساسة، بما في ذلك تعيين ابنه محمود في موقع رفيع بجهاز المخابرات العامة بعد تفكيك نفوذها .
كما أغدق امتيازات مالية غير مسبوقة على كبار الضباط؛ إذ ارتفعت رواتب ومعاشات العسكريين عشرة أضعاف خلال 2014–2019، متجاوزة بكثير زيادات القطاع المدني . ومنح الجيش سيطرة على مشاريع اقتصادية ضخمة ليصبح لاعبًا اقتصاديًا مهيمِنًا (من البنية التحتية إلى الغذاء) . هذه السياسة جعلت الجيش شريكًا اقتصاديًا في الحكم، وضمنت ولاء شريحة واسعة من قياداته المستفيدة من الوضع القائم. لكن في المقابل، تسببت أيضًا في استياء دفين بين بعض ضباط الصف والكوادر الأصغر سنًا الذين يرون تمييزًا هائلًا لصالح قلة من المحظيين.
بحسب تحليل نُشر في موقع ميدل إيست آي، هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية قد تواجه الجيش مع تفاقم الأوضاع  : أولها أن يستمر السيسي في سياساته الحالية من بيع الأصول وتقشف وإقصاء المعارضة، مما قد يؤجل الانفجار الشعبي لكنه يُطيل أمد عدم الاستقرار ويضع المؤسسة العسكرية أمام مخاطر بعيدة المدى.
ثانيها أن يتدخل الجيش لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي – إما عبر اتفاق مع السيسي على تغيير النهج، أو عبر انقلاب عسكري يطيح به إذا استعصى الحل . وثالثها اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة تجبر الجيش على التدخل لإزالة السيسي تفاديًا لانهيار كامل . وفي السيناريوهين الثاني والثالث، سيكون تحرك الجيش مدفوعًا برغبته في حماية مصالحه المؤسسية ومنع تفكك الدولة، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الجيش للكشف عن أنشطته الاقتصادية ضمن برامج الإصلاح . فصندوق النقد الدولي مثلاً وضع شفافية شركات الجيش شرطًا للحصول على الدعم، ما أحرج العسكر وأثار قلقهم من فقدان امتيازاتهم الحصرية.
لا يعني ذلك أن انقلابًا عسكريًا وشيك أو سهل؛ فالسيسي نجح خلال عقد من الحكم في إحكام قبضته على مفاصل المؤسسة الأمنية وتجنب بروز منافسين أقوياء. لكن ولاء الجيوش قد يكون للدولة قبل الشخص. فإذا قدّر كبار القادة أن بقاء السيسي بات عبئًا يهدد بانهيار النظام بالكامل أو بتدخل خارجي، فقد يُقدِمون على تنحيته في “انقلاب قصري ناعم”، ربما بتنسيق مع قوى دولية لضمان الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
وقد يكون هذا التحرك على شاكلة “مجلس إنقاذ” يقوده الجيش مؤقتًا كما حدث عقب تنحي مبارك. بعبارة أخرى، قد يلجأ الجيش للخروج بنفسه من معادلة السيسي حفاظًا على نفسه. وحينها سنشهد تكرارًا لسيناريو مألوف في دول المنطقة: نظام عسكري يُسقط رأسه كي يستمر هيكل الدولة العميقة، ربما مع تغيير في الوجوه والسياسات لامتصاص الغضب الشعبي. هذا السيناريو انقلاب القصر يظل احتمالًا قائمًا كلما اقتربت الدولة من حافة الانهيار الشامل، خاصة إذا تزامن مع السيناريوهات الأخرى كالهبّة الشعبية أو الإفلاس المالي.
السيناريو الثالث: السقوط الاقتصادي (إفلاس الدولة)
في هذا السيناريو، لا يسقط النظام بفعل المظاهرات أو الانقلابات، بل ينهار اقتصاديًا من تلقاء نفسه تحت وطأة الديون وفشل السياسات المالية، مما يشل قدرة الدولة على تأدية وظائفها الأساسية ويمهد للفوضى. قبل عام فقط، كان مراقبون اقتصاديون مرموقون يحذرون من أن مصر على شفا التخلف عن سداد ديونها الخارجية. وصنّفت تحليلات بلومبرغ الاقتصادية مصر كـ“ثاني أكثر دولة في العالم عرضة لخطر التخلف عن سداد الديون” بعد أوكرانيا التي تمزقها الحرب  . هذه النتيجة لم تأتِ من فراغ؛ فمصر أصبحت أحد أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي (بإجمالي قروض 20 مليار دولار منذ 2016 وزيادة برنامجها الأخير إلى 8 مليارات )، وفاقت مدفوعات ديونها السنوية قدرة إيراداتها.
في عام 2024 وحده، كان على مصر سداد أكثر من 29 مليار دولار خدمةً لديونها الخارجية ، وهو مبلغ ضخم استنزف الاحتياطي النقدي وكاد يعجز البنك المركزي عن تدبيره لولا مساعدات خارجية عاجلة. وقد اضطرت الحكومة إلى إجراءات طارئة لتفادي الوقوع في المحظور، منها بيع حصص في شركات وبنوك حكومية واستثمارات سيادية لجمع العملة الصعبة، وكذلك إرجاء سداد بعض المستحقات وتأجيل مشروعات تنموية. وبرغم ذلك، لا تزال مؤشراتها المالية في منطقة الخطر بشهادة وكالات التصنيف الدولية؛ فقد خفضت وكالة موديز تصنيف مصر إلى Caa1 في 2023، ما يعني ارتفاع احتمالات التخلف عن السداد ، بينما أبقت فيتش التصنيف في فئة B-/B (عميق في منطقة غير الاستثمارية) مع نظرة مستقبلية سلبية .
إن إفلاس الدولة لم يعد تصورًا نظريًا تمامًا؛ فقد كادت مصر تلامسه في نهاية 2022 عندما شهدت نقصًا حادًا في العملة الأجنبية وعجزًا عن تمويل الواردات الحيوية كالوقود والقمح  . ما منع وقوع الكارثة حينها هو تدخل عاجل من دول الخليج ومؤسسات دولية بضخ قروض واستثمارات بمليارات الدولارات . أبرزها صفقة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير ساحل رأس الحكمة ، إلى جانب حزمة دعم بقيمة 22 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي .
تلك الأموال وفرت سيولة مؤقتة أتاحت لمصر سداد التزاماتها في 2024 وتجنب التخلف عن الدفع . لكن هذه الحلول في مجملها كانت مسكنات مؤقتة لم تعالج أصل المرض. فالمشكلة الهيكلية باقية: دين عام يتضخم (حوالي 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024 )، وعجز موازنة مزمن يتجاوز 7%، و فاتورة واردات ضخمة (قرابة 90 مليار دولار سنويًا مقابل صادرات بنصف هذا الرقم فقط ). والأسوأ أن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات هو مواد غذائية وأساسية لا يمكن تقليصها دون اضطرابات اجتماعية. أي أن الدولة عالقة في حلقة مفرغة: اقتراض لسداد القروض وشراء الأساسيات، ثم خدمة ديون تستنزف الموارد وتستدعي مزيدًا من الاقتراض. وقد حذر خبراء اقتصاد بأن أزمة مصر قد تصبح “أكبر من أن تُنقذ” إذا استمر هذا المنوال .
سيناريو الانهيار الاقتصادي الكامل قد يتجسد في عدة أشكال: انهيار جديد وحاد في قيمة الجنيه إلى مستويات تفوق قدرة الناس على التكيف (وربما إلى تضخم مرتفع تضيع معها المدخرات تمامًا)؛ أو تعثر الدولة رسميًا في سداد أقساط ديون خارجية ما يؤدي إلى تصنيفها دولة مفلسة ويغلق أبواب الاقتراض ويضعها تحت وصاية الدائنين؛ أو عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين ودعم السلع الأساسية مما قد يشل المرافق ويطلق موجات احتجاج ونهب للفقراء اليائسين. في جميع هذه الحالات، ستكون النتيجة فقدان النظام لآخر ما تبقى من شرعية في أعين الشعب. فالقمع يمكن أن يمنع مظاهرة، لكنه لا يستطيع إجبار بطن جائع على الصبر للأبد. وإذا وصلت مصر إلى لحظة تعجز فيها البنوك عن توفير الدولار لاستيراد القمح أو الوقود، سنكون أمام مشهد انهيار سريع لكل مؤسسات الدولة، بحيث لن تنفع القبضة الأمنية حينها في لجم الفوضى.
سيناريو الإفلاس يختلف عن السيناريو الشعبي في أن الشرارة تأتي من انهيار البنى المالية أولًا، لكن مفاعيله تتقاطع فورًا مع الشارع والسياسة. وقد تبدأ ملامحه الكارثية بالظهور تدريجيًا؛ مثل اختفاء سلع أساسية من الأسواق، طوابير وقود طويلة، انقطاع كهرباء متكرر لعدم توفر الوقود، وصولًا إلى انتشار الجريمة والاضطرابات بسبب شلل الدولة. وعندما يعجز النظام عن توفير الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، فإنه يفقد عمليًا مبرر وجوده، وحينها قد نشهد سقوطه كبيت العنكبوت من الداخل قبل حتى أن يسقطه أحد من الخارج. وهذا يفتح الباب تلقائيًا لسيناريوهات أخرى: انتفاضة شعبية واسعة، أو تدخل الجيش كما أسلفنا، لكن في ظل اقتصاد منهار وعملة بلا قيمة.
السيناريو الرابع: السقوط السياسي الخارجي (سحب الدعم الدولي)
منذ انقلاب 2013، اعتمد نظام السيسي بشكل جوهري على دعم خارجي مكثف لضمان استمراره، سواء دعم مالي واقتصادي من حلفائه الإقليميين، أو دعم سياسي ودبلوماسي من القوى الكبرى. وقد شكّل هذا الدعم شبكة أمان حمت النظام من العديد من الهزات. أبرز مظاهر ذلك هي المساعدات السخية من دول الخليج (السعودية والإمارات خصوصًا) التي ضخت مليارات الدولارات في الخزينة المصرية على شكل منح وودائع واستثمارات منذ 2013، فضلاً عن إمدادات نفطية ميسرة. وبالتوازي، وفّرت الولايات المتحدة مظلة حماية دولية، حيث استمرت في تقديم مساعدات عسكرية سنوية لمصر بنحو 1.3 مليار دولار ، وغضّت الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان حرصًا على استمرار التعاون الأمني ومعاهدة السلام مع إسرائيل.
كما استخدمت واشنطن نفوذها في المؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدولي) لتسهيل حصول مصر على البرامج التمويلية اللازمة عندما ضاقت بها السبل . كذلك تلكأت العواصم الأوروبية في انتقاد سجل السيسي الحقوقي، واعتبرت استقراره ضمانة لمنع موجات هجرة غير نظامية عبر المتوسط وكبح الإرهاب في المنطقة.
غير أن تعويل النظام المفرط على الدعم الخارجي يجعله عرضة للانكشاف إذا ما قرر الداعمون تغيير موقفهم. ففي السنوات الأخيرة، بدأت بعض التحولات تشير إلى تململ أو تغيير حسابات لدى الحلفاء. دول الخليج، التي ضخت ما يقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد المصري منذ 2013، باتت الآن أكثر تحفظًا في الإنفاق الإنقاذي. فمع ارتفاع تكاليف الحرب في اليمن وضغوط موازناتها، ومع شعورها بأن مساعداتها السابقة أسيء استخدامها في مشاريع ضخمة غير منتجة، أصبحت تشترط استثمارات طويلة الأجل بدل المنح المجانية.
على سبيل المثال، تأخر دعم الرياض وأبوظبي في خضم أزمة 2022–2023 إلى أن وافقت القاهرة على برنامج خصخصة واسع، ثم جاءت المساعدات في صورة صفقات استحواذ على أصول مصرية (كالبنوك وشركات الطاقة) أكثر منها ودائع مجانية. وفي تصريح لافت في منتدى دافوس 2023، قال وزير المالية السعودي صراحة: “لن نقدم بعد الآن مساعدات دون شروط، على مصر أن تقوم بإصلاحات مؤلمة”. هذا التبدل يعني أنه إذا تخلفت القاهرة عن تنفيذ المطلوب إصلاحيًا، فقد تغلق صنابير الدعم الخليجي جزئيًا أو كليًا، مما يضع النظام في مأزق كبير.
أما الدعم الأمريكي والأوروبي، فعلى الرغم من استمراره حتى الآن بدافع المصالح الإستراتيجية، إلا أنه هو الآخر يواجه ضغوطًا متزايدة. في واشنطن، أصوات في الكونغرس – ديمقراطية وجمهورية – تنتقد الشيك المفتوح للسيسي رغم استمرار الانتهاكات. وقد أعاد نواب بارزون إحياء تكتل حقوق الإنسان المصري في الكونغرس للمطالبة بربط المساعدات بتقدم حقيقي في ملف حقوق الإنسان . ورغم أن إدارة بايدن قررت في 2024 الإفراج عن كامل المساعدات العسكرية لمصر وتجاهل شروط حقوق الإنسان ، إلا أن هذا القرار قوبل بانتقادات حقوقية ودفع منظمات في واشنطن للمطالبة بفرض عقوبات فردية على مسؤولين مصريين.
هيومن رايتس فيرست (منظمة حقوقية أمريكية) دعت مؤخرًا الحكومة الأمريكية إلى استخدام قانون ماغنيتسكي لفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات على مسؤول مصري كبير وشركة أمريكية متواطئة بانتهاكات . هذه الأجواء تعكس تنامي القناعة بأن غض الطرف الأمريكي الحالي قد لا يستمر للأبد، خصوصًا إذا تغيرت الإدارة أو طرأت أزمة تجعل دعم السيسي مكلفًا سياسياً (كحادثة قتل الباحث الإيطالي ريجيني سابقًا التي أثارت غضبًا أوروبيًا محدودًا، أو أي حدث مشابه مستقبلاً).
لعل حرب غزة 2023 كانت اختبارًا مهمًا لعلاقات السيسي الخارجية؛ إذ واجه ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية لفتح حدود سيناء أمام نازحين فلسطينيين، وهو ما اعتبره خطرًا أمنيًا وجوديًا على حكمه فرفض بشدة. ورغم أن واشنطن لم تعاقبه على الرفض، فإن الواقعة ذكّرت الجميع بمدى اعتماد الجيش المصري على الرضا الأمريكي (إذ تزامنت مع توقيت حرج كان يُفترض أن تُحجب فيه 10% من المعونة لاعتبارات حقوقية، فاختارت الإدارة إطلاقها كاملة مراعاة لدور مصر في غزة ).
لكن ماذا لو قررت واشنطن في ظرف ما تغيير تعاملها مع القاهرة من الاحتواء إلى الضغط؟ إن سحب الغطاء الدولي عن نظام السيسي سيكون بمثابة ضربة قاتلة، فاقتصاده المتهالك لا يستطيع الصمود دون قروض ومساعدات، وجيشه المدجج بالسلاح الأمريكي سيتضرر عمليًا إذا توقفت قطع الغيار والتدريب. كما أن أي إشارة خضراء من الغرب يمكن أن تطلق يد مؤسسات مثل صندوق النقد لممارسة أقسى الضغوط المالية، أو يد الاتحاد الأوروبي لفرض قيود تجارية واستثمارية. يضاف إلى ذلك احتمال تغير الموقف الإقليمي؛ فمثلاً إذا انشغلت أو تراجعت إمكانات داعميه الخليجيين (بسبب انخفاض أسعار النفط أو اضطرابات داخلية لديهم)، سيجد النظام نفسه وحيدًا في العراء.
بعبارة واضحة، نظام السيسي يعيش حاليًا على الأوكسجين الخارجي. فإن قطع عنه هذا الأوكسجين – أو حتى خُفِّض – سيواجه اختناقًا سريعًا. ويمكن أن نشبه وضعه بمنصة مرتفعة يقف عليها، وهي الدعم الدولي؛ فإذا سُحبت المنصة انهار الرجل في لحظات. هذا “الانهيار الخارجي” قد لا يأتي بشكل صدامي مباشر (كأن يعلن الغرب معاداته مثلاً)، بل يكفي أن تُرفع الحماية والمساندة ليواجه النظام مصيره.
وقد رأينا عبر التاريخ كيف سقطت أنظمة استبدادية بمجرد تغير المزاج الدولي تجاهها؛ فالنظام الأبارثيدي في جنوب أفريقيا ترنح عندما فُرضت عليه عقوبات شاملة وعُزل دوليًا، وأنظمة أميركا اللاتينية الدكتاتورية تهاوت حين أوقفت واشنطن دعمها في الثمانينيات. وفي حالة مصر، قد لا نكون بعيدين عن مثل هذا السيناريو إذا تضافرت عوامل عدة: استمرار القمع الوحشي بلا تحسين، واستمرار الأزمة الاقتصادية بلا حل، وبروز قيادة دولية تعتبر بقاء السيسي عبئًا على مصالحها أكثر من رحيله. عندها سيكتشف النظام أنه بلا أصدقاء حقيقيين، وربما يجد الجيش نفسه بلا غطاء دولي لأول مرة ما قد يعجّل بالتفكير في تغيير القيادة حفاظًا على العلاقة مع الداعمين الخارجيين .
السيناريو الخامس: الانهيار المفاجئ متعدد الجبهات
هذا السيناريو الأخير يجمع عناصر من السيناريوهات الأربعة السابقة في عاصفة كاملة تؤدي إلى سقوط مفاجئ وسريع للنظام على كافة المحاور. فبدلًا من أن يتحقق كل سيناريو بمعزل عن الآخر أو على مراحل، يمكن تصور وضع تنهار فيه جبهات الاقتصاد والشارع والمؤسسة العسكرية والدعم الخارجي في وقت متزامن أو متقارب، مما يجعل أي محاولة لإنقاذ النظام مستحيلة. قد يبدو هذا السيناريو دراماتيكيًا، لكنه ليس مستبعدًا كليًا في ضوء درجة الهشاشة الحالية. تخيل مثلًا المشهد التالي: تتراجع احتياطيات البنك المركزي لمستوى حرج يجعل الحكومة عاجزة عن توفير العملة الصعبة لاستيراد القمح والوقود، فيبدأ تقنين الخبز والوقود وتنشب طوابير طويلة ونقص حاد في السلع.
يتزامن ذلك مع هبوط جديد حاد لقيمة الجنيه إثر فقدان الأسواق الثقة تمامًا بالاقتصاد المصري، ما يشعل موجة تضخم جنونية تجعل حتى الطبقة الوسطى غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية. على وقع هذا الانهيار المعيشي، تندلع احتجاجات شعبية عارمة وعفوية في عدة مدن وقرى دفعة واحدة، يتخللها أعمال شغب ونهب في بعض المناطق بسبب الجوع وانفلات الأمن. تحاول الشرطة والأمن المركزي قمع المتظاهرين بالأساليب المعتادة، لكن الأعداد الغاضبة هذه المرة تفوق السيطرة، وقد تبدأ تظهر شقوق داخل الأجهزة الأمنية نفسها مع إنهاكها في مواجهة جماهير غاضبة ليل نهار.
في خضم الفوضى، يجد الجيش أن الوضع خرج عن السيطرة المدنية وأن سمعة القوات المسلحة على المحك، فيقرر قادة عسكريون التحرك. قد يُعلن الجيش عبر بيان متلفز إقالة الرئيس من منصبه استجابة لـ”إرادة الشعب” وتشكيل مجلس طوارئ، أو ربما تحدث حركة داخلية تطيح ببعض كبار قادة الأجهزة الموالين للسيسي لفتح الطريق أمام تغيير أوسع. وفي الوقت نفسه، تقف القوى الدولية موقف المتفرج المتوجس: واشنطن قد تفضل عدم التدخل المباشر تاركة الأحداث تأخذ مجراها، بينما دول الخليج قد ترى أن ضخ أموال إضافية في هذه الحفرة بلا قاع لم يعد مجديًا.
بل ربما تصدر بعض العواصم الغربية بيانات تدعو فيها السيسي إلى التنحي حقنًا للدماء، فيُفهم منها أنها سحبت دعمها الضمني له. خلال أيام قليلة، يكون المشهد قد تبدل جذريًا: نظام السيسي الذي بدا راسخًا لعقد من الزمن يتهاوى دفعة واحدة على وقع انهيار اقتصادي وثورة جياع وتحرك عسكري وضغط خارجي صامت. انهيار متعدد الجبهات كهذا سيذكرنا بانهيار أنظمة أوروبا الشرقية عام 1989، حين فجأة تلاحقت الانتفاضات الشعبية مع تخلي موسكو عن حلفائها ومع تصدع الحزب الحاكم من الداخل. الفرق أن مصر قد تشهد نسختها الخاصة: فوضى أمنية أكبر بحكم انتشار السلاح في المنطقة، وصعوبة في انتقال منظم للسلطة دون خسائر نظرا لغياب البدائل السياسية الجاهزة.
رغم سوداوية هذا السيناريو، إلا أن كثيرًا من الخبراء يرون بنيان حكم السيسي حاليًا “هشًا هيكليًا” لدرجة أن انهياره في النهاية حتمي . هو فقط بحاجة إلى الشرارة المناسبة التي قد تشعل سلسلة تفاعلات لا يمكن إيقافها. وقد تكون تلك الشرارة صغيرة في ظاهرها – ربما حادث أمني كبير، أو كشف فساد يهز الرأي العام، أو حتى وفاة مفاجئة للرئيس نفسه – لكنها في ظل التململ المكتوم كافية لفتح أبواب عاصفة التغيير.
وفي سيناريو العاصفة هذا، لن يكون هناك طرف قادر على إنقاذ النظام: لا الجيش (المنقسم والمحرَج)، ولا الشرطة (العاجزة أمام الطوفان الشعبي)، ولا صندوق النقد (فلن تنفع الأموال حين يعم العصيان)، ولا واشنطن (التي قد تراهن على بديل جديد في ظل الفوضى). سيكون سقوطًا مدويًا ومتعدد الجبهات بالفعل، وربما “مفاجئًا” فقط لمن خدعته مظاهر القبضة الحديدية ولم يرَ التصدعات العميقة تحت السطح. وما بعده ستدخل مصر مرحلة انتقالية صعبة تبحث فيها عن عقد اجتماعي جديد يعالج جذور الأزمات التي انفجرت كلها معًا.
دور لوبي ENABLE (تمكين) في تسريع نهاية السيسي
وسط هذه العوامل الداخلية والخارجية، يبرز دور الجالية المصرية في الخارج كعامل مساعد يمكن أن يسرّع سقوط النظام عبر الضغط السياسي والإعلامي على الداعمين الدوليين للسيسي. فقد نشأ خلال السنوات الأخيرة لوبي مصري في واشنطن يحمل اسم “إينبِل – ENABLE” (تمكين) بقيادة الدكتور سامح مسلّم وعدد من الناشطين المصريين الأمريكيين، يهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في مصر ونقل السلطة من يد العسكر إلى حكم مدني منتخب .
لقد سجل هذا اللوبي نفسه رسميًا في سجلات الكونغرس كأول جماعة ضغط سياسية مصرية في الولايات المتحدة ، وأصبح يعمل بشكل منظم للتأثير على صناع القرار الأمريكان في البيت الأبيض والكونغرس من أجل تغيير سياسة واشنطن التقليدية الداعمة للحكام المستبدين في القاهرة.
يركز لوبي ENABLE جهوده على عدة محاور تكاملية: أولها الضغط داخل الكونغرس لإعادة ربط المساعدات الأمريكية لمصر بتحسين سجل حقوق الإنسان والإصلاح السياسي. وقد تكللت جهود النشطاء بإعادة تشكيل تكتل حقوق الإنسان المصري في مجلس النواب عام 2023 ، حيث يقوم أعضاء هذا التكتل بعقد جلسات استماع وتقديم مشاريع قرارات تنتقد القمع في مصر وتطالب الإدارة باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاهه. كما نجحوا في حشد تأييد عدد من النواب لعرقلة صفقات أسلحة ضخمة لمصر، مستندين إلى قوانين تشترط التأكد من عدم استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين .
صحيح أن إدارة بايدن تجاوزت بعض هذه الاعتراضات وأفرجت عن المعونة كاملة متجاهلة الشروط الحقوقية عام 2024 ، لكن مجرد حصول هذا التجاذب العلني في أروقة السياسة الأمريكية مثّل صداعًا جديدًا للنظام المصري الذي كان معتادًا على شيك أمريكي على بياض.
المحور الثاني هو فضح الانتهاكات حقوق الإنسان المصرية على الساحة الدولية لكسر حالة الصمت أو التجاهل العالمي. يقوم لوبي تمكين بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية بتنظيم فعاليات ومعارض صور وحملات إعلامية تظهر حقيقة ما يجري في السجون المصرية من تعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف، وكذلك تسليط الضوء على حالات محددة لضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج القانون.
وقد نجحت هذه الجهود في إعادة مصر إلى أجندة مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأممي وفي تغطيات كبريات الصحف العالمية، بعد أن كانت الأزمات المصرية تتوارى خلف أزمات إقليمية أخرى. هذا الزخم الإعلامي الحقوقي يزيد من كلفة الدعم السياسي للسيسي لدى حلفائه الغربيين، إذ يُحرج حكوماتهم أمام برلماناتها وشعوبها.
المحور الثالث هو تفعيل سلاح العقوبات الدولية ضد المتورطين في القمع بمصر. فقد دفع نشطاء ENABLE نحو استخدام الإدارة الأمريكية لصلاحيات قانون ماغنيتسكي العالمي الذي يتيح فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، واقترحوا قوائم بأسماء قيادات أمنية مصرية مسؤولة عن التعذيب والقتل الجماعي. كما أثاروا مسألة تورط شركات تقنية أمريكية في تزويد أجهزة الأمن المصرية ببرمجيات تجسس ومراقبة ساعدتها في تعقب المعارضين ، مطالبين بمعاقبة هذه الشركات لخرقها قيم الديمقراطية.
هذه الجهود وإن لم تؤدِ بعد إلى قرارات عقابية جذرية، إلا أنها وضعت سيف العقوبات على رقبة النظام، وأرسلت إشارة قوية للنخبة الحاكمة بأن العالم بدأ يضيق ذرعًا بالممارسات الوحشية، وأن بعضهم قد يدفع ثمنًا شخصيًا من أرصدته وممتلكاته إذا استمر في التورط.
والمحور الرابع هو كسر حاجز الشرعية الدولية الذي يتمتع به النظام عبر التواصل مع الحكومات والبرلمانات الغربية وفضح فشل السيسي في تحقيق الاستقرار الذي يعد به. يذكّر لوبي تمكين في مخاطباته المسؤولين الغربيين بأن الرهان على “استقرار” السيسي رهان خاسر، فهو يقمع الإرهاب بإفراط فيولّد إرهابًا أعنف، ويضغط الشعب بالقهر والفقر فيدفع نحو انفجار أكثر خطرًا على المصالح الدولية.
هذه الرسائل تجد أذنًا صاغية تدريجيًا؛ ففي دوائر الكونغرس وبرلمان الاتحاد الأوروبي تزايدت الأسئلة حول جدوى دعم نظام يدفع بلاده نحو المجهول. وحتى في العواصم الخليجية ذاتها، بدأ يتسلل إدراك بأن استمرار الرهان على شخص واحد قد يضر بالاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، ما جعل بعضهم ينفتح بهدوء على قوى معارضة مصرية في المنفى تحسبًا للمستقبل.
باختصار، يقوم لوبي ENABLE ببناء جبهة ضغط خارجية تشجع المجتمع الدولي على مراجعة علاقته بنظام السيسي. ومع أن التغيير الحاسم سيظل في النهاية مرهونًا بالحراك الداخلي المصري، فإن هذا الضغط الخارجي يلعب دورًا داعمًا لا يستهان به. فهو يضيّق الخناق على النظام دوليًا ويحول دون حصوله على شيك مفتوح كما كان في السابق، ويمد معنويًا جسور الأمل للمعارضة في الداخل بأن صوتها مسموع عالميًا.
وربما الأهم أنه يوجه رسالة للنظام بأن جرائمه لن تمر بلا حساب، ما يضع مزيدًا من الضغوط النفسية والمادية على دائرة الحكم الضيقة. وفي المحصلة، كلما نجح هذا اللوبي في تحريك دوائر القرار الدولي ضد استمرار السيسي، عجّل ذلك من لحظة سقوطه، أو على الأقل أضعف قدرته على المقاومة عندما تحين ساعة التغيير في مصر.
خاتمة: مسألة وقت وإرادة شعب
في ضوء ما سبق من معطيات وسيناريوهات، يبدو سقوط نظام عبد الفتاح السيسي أمرًا لم يعد محصورًا في خانة التكهنات النظرية، بل هو احتمال قائم يتزايد ترجيحه يومًا بعد يوم. فالنظام يقف عند تقاطع طرق كلها خطرة: أزمة اقتصادية خانقة، احتقان شعبي متصاعد، ارتباك داخل مؤسسات الحكم، وتململ في صفوف الحلفاء الخارجيين. قد يختلف المحللون حول متى وكيف ستكون نقطة الانهيار، لكن القاسم المشترك في كل السيناريوهات هو أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار طويلًا.
لقد وصل النموذج الحالي في الحكم إلى طريق مسدود؛ فليس لديه ما يقدمّه لحل أزمات الاقتصاد المستفحلة سوى مسكنات مؤقتة، ولا يملك مشروعًا سياسيًا يخفف الاحتقان الشعبي، بل يعتمد فقط على القمع الذي يزداد صعوبة وفعالية كلما تراكم الغضب. وفي الوقت نفسه، لا يملك هذا النظام ظهرًا شعبيًا حقيقيًا يتكئ عليه؛ فجمهوره الحقيقي بات ضئيلًا ومنتفِعًا، بينما السواد الأعظم من المصريين بين ساخط وصامت كظمًا للغيظ.
من المرجح إذًا أن يكون السقوط مباغتًا وسريعًا عندما تنضج الظروف. ربما نشهد انفجارًا شعبيًا أكبر مما يتوقع الجميع، أو ربما تحركًا داخليًا يطيح برأس النظام لامتصاص الضغوط، أو حتى انهيارًا ذاتيًا بفعل إفلاس مالي يعصف بأركان الدولة. وأيًا كان السيناريو الذي سيتحقق على أرض الواقع، ستبقى الحقيقة الأهم أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الفصل. لقد أثبت التاريخ المصري الحديث أن صبر هذا الشعب طويل لكنه ليس بلا حدود، وأنه في اللحظات الحاسمة يخرج ليفرض إرادته رغم كل شيء.
قد يستغرق الأمر شهورًا أو ربما سنة او سنتين، ولكن كل الشواهد تدل على أن نظام السيسي يقترب من نهايته المحتومة.
وحين تدق ساعة التغيير، سيعلو صوت المصريين ليقرروا مستقبلهم – مستقبل يتطلعون أن يكون أكثر عدلًا وكرامةً وحرية، بعد حقبة مظلمة دفعوا ثمنها غاليًا. بذلك سيتأكد مرة أخرى الدرس الخالد: أن الشعب مهما تأخر في قول كلمته الأخيرة، فإنها عندما تُقال ستكون مدوّية وحاسمة، ولن يصمد أمامها أي طاغية أو نظام متهاوٍ مهما بلغ جبروته.