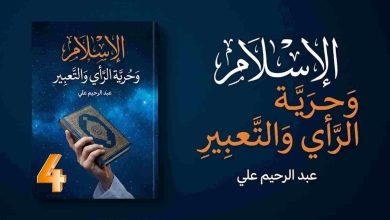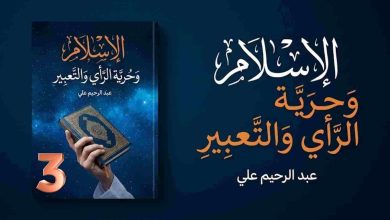في قلب القاهرة يوم 7 يوليو، اندلعت النيران في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي للاتصالات. خلال ساعات التهمت ألسنة اللهب طابقًا كاملًا يضم غرف تشغيل شركات الاتصالات، قبل أن تمتد إلى طوابق أخرى بسبب شدة الحريق .
الحصيلة المأساوية كانت 4 قتلى و27 مصابًا بحالات اختناق، وتعرضت البنية التحتية لشبكات الهاتف والإنترنت في أنحاء مصر لعطل مفاجئ .
وبعد إخماد الحريق الأول، تجدد اشتعال محدود يوم الخميس في الطابق العلوي من البرج وسط ذعر السكان . ورغم السيطرة السريعة على هذا الاحتراق الثاني، كشف الحادث هشاشة نقطة الاتصالات المركزية التي يعتمد عليها ملايين المصريين .
لكن الأخطر هو ما وراء هذه الكارثة التقنية. فبينما أعلنت السلطات التحقيق في الأسباب وتكهنت بخلل كهربائي أو إهمال ، تثار في الخفاء فرضية مرعبة: هل كان الحريق متعمدًا؟ هل هناك يد خفية أشعلت السنترال عمدًا لتمهيد الطريق أمام مشروع مريب – بناء مركز اتصالات جديد مزوّد بأجهزة مراقبة وتجسس ذكية بإشراف جهات أجنبية؟
هذه الفرضية تكتسب رواجًا بين المحللين الحذرين من حرب تكنولوجية صامتة تُشن على مصر والمنطقة. فالحريق جاء في توقيت حساس يتزامن مع تسارع سباق تقنيات التجسس السيبراني عالميًا، ويفتح باب التساؤل: هل يمكن أن تكون مصر ضحية مخطط خبيث لاختراق شبكاتها السيادية تحت ستار تحديث البنية التحتية؟
فرضية الحريق المتعمّد والتكنولوجيا المشبوهة
من الطبيعي أن يحدث حريق نتيجة ماس كهربائي أو تقصير في إجراءات السلامة. لكن حجم الضرر الذي سببه حريق سنترال رمسيس – إذ شلّ جزءًا كبيرًا من خدمات الاتصالات دفعة واحدة – يجعله حادثًا استراتيجيًا بامتياز.
سنترال رمسيس كان بمثابة نقطة فشل واحدة (Single Point of Failure) لشبكة الإنترنت المصرية ؛ أي أن ضربه يعطل التواصل الرقمي في معظم المحافظات. وفي عالم باتت فيه الهجمات السيبرانية أخطر من القنابل، لا يمكن استبعاد أن يكون هذا الحريق ضربة متعمّدة ضمن سياق حرب جديدة.
لقد شهدنا سابقًا استخدام فيروسات مدمّرة لاستهداف بنى تحتية لدول معادية؛ على سبيل المثال، فيروس Stuxnet الشهير الذي كُشف عنه عام 2010، وكان أول سلاح سيبراني معروف يسبب دمارًا ماديًا . استهدف Stuxnet منشآت نووية في إيران، وتبيّن لاحقًا أنه نتاج تعاون استخباراتي أمريكي-إسرائيلي قصد تخريب البرنامج النووي الإيراني دون إطلاق رصاصة  .
إذا صح أنّ حكومات تسخر البرمجيات الخبيثة لإشعال حرائق في أجهزة الطرد المركزي، أفلا يمكن أن يستهدف خصوم مصر مركز أعصاب اتصالاتها لإدخال أجهزة تجسس متطورة أثناء إعادة بنائه؟
الفرضية تقول إن الحريق المفتعل يخلق مبررًا “شرعيًا” لاستبدال أنظمة السنترال القديمة بمنظومات أحدث وأكثر “ذكاءً”. لكن هذه المنظومات الجديدة قد لا تكون سوى حصان طروادة يحمل في جوفه معدات مراقبة شاملة مزوّدة بتقنيات التنصت الرقمي وجمع البيانات على مدار الساعة.
وإذا كانت جهة أجنبية وراء المخطط، فقد تسعى لتمرير أجهزة تتضمن أبوابًا خلفية (Backdoors) في معدات الاتصالات المصرية تسمح لها بالتجسس لحظيًا على كل مكالمة ورسالة وتدفق بيانات في البلاد. بكلمات أخرى، قد يتحول السنترال الجديد المقترح إلى منصة تجسس مركزية تحت غطاء “التطوير”، تمكن صاحبها الخفي من مراقبة مصر بالكامل بزر واحد.
هذه ليست تكهنات خيالية بالكامل؛ فتاريخ المنطقة مليء بأمثلة للتعاون التقني المشبوه. كثيرًا ما عُرض على دول الشرق الأوسط حلول اتصالات وأمن إلكتروني من شركات ذات صلات استخباراتية.
وفي حالة مصر بعد الحريق، من المتوقع أن تتهافت الشركات الأجنبية بعروض إعادة بناء “أذكى وأأمن” للشبكة. والخطر أن بعض هذه الشركات قد تكون واجهة لأجهزة مخابرات أو تعمل بالتنسيق معها.
إسرائيل تحديدًا – وهي الخصم التاريخي والطامح للتفوق التقني إقليميًا – تعتبر رائدة في مجال تكنولوجيا التجسس السيبراني. تطويرات إسرائيل في هذا المجال هائلة، من البرمجيات الخبيثة إلى المنصات التحليلية وأخيرًا الحوسبة الفائقة. وفي السياق الحالي، من الضروري استعراض بعض هذه الأدوات الإسرائيلية التي غيّرت قواعد اللعبة في حروب المعلومات، لفهم حجم التهديد الذي يمكن أن يواجه مصر وأي دولة تغفل عن تأمين فضائها الرقمي.
أبرز أسلحة التجسس السيبراني الإسرائيلية
قدمت إسرائيل – منفردة أو بالتعاون مع حلفاء – منظومات تجسس واختراق إلكتروني باتت حديث العالم. فيما يلي بعض أبرز هذه الأدوات ودلالاتها:
1. فيروس Stuxnet (ستاكس نت) – ظهر عام 2010 كأخطر دودة حاسوب خبيثة حينها، واستهدف تعطيل أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نووية إيرانية عبر التلاعب ببرمجياتها .
مصادر موثوقة كشفت أن تطوير Stuxnet كان عملية مشتركة بين المخابرات الإسرائيلية والأمريكية  ضمن خطة سرية سُمّيت “الألعاب الأولمبية”. نجح هذا الهجوم في إلحاق أضرار مادية بمنشآت حيوية دون أي مواجهة عسكرية مباشرة – سابقة خطيرة أثبتت أن كودًا برمجيًا قادر على تدمير آلات وإشعال حرب أو إيقافها .
إن Stuxnet يمثل نقلة في مفهوم الحرب؛ حيث أصبحت ضربة سرية على لوحة مفاتيح تعادل قصفًا جويًا في فعاليتها.
2. برمجية Pegasus (بيغاسوس) – برنامج تجسس على الهواتف الذكية طورته شركة NSO Group الإسرائيلية. ذاعت سمعة بيغاسوس خلال السنوات الأخيرة بعد انكشاف استخدامه لاختراق هواتف رؤساء ومسؤولين ونشطاء وصحفيين في مختلف أنحاء العالم .
تعمل بيغاسوس عبر ثغرات “صفرية النقر” غالبًا، بحيث يمكن زرعها على هاتف الضحية دون علمه، لتمنح العميل قدرة سيطرة كاملة على الجهاز . بمجرد إصابة الهاتف، يحصل الجاسوس على ما يشبه نافذة سحرية يرى منها كاميرا الهاتف وما تلتقطه، ويسمع الميكروفون وما يسجله، ويطالع الرسائل والمكالمات والصور كأنها على هاتفه الخاص .
وقد بيعت هذه التقنية لحكومات عدة، بعضها استخدمها ضد معارضيه السياسيين. إثارة Pegasus بلغت حدًّا دفعت شركة آبل نفسها لرفع دعوى قضائية ضد NSO، كما طالبت منظمات حقوقية بحظر تصديرها. إن بيغاسوس تعني عمليًا أن لا أسرار ولا خصوصية لأي شخص مستهدف: هاتفك الذكي قد يتحول إلى عميل مزدوج يعمل ضدك.
3. برنامج Predator (بريداتور) – أحد أحدث أدوات التجسس التجاري الذي طورته شركة Cytrox (يُعتقد أن مقرها الرئيسي في أوروبا بقيادة خبراء بينهم إسرائيليون). كُشف مؤخرًا أن مصر ذاتها كانت ضمن الدول التي حصلت على خدمات Predator .
فقد وثّقت منظمة Citizen Lab اختراق هواتف معارضين مصريين في المنفى باستخدام Predator، بالتزامن مع اختراق نفس الأجهزة عبر Pegasus أيضًا . أي أن جهتين حكوميتين مختلفتين – يُرجح أن إحداهما مصرية والأخرى ربما جهة حليفة – تجسستا على نفس الشخص بكل من بيغاسوس وبريداتور في الوقت ذاته !
هذا يثبت انتشار سوق سوداء لبرامج التجسس تتنافس فيها NSO الإسرائيلية وتحالف شركات مثل Cytrox (المندرجة ضمن تحالف Intellexa الأوروبي) . بريداتور يُثبت أن تقنيات التجسس لم تعد حكرًا على الحكومات العظمى فقط، بل تباع وتشترى كخدمة تجارية – ما يضاعف الأخطار، خاصة عندما تقع هذه التقنيات في يد سلطات تستخدمها بلا رقابة قانونية.
4. منصات تحليل البيانات (مثال: Palantir) – إن مجرد جمع البيانات والتنصت ليس كافيًا دون قدرات تحليلية خارقة لاستخلاص معلومة ذات قيمة من جبل البيانات الخام. وهنا برزت منصات مثل Palantir الأمريكية التي تخصصت في تحليل البيانات الضخمة لصالح وكالات الاستخبارات والأمن .
شركة Palantir – التي ساهمت CIA عبر ذراعها الاستثماري In-Q-Tel بتمويل نشأتها  – طورت برمجيات قادرة على دمج وفهم كميات هائلة من البيانات المتباينة (اتصالات، معاملات مالية، تحركات) لكشف الأنماط والعلاقات الخفية.
على سبيل المثال، يُستخدم نظام Palantir Gotham من قبل محللي مكافحة الإرهاب في مجتمع الاستخبارات الأمريكي ووزارة الدفاع ، كما استُخدم سابقًا في مراقبة حرب المعلومات على الإنترنت . تخيّل قدرة برنامج يجمع منشورات مواقع التواصل والتقارير الإخبارية واتصالات الملايين ثم يربط الخيوط ليحدد أين تتشكل نواة احتجاج قبل حدوثه، أو من هم المؤثرون القادرون على قلب الرأي العام.
مثل هذه المنصات تجعل السيطرة على الوعي عملية مدعومة بالخوارزميات: تسمح للحكومات بتوجيه دفة المجتمع كالقطيع عبر معرفة نقاط ضغطه وأفضل أساليب التأثير عليه. ورغم أن Palantir شركة أمريكية، إلا أنها تمثل نموذجًا للتقنيات التي يمكن أن تستغلها أي جهة تمتلك إمكانية الولوج للبيانات المصرية الضخمة – سواء مخابرات أجنبية أو حتى السلطة المحلية نفسها – لـبناء صورة شاملة عن المجتمع والتنبؤ بتحركاته وتشكيلها.
5. مشروع الحاسوب الفائق “إسرائيل-1” – في خطوة تؤكد دخول إسرائيل سباق الذكاء الاصطناعي كقوة عظمى، أعلنت شركة Nvidia عن بناء أقوى حاسوب فائق في إسرائيل بقدرة معالجة تصل إلى 8 إكزافلوبس من أداء الذكاء الاصطناعي .
هذا الحاسوب، الذي سُمّي “إسرائيل-1”، سيكون بين الأسرع في العالم مصممًا لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات هائلة . 8 إكزافلوبس تعني 8 كوينتليون (أي 8 مليار مليار) عملية حسابية في الثانية – رقم يُدخلنا عصر تفوق حوسبي غير مسبوق في المنطقة.
أهمية ذلك في سياق التجسس والتحكم تكمن في أن الذكاء الاصطناعي يستطيع ابتلاع البيانات بلا حد: صوتيات، مرئيات، نصوص؛ ثم يستخدم قوة المعالجة لفهمها والخروج باستنتاجات أو قرارات في لمح البصر.
إسرائيل-1 قد يُستخدم لأغراض علمية وتجارية بالطبع، لكن لا شك أن امتلاك إسرائيل لقدرة حاسوبية كهذه سيوظَّف أيضًا في خدمة مخابراتها الإلكترونية. ستتمكن مثلاً من تحليل محتوى جميع الاتصالات المصورة والمسموعة لحظيًا، أو تشغيل نماذج توليد محتوى متقدم لبث رسائل موجهة بلغات متعددة وبكميات ضخمة عبر الإنترنت بوتيرة تفوق طاقة البشر.
إنه سلاح استراتيجي في ميدان الوعي: حاسوب قادر على التفكير أسرع من عقولنا بملايين المرات، وتوليد أفكار وسيناريوهات للتأثير علينا دون أن ندرك.
هذه مجرد نماذج من الترسانة الرقمية التي باتت بمتناول أيدي من يملك التقنية والمال. أدوات كهذه يمكن تسخيرها بسهولة لـالسيطرة على الوعي الجمعي وبث سرديات موجهة تخدم أجندات من يمتلك مفاتيحها. ماذا يعني ذلك عمليًا؟ إنه يعني القدرة على صناعة الحقيقة التي يراها الناس. فحين تقدر جهة ما على التجسس على كل همسة وصورة، ثم تحليل ميول المجتمع وخوفه وأحلامه، ثم ضخ محتوى إعلامي مصمم بدقة لاستثارة عواطفه أو إحباطه أو توجيهه نحو فكرة معينة – فإن تلك الجهة تمتلك أخطر سلاح على الإطلاق: التحكم بإدراك الناس.
السيطرة على الوعي وزرع السرديات: حرب بلا دخان
لقد ولّت أيام الحروب التقليدية التي تُحسم بالاحتلال العسكري أو التفوق الاقتصادي فحسب. نحن اليوم أمام حرب من نوع آخر تستهدف العقول والقلوب قبل الأبدان. يصف خبراء استراتيجيون معاصرون هذا المشهد بأنه “حرب صامتة” على الوعي تدور رحاها بالتوازي مع أي صراع ميداني .
الهدف منها تشكيل سرديات بديلة تغير إدراك الجمهور وتصنع واقعًا افتراضيًا يخدم مصالح جهة معينة . بكلمات أخرى، يتم إطلاق معركة خفية على الإدراك إلى جانب المعركة العسكرية الظاهرة، وقد تكون أشد حسمًا منها.
إن إسرائيل اليوم تخوض مثل هذه الحرب الصامتة بامتياز. تدرك المؤسسات الإسرائيلية أن السيطرة على الوعي ليست مجرد عامل مساعد، بل هي جوهر المعركة المستقبلية. حتى أن دراسات صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) تشير إلى أن صانع القرار الإسرائيلي يرى أن السيطرة على الوعي تسبق السيطرة على الأرض .
وقد أنشأ الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ما يسمى “مركز العمليات الإدراكية” لقيادة هذه المعركة الذهنية . أدواتهم في ذلك متعددة: من وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالعربية التي يديرها ضباط مخابرات (مثل صفحة أفيخاي أدرعي وغيرها )، إلى حملات إعلامية عالمية تصوغ روايات تخدم إسرائيل في كل حدث دولي.
على سبيل المثال، خلال الحروب الأخيرة على غزة، لم تقتصر عمليات إسرائيل على القصف؛ بل رافقتها حملات إعلامية ممنهجة لتبرير الضربات وتشويه صورة المقاومة . يتم تصوير إسرائيل إعلاميًا كطرف أخلاقي متفوق يواجه الإرهاب، بينما يُلقى باللوم في معاناة المدنيين على المقاومة نفسها .
هذه السردية المعكوسة تهدف إلى التلاعب بالوعي المحلي والعالمي، حتى تتبنى الجماهير – في الغرب خصوصًا – رواية إسرائيل بأنها المدافع عن النفس . وقد نجحت إسرائيل عبر عقود في زرع سرديات عالمية مثل “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها” التي تجذرت في الوعي الغربي حتى غدت بديهية ، بينما رواية الفلسطيني كضحية يتم طمسها.
هكذا تُدار معركة الروايات: كل صورة وفيديو وتصريح يتم توظيفه بعناية لصياغة واقع بديل يغطي على الحقائق .
بالطبع، ليست إسرائيل وحدها من يمارس حرب السرديات هذه، فكل القوى الكبرى اليوم لديها جيوش إلكترونية وحملات تأثير. لكن المنطقة العربية تبدو الساحة الأضعف دفاعًا. فالمجتمعات العربية تعاني من فجوة وعي تقنية ومن تضييق على الإعلام الحر، مما يجعل اختراق وعيها أسهل.
إن إضعاف أي مقاومة فكرية أو هوية مستقلة في العالم العربي هدف ضمني – وأحيانًا صريح – لبعض القوى الساعية للهيمنة. فامتلاك مجتمع عربي لوعي تاريخي وواقع متماسك يعني قدرته على الرفض والنهضة؛ بينما مجتمع مشتت الوعي يسهل تطويعه وتقبّله لروايات مفبركة عن ذاته وعن عدوه.
من هنا نفهم لماذا يتزامن تصاعد القمع السياسي في دولنا مع فتح الأبواب على مصراعيها لتقنيات المراقبة والتأثير: إنها حلقة متكاملة لإحكام السيطرة على الشعوب، جسدًا وروحًا.
لقد أصبحت الحرب النفسية والعقلية والروحية هي الميدان الجديد. تُشن على العقول عبر بث الخوف والشائعات، وعلى الحقائق عبر تسويق الأكاذيب كمسلمات، وعلى المفاهيم عبر قلب معانيها وتشويهها.
في هذه الحرب، الضحية الأولى هي الحقيقة. فأنت لا تحتاج لاحتلال أرض شعب إذا استطعت احتلال دماغه وإقناعه باستعمار نفسه بنفسه. إنه تكتيك “السيطرة الناعمة” الذي يتغلغل عبر الإعلام ووسائل التواصل والمناهج التعليمية أحيانًا، لفرض سردية عالمية جديدة تجعل المستعمَر يرى المستعمِر صديقًا والمقاوم عدوًا.
خطورة الأمر دفعت بعض المفكرين لوصف “الحرب على الوعي” بأنها ربما أخطر من الحرب العسكرية، لأنها تستهدف أعماقنا وتعيد تشكيل صورتنا عن أنفسنا وعن عدونا . وكما قال أحد الكتاب: قد تصبح الحرب على الوعي أخطر من القصف، فهي تقصف أرواحنا لا أجسادنا . إنها تسعى لسلبنا أكثر ما نملك مناعة: مناعتنا الفكرية والنفسية. حينها سنُهزم حتى لو لم تُطلق علينا رصاصة واحدة.
قيادة مصر الحالية في مرمى الحرب الذكية
إذا كانت هذه هي طبيعة الحرب الجديدة، فهل مصر مستعدة لها؟ المؤسف أن الشواهد تقول عكس ذلك. القيادة المصرية الحالية تبدو غير مؤهلة لمواجهة هذا النوع من الحروب؛ بل هي ذاتها جزء من المنظومة التي تعمّق اختراق الوعي والمعلومات في البلاد.
فمنذ 2014، انشغل النظام في مصر بتشديد قبضته الأمنية التقليدية عبر الاعتقالات وتمديد حالة الطوارئ وقمع الإعلام المستقل… لكنه في الوقت نفسه فتح الأبواب لدخول تكنولوجيا المراقبة والتحكم الأجنبية دون شفافية.
مثال صارخ يتجلى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تباهي بها الدولة كمدينة “ذكية”. هذه المدينة مزوّدة بأكثر من 6,000 كاميرا مراقبة تنتشر في الشوارع والمرافق  ، وترتبط بغرفة تحكم مركزية تستخدم برمجيات تحليل فيديو متقدمة لرصد التجمعات والتحركات “المشبوهة” آنيًا .
التقنية وفّرتها شركة أجنبية (Honeywell الأمريكية) وتوصف بأنها نظام شامل لتنسيق الأمن والشرطة عبر إنترنت الأشياء . المسؤولون يروجون لها كوسيلة لمكافحة الجريمة وتحسين الخدمات، لكن خبراء الحقوق الرقمية وصفوا العاصمة الجديدة بأنها في الحقيقة “مدينة مراقبة” تهدد حقوق المصريين  .
فزرع هذا الكم من الكاميرات يمنح السلطات قدرة غير مسبوقة على تتبّع المواطنين وقمع أي بوادر احتجاج . ومع غياب قوانين تحمي الخصوصية أو تنظم استخدام تقنية التعرف على الوجوه في مصر، يصبح كل مواطن هدفًا مراقَبًا محتملًا دون علمه أو موافقته .
لا يتوقف الأمر عند الكاميرات. خلال السنوات الماضية، استوردت الأجهزة الأمنية المصرية أدوات اختراق وتجسس متقدمة من الخارج. تؤكد تحقيقات Citizen Lab أن مصر اشترت برنامج Predator واستعملته ضد أهداف سياسية ، كما تشير تقارير أخرى إلى اقتناء القاهرة لتقنيات اعتراض اتصالات وتنصت جماعي من شركات أوروبية وإسرائيلية بشكل غير مباشر.
أي أن النظام – عوض أن يحصّن الفضاء الرقمي المصري – قام بتسليمه لأدوات أجنبية تحت ستار “محاربة الإرهاب” وملاحقة المعارضين. هذا يطرح معضلة كبرى: من يضمن أن البيانات التي تجمعها هذه الأدوات تبقى بأيدٍ مصرية خالصة؟
إذا كانت الشركات المطوِّرة ذات صلة بإسرائيل أو غيرها، فقد تمتلك منافذ سرية للإطلاع على ما تجمعه في مصر. وحينها يكون النظام قد وضع رقبة الشعب في يد من يتجسس عليه من وراء ستار.
إن التقدم التقني الإسرائيلي يضع القيادة المصرية أمام اختبار تاريخي: إما مجاراة هذا التقدم بتحصين ذاتي ووعي تقني سيادي، أو الخضوع له بتبني حلول جاهزة تأتي مضمَّنة بوسائل السيطرة الأجنبية. حتى الآن، يبدو أن مصر اختارت المسار الثاني للأسف.
فعوض الاستثمار الجاد في الكفاءات السيبرانية المحلية وبناء منظومة مستقلة للأمن الرقمي، اعتمدت على شراء حلول خارجية غالبًا ما تأتي مشروطة بثغرات. أضف إلى ذلك انشغال النظام بفرض سرديته الخاصة داخليًا (عبر هيمنة إعلامية ودعاية مؤيدة) ما جعله يتهاون في رصد السرديات الأخطر التي تتسلل من الخارج لتشكيل وعي الشعب على المدى البعيد.
والمشكلة أن النظام نفسه ربما يرى في بعض تقنيات التجسس والسيطرة أداة لترسيخ حكمه، فيتغاضى عن خطرها السيادي. مثلاً، قد يرحب بزرع كاميرات صينية أو برامج تجسس أجنبية طالما أنها تساعده فورًا في تعقب معارضيه – غير مدرك أنها سيف ذو حدين.
اليوم قد يستخدمها ضد ناشط مصري، وغدًا ربما تستخدمها جهة أجنبية لابتزاز الدولة نفسها أو تمرير أجندات في الخفاء. لقد أصبح أمن البيانات جزءًا لا يتجزأ من أمن الدولة. وأي ثغرة هنا قد تفتح أبوابًا خلفية تخرج منها سيادة الوطن لصالح الآخر.
إذا قدّر للشعب المصري أن يستعيد زمام أموره يومًا، فعليه أن يضع في أولوياته مراجعة دقيقة لكل الأجهزة والمنظومات التقنية التي أُدخلت البلاد خلال عهد عبد الفتاح السيسي. لا بد من تدقيق سيادي: ماذا جلبتم؟ من أي شركات؟ ما البرمجيات التي تدير البنية التحتية الآن؟ هل تحققت جهة مستقلة من عدم وجود أكواد تجسس فيها؟
أسئلة مصيرية لضمان أن لا يكون الأمن المصري مختَرَقًا من الداخل. فالتبعية التقنية أخطر من التبعية الاقتصادية؛ لأنها غير مرئية، تنخر أساس الأمة بصمت حتى تنهار فجأة.
التسلح بالعلم والوعي: سلاح المصريين في حرب المستقبل
في ختام هذا المشهد المعقد، يبرز سؤال واحد: ما العمل؟ كيف يحمي المصريون أنفسهم وبلدهم من حرب ذكية لا تُرى بالعين المجردة؟ الإجابة تكمن في العلم والوعي والفهم العميق. فكما كان التعليم والوعي سلاح مصر في مواجهة الاستعمار التقليدي أوائل القرن الماضي، هما اليوم أيضًا السلاح في وجه الاستعمار الرقمي والفكري.
أولاً، لا بد من الاعتراف شعبيًا ورسميًا بأننا في حرب حقيقية – حرب تدور رحاها في الفضاء السيبراني وعلى شاشات الهواتف وعبر منصات الأخبار. هذه ليست نظريات مؤامرة، بل واقع تؤكده الأحداث اليومية والتسريبات والتقارير الدولية. إن إدراك وجود الخطر هو الخطوة الأولى للتعامل معه. على كل مواطن واعٍ أن يتساءل عندما يرى حملة أخبار موجهة أو شائعة تنتشر: من المستفيد؟ قد لا يكون الجواب دائمًا في الداخل.
ثانيًا، التحصين المعرفي ضرورة قصوى. يجب أن ينتشر بين الشباب ثقافة الأمن الرقمي: كيف تحمي بياناتك واتصالاتك؟ كيف تتحقق من موثوقية الخبر قبل أن تشاركه وتساهم دون قصد في حرب سرديات ضد وطنك؟ هذه مهارات حياتية اليوم تمامًا كإتقان القراءة والكتابة.
المدارس والجامعات والإعلام الوطني مطالبون بإطلاق حملات توعية سيبرانية، تُشرح فيها أمثلة عمليات الاختراق الإلكتروني التاريخية وكيف تم إحباطها أو تسريبها. فمعرفة قصص مثل Stuxnet وبيغاسوس وCambridge Analytica وغيرها   ستجعل المواطن أكثر حصانةً حين يواجه وضعًا مشابهًا.
ثالثًا، المساءلة والمطالبة بالشفافية. ينبغي دعم أي جهود لمحاسبة من يُدخل تقنيات مراقبة تنتهك خصوصية المصريين أو تضع سيادة بياناتهم في خطر. في هذا السياق، يبرز دور لوبي ENABLE (اختصارًا لـ Egyptian New Assembly for Building, Liberation and Empowerment) كحركة ضغط أهلية واعدة. هذا اللوبي يمكنه حشد الخبراء والقانونيين لمتابعة الشركات الدولية التي تورد أجهزة المراقبة الجديدة لمصر ومراجعة عقودها.
بل ويمكنه رفع شكاوى قانونية دولية ضد الجهات – سواء حكومية أو خاصة – التي يثبت أنها انتهكت سيادة البيانات المصرية أو شاركت في التجسس على المصريين. لقد بدأت بالفعل منظمات دولية في مقاضاة شركات مثل NSO الإسرائيلية المطوّرة لبيغاسوس بسبب تجاوزاتها عالميا؛ وفي حالتنا المصرية، وجود كيان محلي كـENABLE سيساعد في توثيق أي انتهاك وملاحقته ضمن الأطر القانونية .
إن سيادة مصر الرقمية خط أحمر لا يقل أهمية عن سيادتها على أرضها ومياهها، ويجب أن يرسخ هذا المبدأ في الوعي الجمعي: بياناتنا ملك لنا، وأي اعتداء عليها هو اعتداء على الوطن .
أخيرًا، يبقى الرهان الأكبر على الإنسان المصري نفسه. هذا الشعب الذي صمد أمام حملات عسكرية وثقافية عبر تاريخه، يملك بلا شك مقومات الصمود في حرب المعلومات. الفارق أن عليه تغيير أسلحته هذه المرة. بدلاً من العصيان المدني أو الكفاح المسلح، سلاحك أيها الشاب المصري هو لوحة المفاتيح والفأرة ولكن ليس للهجوم، بل للتعلّم.
تعلّم كيف يعمل الإنترنت، كيف تُنتهك الخصوصية وكيف تحميها، كيف تنتشر الإشاعة وكيف تدحضها، كيف تصنع سردية مضادة تنبع من حقائقك وتاريخك في وجه السرديات المفروضة. المعرفة قوة – وهذه ليست عبارة إنشائية؛ بل حرفيًا، المعلومة هي سلاح القرن الحادي والعشرين. من يمتلكها ويفهمها يستطيع شن الحرب أو منعها.
لقد أصبحت الحروب ذكية لا تُخاض بالسلاح الناري بل بالمعلومة وبالقدرة على التحكم في الإدراك. وإذا كان أعداء مصر يتربصون بها عبر زرع شرارة في سنترال هنا أو ثغرة في هاتف هناك، فإن الرد الأمثل هو أن نُحوّل كل مصري ومصرية إلى جندي وعي يعلم ما يجري حوله. هكذا فقط نفوّت الفرصة على أي خطر داهم قادم في الظلام. فالنار التي اشتعلت في رمسيس قد تنطفئ، لكن نار الوعي التي تشتعل في عقولنا اليوم هي الكفيلة بأن تضيء لنا المستقبل وتحمينا من أي حرب خفية.