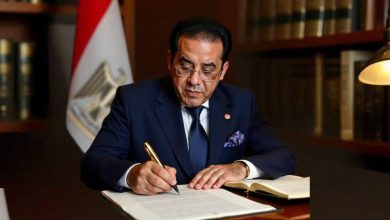45 عامًا أمارس فيها السياسة كمضاد حيوي، أحافظ به على إنسانيتي…
فلم يكن ما اخترتُه في حياتي ترفًا نضاليًا، ولا نزوة معارضة على رصيف الوجاهة، ولا بحثًا عن كاميرا تلتقطني وأنا أصرخ في عتمة الصمت. كان قرارًا… خيار حياةٍ لا قسط فيه ولا مهلة سداد، خيارًا مكلّفًا، باكرًا، قاسيًا، لكن لا رجعة فيه.
كان بوسعي أن أكون ضيفًا دائمًا على موائد القرار، أرتدي ربطة عنق من نوع “نعم”، وأتزيّن بابتسامات التواطؤ في حضرة السلطان. أن أكون صورة مطبوعة في أوراق الولاء، وصوتًا مجمّلاً في برامج “الاعتدال”، وأنال نصيبي من تورتة السياسة، التي تُقسَّم بميزان الخنوع، لا ميزان الدستور.
لكن كيف؟!
كيف أرتدي بذلة من البلاستيك الوطني، وأمثّل دورًا في مسرحية رديئة، بينما الوطن يختنق في غرفة العناية المركزة؟! كيف أشاركهم الزينة على تابوت البلاد، وأغني لقصص الإنجاز، بينما الذي يُنجز فعلًا هو اغتيال الكرامة وتآكل الوعي وتجريف الأرض؟!
لم أملك في يدي سوى الحقيقة، وفي صوتي سوى الكلمة. لم أكن راقِصًا في سيرك سياسي، أوزّع الأحجبة وأحرق البخور، وألقي خطبًا عن “فشل المحافظ” و“جشع التجار” و“زيادة الإنجاب”، بينما جثة الوطن لا تزال ساخنة.
الحقيقة لا تُقال بماء الورد. الحقيقة مرّة. جارحة. تُقال بالكحول حين تعفن الجرح. وبالنار حين تستدعي الكي. ومن يحب بلده لا يربّت على جروحه، بل يواجهها، يطهرها، ولو احترق معها.
قلت “لا”، بينما كان البساط الأحمر مفروشًا لكل “نعم”. قلتها وأنا أعلم أنني لن أُمنح وسام شجاعة، بل سأُمنح تهمة خيانة. في جمهورية الصدى، كل “لا” تُعامل كفيروس، وكل “نعم” تُكرم كشهيد.
قلت “لا”… فاتهموني بأنني خائن، وعميل، وعدو للأرض التي أمشي عليها، والسماء التي أتنفس منها. لكنني كنت أعرف، ويعرف الناس، من الخائن فعلًا، ومن العاشق الموجوع.
لم يكن سهلًا أن تنهشهم سمعتي، وتُصاغ ضدي بلاغاتهم الأمنية، وأن يتم استباحة اسمي كل صباح ومساء… لكنني ظللت واقفًا. لا أنهار، لا أُبايع، لا أساوم. والناس… نعم الناس، لم تُخطئ الشمّ. تشمّ رائحة الكيد، وتعرف مذاق الظلم حين يُطبخ في مطابخ الدعاية السوداء.
لم أدّع يومًا أنني أسقطت النظام، ولا أنني وحدي على الميدان، لكنني رفضت أن أكون طبالًا في موكب الطغيان، أو بائعًا للمواقف بالتقسيط، أو مروضًا للحقيقة على خشبة الإعلام المأجور.
وقفت… كالمصلوب في ميدان الخذلان. لا من يسمع صراخي، ولا من يُوقف نزيفي. لكنني وقفت. ولم أتراجع، ولم أختبئ، ولم أتلطّ خلف قناع الوطنية المعلّبة.
لا يعاقَب المظلوم في هذا الزمن لأنه ظُلم، بل لأنه لم يتحوّل إلى جلاد. لا يُلام الجريح لأنه نازف، بل لأنه ما زال يؤمن بالعدالة، ولم يكره ظله بعد. وأنا… كنت هذا الرجل.
لم أصرخ إلا بما همس به غيري خلف الأبواب. لم أشر إلى الداء، إلا لأنّ في قلبي مرارة، وفي عيني دمعة، وفي روحي صدق. لم أكن من المُبشّرين، ولا من المُدّعين، كنت فقط… إنسانًا يعرف أن “السكوت عن النار لا يطفئها”.
لم أصنع من نفسي نبيًا ولا مخلّصًا. لم أطلب الزعامة، ولا النجومية. لكنني كنت رقمًا عصيًّا في جدول الطاعة، صوتًا نشازًا في كورال المديح، ريشة مقاومة في لوحة استسلام معلّقة في قصر الحكم.
لم أقترب من موائدهم، لم أتناول من أعلافهم، لم أنم في أكفان خفافيشهم. كنت طائرًا منفردًا… لا يُغريه قفص ولو كان من ذهب. لا يُغنيه تصفيق ولو صعدت له الجماهير على المنابر.
السجن لم يُرهبني، ولا المقصلة أخافتني. ما جرحني حقًّا هو صمت النخبة، وانحناء من كانوا يومًا في الجبهة، وانقلاب المعارضات الموسمية إلى تصفيق موسيقي للنظام… حين تنطفئ الكاميرا.
لا ألوم السلطة على قسوتها، بقدر ما ألوم من عاونها في الخفاء، من رفض عمر مكرم وصفق لمحمد علي، من هتف ضد الظلم وهو يكتبه ويُروّجه. هؤلاء ليسوا ضحايا… بل صُنّاع الظلال.
وما زالت المسرحية تُعرض، وأدوار البطولة تُوزّع، والستار يُسدل على مشهدٍ وراء مشهد… لكن الجمهور سئم، والتصفيق انقطع… وأنا معه، لا أصفق بعد الآن.
لا أزعم أنني غيرتُ مجرى النهر، لكنني قاومت أن أُجرّ معه. لا أزعم أنني قهرت الطغيان، لكنني قاومت أن أكون عباءة تُلبس له. رفرف قلبي بالحقيقة… فليُكتب هذا في دفاتر العناد.
ومن لا يملك شجاعة “لا”، فليبتلع صوته، وليتوقّف عن التغني بحب الوطن. فالوطن لا تُحبّه بالصمت، ولا تُنقذه بالسكوت، ولا تحميه بموالاة الجلاد. الوطن لا يحترق بورقة خريف… بل بخيانة الصمت.