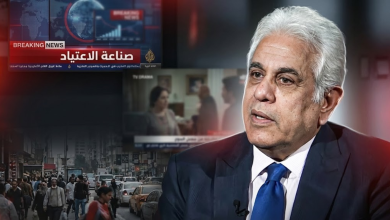“تناقض مصالح الدول المركزية بشكل كبير وغياب الثقة المتراكم بينها، وهو ما سيفسح المجال لمزيد من التفوق النوعي للمشروع الأمريكي بقيادة إسرائيل”- جيتي
يشهد النظام الدولي في السنوات الأخيرة حالة من التغيرات المتسارعة على المستويين المفاهيمي والعملياتي. فالمفاهيم التقليدية مثل الأمن الجماعي وتوازن القوى وسباقات التسلح تعود للواجهة، ولكن في سياقات جديدة تتسم باضطراب النظام الليبرالي العالمي وتآكل مصداقية المؤسسات الأممية. عمليا، تتجلى هذه التحولات في اشتداد الصراعات والتفاعلات الإقليمية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ومنطقة الساحل الأفريقي، ما يعكس تزايد ضغوط هيكلية من بنيان السياسة الدولية على الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط.
في قلب هذه التفاعلات، شكلت حرب طوفان الأقصى لحظة اختبار حقيقية لبنية العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث انفجرت التناقضات المكتومة داخل النظام الإقليمي، وكشفت عن مدى هشاشة استقلال القرار الاستراتيجي للعديد من الدول، في ظل تفاقم تدخلات القوى الدولية وتزايد التنافس على ترتيبات ما بعد الحرب. وقد بات واضحا أن قوى المنطقة تختلف في كيفية تعاطيها مع هذه الضغوط، وفقا لقدراتها الذاتية وموقعها ضمن منظومة التحالفات الدولية.
ومع تصاعد المواجهة بين القوى الكبرى، وتراجع هيمنة القطبية الواحدة، تتعرض الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط لمستويات غير مسبوقة من الضغوط الهيكلية التي تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ إلى إعادة تعريف مساحات النفوذ والمصالح الاستراتيجية. وتتباين استجابات الدول المركزية في المنطقة لهذه الضغوط بين البحث عن الاستقلال الاستراتيجي وبين الرضوخ لتوازنات قسرية تفرضها الوقائع الدولية.
في قلب هذه التفاعلات، شكلت حرب طوفان الأقصى لحظة اختبار حقيقية لبنية العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث انفجرت التناقضات المكتومة داخل النظام الإقليمي، وكشفت عن مدى هشاشة استقلال القرار الاستراتيجي للعديد من الدول، في ظل تفاقم تدخلات القوى الدولية وتزايد التنافس على ترتيبات ما بعد الحرب
وعلى إثر هذه الضغوط، نسعى في هذا المقال إلى قراءة استراتيجيات دول الشرق الأوسط في مواجهة هذه الضغوط، ونحاول تقييم جدارة هذه الاستراتيجيات أمام هذه التحديات والمخاطر، مع التركيز على مجموعة الدول المركزية، السعودية ومصر وإيران، بالإضافة لدولة تركيا، لما لها من وجود تاريخي ونفوذ يتمدد في المنطقة، ومع الأخذ في الاعتبار تفاوت مقدار الضغوط من دولة لأخرى.
أولا: تُعد تركيا نموذجا بارزا لتحول استراتيجيات الدول الإقليمية من الانخراط الأيديولوجي إلى الواقعية البراغماتية، تحولت الدولة التركية من استراتيجية “العمق الاستراتيجي” التي أطلقها وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو في 2001، إلى استراتيجية “القرن التركي” في 2022، حيث تسعى الدولة التركية إلى تعزيز استقلال الحكم الذاتي، وبناء قدرات محلية ذاتية، وتصفير الخلافات مع قوى إقليمية رئيسة مثل السعودية والإمارات ومصر، وتركيز جهود الدولة على المصالح الوطنية وبناء تحالفاتها شرقا أو غربا وفقا لأجندة هذه المصالح، مع الحفاظ على الانخراط بفاعلية إقليميا ودوليا لتحقيق رؤية القرن التركي.
ولقراءة تموضع الدولة التركية خلال التطورات الأخيرة وفق هذه الاستراتيجية، علينا أن نضع في عين الاعتبار أن حجم الضغوط على تركيا هو محدود نسبيا مقارنة بباقي الدول، بل إن بعض التطورات في المنطقة مثلت انتصارا للدولة التركية خاصة في ملفات سوريا والعراق والأكراد، كما أنها رغم طول الحرب في غزة تجنبت تصعيد الأزمة مع دولة الاحتلال إلى مستويات سياسية ودبلوماسية متقدمة، مكتفية بتقديم المساعدات الإنسانية والانخراط في المحافل الدولية.
وفي نفس السياق، رغم السعي التركي لترميم علاقاتها بالدول العربية إلا أن هذه العلاقات ما زالت باردة، وتواجه العديد من العوائق لتصل إلى مستوى التحالفات الاستراتيجية، وهو ما يجعل موقف الدولة التركية التموضع بعيدا عن الضغوط ومتجنبا الانخراط في أي صراع قد يعرقل مشروع القرن التركي الجديد، مع الحفاظ على فاعلية إقليمية ودولية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ثانيا: تبدو إيران في وضع أكثر تعقيدا، حيث وجدت نفسها بعد طوفان الأقصى -ومع انخراط أذرعها الإقليمية في اليمن ولبنان والعراق في إسناد المقاومة في غزة- أقرب من أي وقت مضى إلى حرب شاملة، ومن أجل تجنب الوقوع في أتون هذه الحرب، اتبعت إيران استراتيجية صارمة لـ”سحب الذرائع”، واكتفت بردود رمزية على محاولات الاستفزاز المتكررة من دولة الاحتلال، في ظل عزلة سياسية واضحة عانى منها النظام خلال حرب الاثني عشر يوما رسميا وشعبيا.
خلال السنوات الماضية، عززت السياسات الإيرانية إقليميا ودوليا من عزلة النظام إلى حدٍ كبير، وهو ما جعل النظام يدرك خطورة مواجهته لهذه الضغوط وحيدا، ورغم تحسن العلاقات الرسمية الإيرانية العربية خلال السنوات الماضية، إلا أن إيران ما تزال بعيدة عن بناء تحالفات حقيقية مع دول المنطقة -أو خارجها- في ظل ضعف الثقة الممتد بين الأطراف، خاصة في ظل استمرار دعم مجموعات مسلحة بعضها متهمة بتهديد استقرار عدة دول عربية. ويبدو أن الاستراتيجية الإيرانية تتجه نحو الانكفاء والترميم الداخلي، مع محاولة الحفاظ على أدوات التأثير الإقليمي في حدود لا تستدعي مواجهة مباشرة مع القوى الكبرى.
ثالثا: أما السعودية، التي دخلت في السنوات الأخيرة مسار إعادة تموضع حذر ضمن التوازنات الإقليمية والدولية، فقد وجدت نفسها أمام معادلة دقيقة بين الضغوط الغربية، خاصة الأمريكية، ورغبتها في الحفاظ على الحد الأدنى من الالتزام بالموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية. ورغم ما تردد عن تفاهمات أمنية غير معلنة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ظلت الرياض متمسكة بموقف رسمي يربط أي خطوات تطبيعية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.
تتبنى السعودية استراتيجية مركبة تستند إلى إدراك دقيق لمعادلة الفجوة بين الطموحات الكبرى والقدرات الفعلية. منذ صعود الأمير محمد بن سلمان، تتجه المملكة لإعادة تعريف دورها من مجرد لاعب نفطي إلى قوة اقتصادية صاعدة تستند إلى مشروعات التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبرى. إلا أن هذه الرؤية لا يمكن أن تنجح في بيئة إقليمية غير مستقرة، ما يفسر سعي السعودية لتحييد أكبر قدر ممكن من مصادر التهديد، سواء من خلال تفاهمات مع إيران، أو تبريد الجبهات مع تركيا، أو حتى من خلال الانفتاح الحذر على دولة الاحتلال عبر قنوات غير معلنة.
مع ذلك، فإن الموقف السعودي في حرب طوفان الأقصى كشف حدود المناورة، إذ لا تستطيع المملكة المضي في التطبيع تحت وطأة المشهد الشعبي العربي والإسلامي الملتهب، ولا يمكنها في الوقت ذاته التضحية بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تمثل مصدر الأمان العسكري، خاصة في ظل محدودية القدرات الدفاعية الذاتية للمملكة مقارنة بالتحديات المتعاظمة. لذلك تتحرك السعودية ضمن مسار معقد يركز على المصالح الوطنية ويتطلع لدور إقليمي أكبر وفق معدلات حذرة، خاصة في ظل غياب رؤية عربية موحدة.
رابعا: تأتي مصر كلاعب رئيس لكنه منهك داخليا. فالأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وضعف الاحتياطي النقدي، وتوسع الدين الخارجي، قلصت من هوامش الحركة الاستراتيجية للدولة المصرية. فعلى المستوى الإقليمي، تبنت القاهرة موقفا أكثر حذرا، متمسكة بدور الوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع السعي لتثبيت تفاهمات الحد الأدنى مع تركيا. في ظل استمرار حالة الجمود السياسي الداخلي، وغياب مشروع تنموي جامع، وانكفاء الجيش على قضايا الأمن الداخلي، جعل من مصر قوة مؤثرة في لحظات الوساطة، لكنها غير قادرة على صياغة موازين قوى جديدة في المنطقة.
مع انزياح العالم نحو تعددية قطبية فوضوية، فإن غياب مشروع عربي موحد، واستمرار تناقضات المشاريع الإقليمية بين تركيا وإيران والسعودية ومصر، سيُبقي المنطقة في دائرة إدارة الأزمات بدلا من تجاوزها، بانتظار تحول نوعي قد يفرضه تغير موازين القوى الدولية أو تحولات سياسية داخلية في الدول الكبرى بالمنطقة
تعيش مصر حالة من الانكفاء القسري بفعل أزمات داخلية عميقة، تدفع الدولة نحو تثبيت علاقتها بالخليج لتأمين تدفقات مالية تضمن استمرارية النظام السياسي داخليا، وإبقاء مساحات تهدئة مع تركيا على قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة. ورغم أن القاهرة تحافظ على قنواتها التقليدية مع الفاعلين الدوليين شرقا وغربا، إلا أن غياب مشروع استراتيجي جامع، والانكفاء على إدارة الأزمات اليومية، يجعلان من مصر فاعلا إقليميا حاضرا بالصورة لكنه غائب بالتأثير الحقيقي.
في التحليل المقارن بين هذه الدول، نجد تفاوتا واضحا في مستويات الاستقلالية الاستراتيجية والقدرات الذاتية. تركيا تبدو الأكثر استقرارا والأقل تعرضا للضغوط، مع هامش مناورة واسع بفضل اقتصاد متماسك وسياسة خارجية متعددة الاتجاهات، في حين أن إيران تبدو الأكثر انكشافا وعزلة رغم امتلاكها أدوات نفوذ إقليمي غير نظامية. تتحرك السعودية في مساحة وسطى، تحاول تعظيم النفوذ الاقتصادي مع تقليل المخاطر السياسية، بينما تبدو مصر في موقع دفاعي يحاول تقليل الخسائر دون امتلاك أدوات تصعيد أو تأثير حقيقي على التوازنات الكبرى.
على ضوء هذه المعطيات، يصعب الحديث عن ميل النظام الإقليمي نحو نموذج “الأمن الجماعي”، حيث تفتقر المنطقة إلى مستوى الثقة الكافي وبنية أمنية مشتركة فاعلة، وتستمر السياسات في إطار لعبة توازنات القوى الهشة. في المدى المنظور، يبدو أن المنطقة ستبقى رهينة لمعادلات مرنة تقوم على تحالفات ظرفية، تتأثر بموازين القوى العالمية أكثر من حسابات المصلحة الإقليمية الذاتية. ومع انزياح العالم نحو تعددية قطبية فوضوية، فإن غياب مشروع عربي موحد، واستمرار تناقضات المشاريع الإقليمية بين تركيا وإيران والسعودية ومصر، سيُبقي المنطقة في دائرة إدارة الأزمات بدلا من تجاوزها، بانتظار تحول نوعي قد يفرضه تغير موازين القوى الدولية أو تحولات سياسية داخلية في الدول الكبرى بالمنطقة.
إجمالا: يمكننا القول إن القوى المركزية في الشرق الأوسط سوف تبقى أكثر انحيازا لمصالحها الوطنية، في ظل غياب مشروع إقليمي واضح، وتناقض مصالح الدول المركزية بشكل كبير وغياب الثقة المتراكم بينها، وهو ما سيفسح المجال لمزيد من التفوق النوعي للمشروع الأمريكي بقيادة إسرائيل وإن شئت فقل المشروع الإسرائيلي بدعم أمريكي.