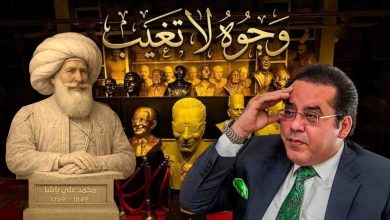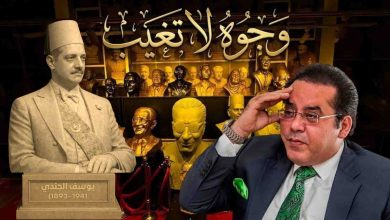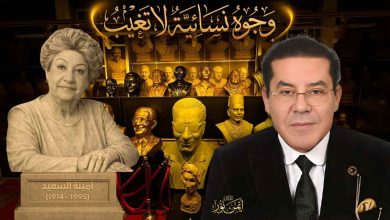في مشهد ينذر بالخطر، تقف مصر على حافة مجاعة مائية حقيقية.
تعتمد البلاد شبه كامل الاعتماد على مياه نهر النيل – شريان الحياة التاريخي – لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة . فعلى الرغم من ثبات حصة مصر السنوية عند 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، لا تحصل البلاد فعليًا إلا على نحو 59.6 مليار متر مكعب إجمالاً من الموارد المائية الطبيعية سنويًا .
وهذا يعني أن أكثر من 90% من موارد مصر المائية تأتي من هذا النهر الواحد . ومع ذلك، تقدر الاحتياجات المائية بأكثر من 114 مليار متر مكعب سنوياً  – أي ضعف المتاح تقريبًا – مما يدفع الدولة إلى تعويض الفجوة عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحمّل فاتورة واردات غذائية ضخمة تعادل 33 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنوياً  .
هذا الاعتماد المفرط على مصدر وحيد ترافق مع انهيار حاد في حصة الفرد المائية. ففي حقبة الستينيات، كان نصيب المواطن المصري حوالي 2000 متر مكعب سنويًا؛ أما اليوم فقد هبط إلى قرابة 500 متر مكعب فقط سنويًا . هذا الرقم يضع مصر تحت خط الفقر المائي الحاد – بل أدنى من نصف عتبة الفقر المائي المتعارف عليها عالميًا (1000 متر مكعب) .
وبحسب إحصاءات رسمية، تراجع نصيب الفرد من المياه إلى هذا المستوى المتدني بعد عقود من النمو السكاني السريع والثبات النسبي لموارد المياه . إذا استمر هذا الاتجاه التنازلي، فقد ينخفض حصة الفرد إلى أقل من 350 متر مكعب بحلول عام 2050 ، في سيناريو مفزع ينذر بعطش مدقع للأجيال القادمة.
لا تقتصر مخاطر الأزمة على العطش المباشر، بل تهدد الأمن الغذائي برمته. الزراعة المصرية – العمود الفقري لغذاء البلاد – تستهلك نحو 80–85% من موارد المياه. ومع تقلّص الموارد، اضطرت الدولة إلى تقليص مساحات زراعات أساسية كثيفة الاستخدام للمياه مثل الأرز وقصب السكر لتوفير المياه  .
بالفعل أعلنت الحكومة خططًا لخفض مساحة زراعة الأرز بنسبة 32% بحلول 2025 بسبب نقص المياه ، رغم ما يعنيه ذلك من تضرر صغار المزارعين وزيادة الاعتماد على استيراد الأرز لتلبية الاستهلاك المحلي . إن استمرار ندرة المياه يعني تراجع إنتاج الغذاء المحلي وازدياد الفجوة الغذائية التي يجب سدها بالواردات، ما يرهق الميزانية ويعرّض البلاد لتقلبات الأسواق العالمية.
ومع ارتفاع عدد السكان وتنامي الطلب، قد تواجه مصر عجزًا عن توفير مياه الري الكافية للمحاصيل الأساسية، مما ينذر بتدهور الرقعة الزراعية وارتفاع البطالة الريفية. هذه العوامل مجتمعة تضع مستقبل مصر الغذائي على المحك، وتحوّل قضية المياه إلى تهديد وجودي لأمن الوطن واستقراره.
سد النهضة الإثيوبي وسدود أخرى: تهديد مباشر لحصة مصر
صورة لسد النهضة الإثيوبي الذي بني على النيل الأزرق قرب حدود السودان – المشروع الذي يثير مخاوف عميقة في مصر من تقليص إمدادات المياه.
في قلب هذه الأزمة المائية يبرز دور إثيوبيا التي تمسك بمنبع النيل الأزرق. فقد شرعت أديس أبابا في عام 2011 في بناء سد النهضة الكبير على النيل الأزرق غير آبهة باعتراضات دول المصب . هذا السد العملاق، الذي يُعد الأكبر في أفريقيا بقدرة توليد تصل إلى 6450 ميجاواط، يتمتع بخزان هائل يمكنه احتجاز نحو 74 مليار متر مكعب من المياه – ما يوازي 88% من متوسط تدفق النيل السنوي عند أسوان .
وبموقعه الاستراتيجي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود السودانية ، بات بمقدور إثيوبيا فعليًا التحكم في أغلب مياه النيل المتدفقة إلى السودان ومصر . هذا الواقع المستجد يثير في القاهرة مخاوف وجودية حقيقية، حيث وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “تهديد وجودي” لا يمكن القبول به .
منذ عام 2020 بدأت إثيوبيا ملء خزان السد على مراحل بشكل أحادي، مستغلة سنوات الوفرة المطرية ومتجاهلة اعتراضات مصر والسودان. ورغم جولات طويلة من المفاوضات الثلاثية، رفضت أديس أبابا الالتزام باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل  . أقدمت إثيوبيا على هذه الخطوة منفردة في غياب أي تنسيق، مما دفع مصر إلى التوجه بمناشدات لمجلس الأمن الدولي للتدخل خشية حدوث إخلال جسيم بالأمن المائي في المنطقة .
وتؤكد القاهرة أن استمرار إثيوبيا في نهجها المتعنت – من دون اتفاق – يهدد بتقليص حصة مصر المائية بشكل خطير، خصوصًا في فترات الجفاف الممتد حين تنخفض إيرادات النيل الأزرق  . فمصر تخشى أنه إذا حلّت سلسلة سنوات جافة بينما يحتجز السد كميات ضخمة خلفه، ستجد نفسها أمام عجز مائي كارثي قد يفوق قدرة السد العالي في أسوان على تعويضه.
تدافع إثيوبيا من جهتها عن حقها السيادي في استغلال مواردها المائية لتوليد الكهرباء والتنمية، مؤكدة أنها لا تنوي إلحاق ضرر جسيم بمصر أو السودان. بيد أن غياب الشفافية والدراسات البيئية المستقلة يزيد الشكوك  . فعلى أرض الواقع، لا ضمانات حقيقية لدى دولتي المصب بشأن كميات المياه التي ستسمح بها إثيوبيا بالعبور سنويًا، لاسيما أثناء فترات الملء أو في سنوات الجفاف. الأسوأ من ذلك، أن نجاح إثيوبيا في تشغيل سد النهضة دون معارضة فعالة ربما يفتح شهيتها لمشاريع أخرى على منابع النيل.
فالاتفاق الإطاري الذي وقعته القاهرة في 2015 أعطى أديس أبابا شرعية لبناء سد النهضة ، ويفسره البعض على أنه موافقة ضمنية أيضًا على بناء سدود أخرى مستقبلًا على النيل وروافده . بالفعل بنت إثيوبيا سدودًا عديدة على أنهار أخرى داخل أراضيها خلال العقود الماضية، وتخطط لتحويل نفسها إلى “بطارية أفريقيا” عبر سلسلة مشروعات مائية. هذا السيناريو يقرع ناقوس الخطر في مصر؛ إذ قد لا يقتصر الأمر على سد النهضة وحده، بل ربما تجد القاهرة نفسها في مواجهة سلسلة سدود تقيد تدفق النهر التاريخي شمالًا، ما يعني تآكلًا إضافيًا لحصتها المائية الشحيحة أصلاً.
مواقف السودان وإسرائيل: أدوار إقليمية معقدة
لم تكن مصر وحدها في معركة المياه هذه؛ فـالسودان الجار والشريك في مياه النيل يعيش هو الآخر تداعيات السد الإثيوبي بقلق وتوجس. موقف الخرطوم تجاه سد النهضة اتسم بالتأرجح والتعقيد. فمن ناحية، يرى السودانيون جوانب إيجابية محتملة للمشروع، منها الحصول على كهرباء بأسعار مخفضة من إثيوبيا، والأهم تنظيم تدفق النيل الأزرق والحد من الفيضانات المدمرة التي اعتاد السودان مواجهتها . فبحيرة السد يمكن أن تعمل كحاجز ينظم اندفاع المياه في موسم الأمطار ويحمي القرى السودانية على ضفاف النيل من الغرق. كذلك قد يحسن السد توفر المياه للري في موسم الجفاف عبر إطلاق تدفقات ثابتة. هذه المنافع جعلت الخرطوم تميل في البداية إلى التأني وعدم تبني لهجة التصعيد المصرية.
لكن من ناحية أخرى، لم تغفل السودان عن المخاطر الجسيمة. فغياب اتفاق ملزم يثير مخاوف تقنية وأمنية حادة في الخرطوم. يخشى السودانيون أن يؤدي تشغيل سد النهضة دون تنسيق إلى اضطرابات في إمدادات المياه تصل إلى مشروعاتهم الزراعية وسدودهم الداخلية (كسد الروصيرص مثلًا الذي يبعد بضعة كيلومترات فقط عن سد النهضة).
كما يساورهم هاجس السلامة الإنشائية للسد الإثيوبي: فأي خلل أو انهيار – لا قدر الله – سيعني إطلاق عشرات المليارات من الأمتار المكعبة دفعة واحدة نحو الأراضي السودانية أولاً بحكم الجغرافيا . إن حدوث فيضان هائل بسبب انهيار السد سيؤدي إلى كارثة عارمة في السودان قبل أن يصل تأثيره إلى مصر. لذلك تشدد الخرطوم على ضرورة اتفاق شامل يضمن تبادل البيانات اللحظية حول تشغيل السد، والتنسيق في حالات الطوارئ والجفاف، حفاظًا على أمنها المائي وسلامة مواطنيها.
وقد انضمت السودان لمصر في مطالبة مجلس الأمن بالتدخل عام 2020 لتحذير إثيوبيا من الملء الأحادي ، مؤكدة أن الأمن الإنساني لملايين السودانيين على طول النيل على المحك. وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية الداخلية التي يمر بها السودان مؤخرًا والتي أضعفت دوره التفاوضي، يبقى موقفه الثابت هو المطالبة بالاتفاق القانوني الملزم الذي يكفل حقوق الجميع ويجنب المنطقة أخطار المواجهة.
أما إسرائيل – وإن لم تكن دولة مطلة على حوض النيل – فإن ظلها حاضر في المشهد المائي الإقليمي بصورة متزايدة. فخلال فبراير 2025، وقعّت إسرائيل وإثيوبيا اتفاقًا للتعاون في مجال إدارة المياه والطاقة، مما أطلق أجراس إنذار في القاهرة . يرى مراقبون أن إسرائيل تسعى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي عبر بوابة المشروعات المائية، مستفيدة من خبراتها التقنية في الري وتحلية المياه. وبالنسبة لمصر، جاء هذا التقارب الإسرائيلي الإثيوبي بمثابة استفزاز خطير يثير التساؤلات حول النوايا الخفية.
ولا عجب أن تنتشر قناعة راسخة في الأوساط المصرية مفادها أن إسرائيل وقوى أخرى تستخدم إثيوبيا كأداة لإضعاف مصر وتركيعها من خلال حرمانها من ماء النيل، شريان حياتها الوحيد  . هذه النظرية – التي قد يراها البعض مبالغًا فيها – تجد جذورها في وقائع تاريخية ومعاصرة: فإسرائيل منذ عقود تطمح للاستفادة من مياه النيل، وسبق أن طُرحت خطط لمد أنابيب من النيل إلى صحراء النقب في السبعينيات والثمانينيات. كما تشير تقارير غير مؤكدة إلى دعم تقني وأمني إسرائيلي لإثيوبيا في حماية سد النهضة.
ورغم أن إسرائيل تنفي تدخلها المباشر في الخلاف المائي، إلا أن تنامي علاقتها بإثيوبيا اقتصاديًا وعسكريًا يثير حفيظة القاهرة. فمصر تنظر إلى أي دعم إسرائيلي لأديس أبابا – سواء كان في صورة تكنولوجيا للري والزراعة أو تعاون استخباراتي – بأنه تهديد غير مباشر لأمنها القومي المائي. ومما يعزز هذه الشكوك أن إسرائيل نجحت عبر عقود في تحقيق أمنها المائي الداخلي بنسبة كبيرة (من خلال تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف بكفاءة عالية)، وبالتالي فهي ليست في موقف المتضرر من أزمات المياه الإقليمية، بل ربما المستفيد من إعادة رسم خريطة النفوذ.
وفي المحصلة، يضيف الدور الإسرائيلي بُعدًا جيوسياسيًا معقدًا لأزمة مياه النيل، ويدفع مصر للتيقظ من تحالفات إقليمية قد تتشكل على حساب مصالحها المائية التاريخية.
غياب الشفافية وتقصير النظام المصري بقيادة السيسي
في خضم هذه التحديات الخارجية، يواجه النظام المصري ذاته انتقادات لاذعة بشأن إدارته لملف أزمة المياه. فالكثيرون يحملون حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية التقصير في حماية أمن مصر المائي، بل ويتهمونها باتخاذ خطوات كارثية ساهمت في تفاقم المأزق الحالي. يتصدر هذه الانتقادات اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان في الخرطوم.
بموجب هذا الاتفاق، اعترفت مصر رسميًا بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة  دون الحصول بالمقابل على ضمان صريح لحصتها التاريخية من المياه. اعتُبر ذلك تنازلًا استراتيجيًا خطيرًا؛ فالاتفاق لم يتضمن أي أرقام تلزم إثيوبيا بتصريف كميات محددة من المياه سنويًا نحو دول المصب ، واكتفى بعبارات عامة عن الاستخدام العادل وعدم الإضرار. بل إن صياغة بنوده الفضفاضة – كما يشير محللون – تركت المجال لتفسيرات تسمح لإثيوبيا بالمضي قدمًا في مشاريع مائية أخرى مستقبلًا دون معارضة تذكر .
بعبارة أخرى، منح السيسي بتوقيعه هذا الاتفاق “قبلة الحياة” لسد النهضة ، إذ وفر لأديس أبابا الغطاء الشرعي للحصول على التمويل الدولي واستكمال البناء على قدم وساق، فيما لم تحصل القاهرة سوى على وعود بالتعاون ومشاركة معلومات لم تتحقق فعليًا .
وينظر الإثيوبيون الآن إلى ذلك الاتفاق كمرجعية يستندون إليها لرفض أي مقترحات مصرية أو سودانية تتجاوز ما ورد فيه .
لم تتوقف الانتقادات عند حدود الاتفاق المشؤوم. يعيب الخبراء على نهج الحكومة المصرية افتقاره للشفافية والمصارحة الداخلية حيال خطورة الأزمة. فطيلة سنوات المفاوضات مع إثيوبيا، غابت المعلومات الدقيقة عن الشعب بشأن ما يدور في الغرف المغلقة. وعندما تأزم الوضع وشارفت إثيوبيا على إتمام الملء الثالث والرابع لخزان السد، خرج السيسي في كل مرة ليُطمئن الناس بأن “المياه خط أحمر” ولن يُسمح بالمساس بحصة مصر ، دون أن يشرح خطة واضحة بديلة.
بل كثيرًا ما لجأ الرئيس إلى إلقاء اللوم على أطراف أخرى لتبرير الأزمة – أبرزها ثورة يناير 2011 – حيث كرر مرارًا أن حالة الفوضى التي رافقت تلك الثورة هي ما شجّع إثيوبيا على بدء مشروع السد . هذا الخطاب لم يعد يقنع شريحة واسعة من المصريين؛ فكلما حمل السيسي الثورة مسؤولية ضياع مياه النيل، رد عليه معارضون ونشطاء بأن المسؤول الحقيقي هو سياساته هو  . وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كتب مغردون غاضبون أن “السيسي فرّط في حق مصر المائي ومنح إثيوبيا الضوء الأخضر” حين وقع اتفاق 2015 . ويذهب البعض إلى القول إنه “ضلل المصريين” بإعطائهم وعودًا زائفة، بينما الواقع أن السد بات أمرًا واقعًا وإثيوبيا تخزن المياه خلفه دون اكتراث .
على الصعيد السياسي الداخلي، تواجه المعارضة المصرية تضييقًا حين تحاول إثارة قضية السد وانتقاد تعاطي النظام معها. فوسائل الإعلام الرسمية قللت لسنوات من خطورة الأزمة، وروّجت لنجاح الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على الحقوق المائية، إلى أن فوجئ الشارع باتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية. وحتى حين ارتفعت بعض الأصوات المحذرة – من خبراء مياه أو شخصيات معارضة – قوبلت بالتهميش أو التخوين.
هذه الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع زعزعت ثقة قطاعات من الشعب في قدرة الحكومة على إدارة الملف. فنسبة كبيرة من المصريين لم تدرك حجم الخطر إلا متأخرًا، ولم يتم إعدادهم نفسيًا ولا عمليًا لاحتمال شحّ المياه. أضف إلى ذلك مشاريع داخلية مكلفة استنزفت موارد مالية هائلة دون جدوى واضحة بالنسبة للأزمة المائية (مثل توسيع رقعة الأراضي الزراعية في الصحراء أو إنشاء عاصمة إدارية جديدة تستهلك الكثير من المياه)، وكلها تعرضت لانتقادات بأنها أولويات في غير محلها بينما الخطر الوجودي يلوح في الأفق. ومع تفشي الغلاء وتدهور الاقتصاد ، يشعر المواطن العادي بأن الدولة تقصّر في أهم واجباتها: تأمين لقمة عيشه وكأس مائه.
في المحصلة، يقف النظام المصري اليوم في مرمى سهام النقد. يراه منتقدوه مسؤولًا عن ورطة تاريخية بسبب سوء التقدير والتهاون في الدفاع عن الحقوق المائية. فسنوات ما بعد 2015 أهدرت في مفاوضات عقيمة بينما مضت إثيوبيا في فرض الأمر الواقع. ولم تتحرك القاهرة بفاعلية على الساحة الدولية إلا وهي في موقع الضعيف الذي يطلب العون متأخرًا.
وحتى خيار التهديد العسكري الذي لوّح به السيسي صراحة في 2021 – بقوله إن “المياه خط أحمر وأي مساس بها سيؤدي لعدم استقرار يفوق الخيال”  – جاء متأخرًا جدًا ولم يؤدِ إلى تغيير يذكر في موقف إثيوبيا، بل اعتُبر للاستهلاك المحلي وتهدئة الغضب الشعبي. وبينما يدخل السد مرحلة التشغيل الفعلي، تجد مصر نفسها محاصرة بأزمة خانقة صنعها خصومها الإقليميون ولكن ساهمت سياسات نظامها في تفاقمها. هذا النقد السياسي الصريح قد يكون قاسيًا، لكنه في عيون كثيرين ضرورة لمحاسبة المسؤولين وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.
سيناريوهات سوداء: ماذا لو وقعت مجاعة مائية فعلية؟
إذا استمر المسار الحالي للأزمة دون حل، قد تجد مصر نفسها خلال سنوات أمام كابوس مجاعة مائية حقيقي. في مثل هذا السيناريو الأسود، سيتجاوز الأمر مجرد العطش إلى انهيار شامل لمقومات الحياة. أولى الضحايا ستكون الرقعة الزراعية المصرية التي تعتمد كليًا على الري من النيل. سوف يجف التراب في مساحات شاسعة من دلتا النيل وواديه، وتتحول الحقول الخضراء إلى أرض بور متشققة تحت شمس حارقة.
سيضطر المزارعون إلى هجر أراضيهم التي لم تعد تجود بالمحصول، لينضموا إلى طوابير الباحثين عن لقمة العيش في المدن المكتظة. هذا النزوح الريفي سيفاقم البطالة والفقر الحضري ويخلق أحزمة عشوائيات جديدة حول القاهرة وغيرها من المدن، بما تحمله من مشاكل اجتماعية وأمنية.
على صعيد الغذاء، ستواجه البلاد عجزًا متفاقمًا في إنتاج المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والذرة. وستضطر مصر إلى استيراد معظم غذائها بكلفة باهظة، في وقت تعاني فيه العملة المحلية والاقتصاد من ضغوط شديدة. إن انعدام الأمن الغذائي قد يصبح واقعًا مريرًا لملايين الأسر ، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وتقلب إمدادات الأسواق الخارجية. وقد يعيد هذا شبح طوابير الخبز وأزمات التموين التي عاشتها مصر في عقود ماضية، لكن في ظروف أشد قسوة هذه المرة.
كما أن نقص مياه الشرب نفسها سيكون خطرًا محدقًا. فمع انخفاض منسوب النيل، ستعجز محطات تنقية المياه عن تلبية احتياجات المدن والقرى. وربما نشهد انقطاعًا متكررًا للمياه عن الأحياء السكنية، وتراجُعًا في جودة المياه المتاحة. في الريف، قد يجف الكثير من الترع والقنوات الصغيرة التي يعتمد عليها الأهالي، فيضطرون للجوء إلى مياه جوفية عميقة مكلفة الاستخراج أو حتى إلى مياه ملوثة. هكذا يمكن أن يصبح الوصول إلى ماء نظيف امتيازًا نادرًا بدلاً من كونه حقًا مكفولًا للجميع.
ولا تتوقف الكارثة عند الاقتصاد والصحة؛ فالتبعات الاجتماعية والسياسية قد تكون أخطر. تصاعد البطالة وانهيار الزراعة وندرة الغذاء والماء كلها عوامل قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة واحتقان شعبي غير مسبوق. حين يعجز الناس عن ري عطشهم وإطعام أطفالهم، سوف تتنامى مشاعر الغضب واليأس.
وقد تتحول هذه المشاعر إلى احتجاجات عارمة أو اضطرابات أمنية تهدد استقرار البلاد. يشير خبراء إلى أن تصاعد انعدام الموارد الأساسية يربك العقد الاجتماعي بين الشعب والدولة، ويضعف ثقة المواطنين في قدرة الحكومة، ما قد يفجر توترات داخلية خطيرة . ولنا في تجارب دول مجاورة عبرة، حيث ساهم الجفاف وفشل المحاصيل في اندلاع نزاعات أهلية واضطرابات سياسية.
علاوة على ذلك، قد تضطر مصر تحت وطأة العطش الشديد إلى إجراءات تقشف مائي غير مسبوقة. ربما يجري تقنين صارم للاستهلاك المنزلي والصناعي، فتُحدد حصص يومية للفرد من مياه الشرب، وتُمنع زراعة محاصيل معينة بشكل قاطع، ويُعاد استخدام مياه الصرف في أغراض الشرب بعد معالجتها على نحو واسع. مثل هذه الخطوات الضرورية ستكون لها تكلفة اجتماعية وصحية عالية، لكنها قد تصبح واقعًا لا مفر منه في حالة المجاعة المائية.
على المستوى الإقليمي، لن تكون مصر وحدها المتضررة. فأي انهيار اقتصادي أو اجتماعي في مصر جراء نقص المياه سينعكس على جوارها عبر موجات هجرة بشرية محتملة أو زعزعة للاستقرار الإقليمي. وقد تدخل مصر في نزاعات مع دول أخرى حول المياه (كسعي البعض لنقل مياه نهر الكونغو مثلاً أو تحلية مياه البحر الأحمر بمعونة دولية)، مما قد يخلق توترات جيوسياسية جديدة في المنطقة.
باختصار، سيناريو المجاعة المائية في مصر أشبه بقنبلة موقوتة: انهيار زراعي، شح ماء للشرب، غلاء فاحش للغذاء، اضطرابات اجتماعية، وانفلات أمني محتمل. ولعل أخطر ما في الأمر أن كل مكونات هذا السيناريو بدأت تلوح في الأفق ما لم يُتدارك الموقف سريعًا. إنها صورة قاتمة، لكنها تحذير ضروري لاستشعار حجم الكارثة المحدقة إذا بقينا على المسار الحالي دون تغيير جذري.
طوق النجاة: حلول دبلوماسية وفنية وتحالفات… وحتى عسكرية
رغم قتامة المشهد، لا تزال هناك سلسلة من الحلول والسيناريوهات التي يمكن لمصر اتباعها لتجنب الأسوأ وتخفيف حدة أزمة المياه. هذه الحلول يجب أن تكون متكاملة ومتزامنة، تمزج بين التحرك السياسي والدولي، والابتكار التقني، وبناء التحالفات، والاستعداد للخيارات الصعبة. فيما يلي أبرز المسارات المطروحة:
1. المسار الدبلوماسي والدولي: يبقى الحل التفاوضي هو السبيل الأكثر أمانًا واستدامة. على مصر أن تستمر في الضغط الدبلوماسي عبر كل المحافل لحشد الدعم لقضيتها العادلة في الحق في المياه. لقد حققت القاهرة نجاحًا نسبيًا عام 2020 عندما توسطت الولايات المتحدة والبنك الدولي في مفاوضات كادت تثمر اتفاقًا قبل أن تتعنت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة .
يمكن البناء على تلك الصيغة بدعوة وسطاء دوليين جدد من الأطراف المؤثرة (كالاتحاد الأوروبي أو الصين أو الاتحاد الأفريقي) للمشاركة في إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم. كما تستطيع مصر تصعيد القضية مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد أن تعنت إثيوبيا يهدد السلم الإقليمي ويتطلب ضغطًا جماعيًا. وإقليميًا، ينبغي العمل على إعادة السودان إلى طاولة التفاوض جنبًا إلى جنب مع مصر – حالما تسمح أوضاعه الداخلية – لتشكيل جبهة مصب موحدة تطالب بحقوقها.
كذلك قد تنظر القاهرة في التحكيم الدولي أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي قانوني يُدين أي أضرار جسيمة تلحق بمصالحها المائية. ورغم أن إثيوبيا ترفض حتى الآن وساطات أو تحكيمًا خارج مظلة الاتحاد الأفريقي ، فإن استمرار العزلة الدولية والضغوط قد يدفعها في النهاية إلى التراجع عن موقفها المتشدد. باختصار، يتطلب المسار الدبلوماسي مثابرة وصبرًا مع تصعيد محسوب يوضح للعالم أن مصر سلكت كل السبل السلمية الممكنة.
2. الحلول التقنية وإدارة الموارد: بالتوازي مع المعركة الدبلوماسية، على مصر خوض معركة الاكتفاء المائي بأدوات التكنولوجيا والإدارة الرشيدة. فمن الضروري تبني خطة شاملة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام كل قطرة ماء. ويشمل ذلك التوسع السريع في مشاريع تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط لتوفير مياه للشرب والصناعة، وتقليل الاعتماد على النيل في تلك القطاعات. بالفعل بدأت الدولة تنفيذ خطط لبناء محطات تحلية عملاقة بطاقة ملايين الأمتار المكعبة يوميًا، ضمن استراتيجية تمتد لعقدين قادمين.
أيضًا ينبغي الاستثمار بقوة في معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها لأغراض الري والزراعة. وقد قطعت مصر خطوات في هذا الاتجاه عبر إنشاء محطات معالجة ضخمة مثل محطة بحر البقر ومحطة المحسمة، التي تعالج مليارات الأمتار المكعبة من مياه الصرف الزراعي سنويًا لإعادة استخدامها . هذه المشاريع يجب مضاعفتها لتشمل كل شبر ممكن من الأراضي الزراعية القابلة للري بمياه معاد تدويرها. وفي القطاع الزراعي، لا مفر من إعادة هيكلة التركيب المحصولي ليلائم الواقع المائي الجديد.
بمعنى آخر، يجب الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالقمح والأرز وقصب السكر في غير المناطق المناسبة، واستبدالها قدر الإمكان بمحاصيل أقل استهلاكًا أو أصناف محسنة موفرة للماء . كما يتعيّن نشر تقنيات الري الحديث (التنقيط والرش) بدلًا من أساليب الري بالغمر التقليدية التي تهدر كميات ضخمة – علمًا أن كفاءة الري الحالي في مصر بالكاد 50%  وهي نسبة متدنية يجب رفعها بشكل عاجل. ولا ننسى أهمية إصلاح البنية التحتية المائية من ترع وقنوات لمنع التسرب والهدر، وتبطينها حيث أمكن.
وعلى المدى الأبعد، يمكن لمصر استكشاف حلول ابتكارية أكبر، مثل مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول في سيناء والصحراء (بالرغم من محدوديتها)، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل محطات التحلية لخفض التكلفة. إن تبني هذه الإجراءات التقنية والإدارية سيعزز مرونة المنظومة المائية المصرية ويقلل اعتمادها الكلي على النيل، مما يخفف تبعات أي خفض قسري في إيراداته مستقبلاً.
3. التحالفات الإقليمية وضمانات المنفعة المشتركة: قد تجد مصر أنه من الحكمة بناء شراكات وتحالفات إقليمية تساعدها في تجاوز أزمتها المائية. فعلى صعيد دول حوض النيل، يمكن تعزيز التعاون مع دول المنابع الاستوائية (كأوغندا وكينيا وتنزانيا) عبر دعم مشاريع تنموية هناك مقابل الحصول على حصة من مياه تلك البلدان الغزيرة الأمطار أو التعاون في مشاريع للربط المائي الإقليمي. هناك أفكار مطروحة – وإن كانت معقدة – مثل ربط نهر الكونغو بنهر النيل أو نقل كميات من مياه بحيرة فيكتوريا عبر جنوب السودان إلى شماله، وهي أفكار تحتاج دراسات مستفيضة لكنها تستحق النظر كحلول بعيدة المدى.
إقليميًا أيضًا، يمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في مجال إدارة المياه دون حساسية سياسية، خصوصًا في مجالات التحلية المتقدمة وإعادة تدوير المياه والزراعة الحديثة. لقد أصبحت إسرائيل رائدة عالميًا في تحلية مياه البحر لدرجة تحقيق فائض مائي، ويمكن أن يكون هناك تعاون علمي وتقني يستفيد منه الجانب المصري لتسريع مشاريعه . كذلك تستطيع مصر تعزيز شراكاتها مع دول الخليج العربي التي تملك فوائض مالية وتقنيات تحلية متطورة، بحيث تُشرك هذه الدول في الاستثمار بمشاريع المياه المصرية مقابل امتيازات اقتصادية متبادلة. بالفعل أبدت السعودية والإمارات اهتمامًا بتمويل محطات تحلية جديدة ومزارع إنتاج زراعي في مصر، ما يمكن توسيعه إلى مبادرة إقليمية لأمن المياه تشمل دعم مصر في مواجهة الأزمة.
وعلى المستوى الإفريقي، قد تقود القاهرة حراكًا عبر الاتحاد الأفريقي لبلورة اتفاقية أوسع لحوض النيل تضمن التنمية للجميع دون الإضرار بأحد، بحيث تحصل إثيوبيا على الكهرباء التي تحتاجها ويحصل السودان ومصر على تدفق مائي آمن ومعلومات آنية عن إدارة أي سدود. مثل هذه المعادلة التكاملية – إن نجحت دبلوماسيًا – ستخلق واقعًا جديدًا يجعل المياه عنصر تعاون لا صراع. في المحصلة، يتعين على مصر توظيف كل أوراق القوة الناعمة والتحالفات الممكنة لتأمين شبكة أمان إقليمية تدعم موقفها وتساعدها فنيًا وماليًا لعبور محنة الشح المائي.
4. الخيار العسكري كملاذ أخير: على قدر خطورته، يبقى الخيار العسكري حاضرًا في أذهان البعض كحل استثنائي إذا وصلت الأمور إلى تهديد وجودي حقيقي لمصر ولم تُجْدِ كل السبل الأخرى. وقد سبق لمسؤولين مصريين – من عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وصولًا إلى الرئيس السيسي – التلويح ضمنيًا أو صراحة بإمكانية اللجوء للقوة لحماية حقوق مصر المائية إذا استنفدت الوسائل السلمية  .
يشمل ذلك سيناريوهات مثل ضربة جوية محدودة تستهدف منشآت سد النهضة لتعطيل ملئه أو تخريب أجزاء منه، أو عمليات تخريب سرية من خلال قوات خاصة أو دعم حركات معارضة لإثيوبيا، وغيرها مما تم تداوله في مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام  . لا شك أن القدرات العسكرية المصرية تتفوق بمراحل على نظيرتها الإثيوبية من حيث العدة والعتاد  – فالقاهرة تمتلك أسطولاً جوياً متطورًا من المقاتلات ويمكنها نظريًا الوصول إلى عمق إثيوبيا عبر التزود الجوي بالوقود أو استخدام قواعد صديقة. كما تمتلك مصر ذخيرة خبرات حرب 1973 حين ضربت أهدافًا بعيدة.
لكن التحديات والعوائق أمام هذا الخيار جسيمة للغاية . فسد النهضة يقع على بعد يقارب 1500 كم من أقرب قاعدة جوية مصرية، مما يتطلب ترتيب مرور عبر أجواء دول أخرى (السودان أو إريتريا) واحتمال موافقة ضمنية منها. ثم إن السد هدف صعب للغاية – منشأة خرسانية ضخمة قد لا تُحدث فيها ضربة جوية ضررًا كافيًا إن لم تكن محكمة، بل ربما لا تؤدي إلا لتأخير المشروع بضعة أشهر. والأسوأ أنه في حال نجحت ضربة في إحداث تصدّع أو تدمير جزئي للسد والخزان ممتلئ، ستكون العواقب كارثية مباشرة على السودان المجاور بفيضانات هائلة قد تزهق أرواح آلاف الأبرياء .
كما أن القيام بعمل عسكري سيشعل نزاعًا إقليميًا مفتوحًا؛ فإثيوبيا سترد ربما بضربات انتقامية (رغم ضعف قدراتها مقارنة بمصر، قد تلجأ لحرب عصابات بالوكالة أو استهداف مصالح مصرية في القرن الأفريقي). وستفقد مصر التعاطف الدولي الذي حظيت به كطرف سعى للسلام، لتصبح في نظر البعض المعتدي الذي قوّض منشأة مدنية كبرى. أضف إلى ذلك احتمال تورط أطراف دولية بشكل غير مباشر في دعم هذا الجانب أو ذاك، مما قد يوسّع دائرة الصراع. باختصار، الخيار العسكري مخاطره تفوق كثيرًا فوائده المحتملة، وقد يجلب نتائج عكسية تقضي على آخر ما تبقى من أمل في حل سلمي وتدفع بالمنطقة إلى أتون صراع لا يمكن التنبؤ بمآلاته.
مع ذلك، يراه البعض خيارًا لا ينبغي إسقاطه تمامًا من الحسابات – كوسيلة ضغط قصوى – بشرط أن يظل ملاذًا أخيرًا جدًا عندما يتعرض أمن مصر المائي لحافة الهاوية ولا يتبقّى أي مجال آخر للتحرك. وحتى في هذه الحالة، ينبغي التفكير مليًا ببدائل كعمليات استخباراتية مركزة أو ضربات تحذيرية رمزية قبل الإقدام على أي خطوة قد تؤدي إلى دمار شامل. في النهاية، الرسالة التي تريد مصر إيصالها عبر التلويح بالقوة هي أن “المياه بالنسبة لمصر حياة أو موت” وليست مجرد قضية تنموية عابرة، على أمل أن تعي أديس أبابا وداعموها جدية هذا التحذير فتجنّب الجميع أسوأ السيناريوهات.
ختامًا، مصر اليوم أمام منعطف تاريخي حرج فيما يتعلق بأمنها المائي. مجاعة مصر المائية القادمة ليست مجرد عنوان درامي بل احتمال واقعي ما لم يتحرك الجميع – حكومة وشعبًا ومجتمعًا دوليًا – لتدارك الأسباب ومعالجة الخلل. لقد عاش المصريون لآلاف السنين على هبة النيل، وازدهرت حضارتهم على ضفافه، فباتت مياه هذا النهر جزءًا من وجدانهم الجمعي وهويتهم الوطنية.
اليوم، يشعر المصريون أن شريان حياتهم يُضغط بقوة، وأن مستقبل أبنائهم مهدد بالعطش والجوع إذا انقطع عنهم فيضان النهر المبارك. إنها لحظة حقيقة تستدعي وقفة صادقة: فإما أن تتكاتف الجهود لإبرام اتفاق عادل يحفظ حقوق الجميع في مياه النيل، مدعومًا بخطوات داخلية جريئة لتحقيق الاكتفاء المائي؛ أو يترك المصريون لمصير مجهول في صراع وجودي على مورد الحياة الأول. وكما يقول المثل الشعبي الدارج: “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” – فكيف إذا كان “الرزق” هنا ماء الحياة نفسه؟
إن صوت مصر يرتفع الآن، محذرًا ومنذرًا، لعل العالم يصغي ولعل إثيوبيا تتعقل قبل أن يحل الطوفان. ومهما كان الطريق طويلًا وشاقًا، فلا خيار أمام مصر إلا خوض معركة البقاء هذه حتى النهاية، دفاعًا عن حق أبنائها في شربة ماء ولقمة عيش كريمة، وعن وعد النيل الأزلي الذي ارتبط بميلاد مصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.