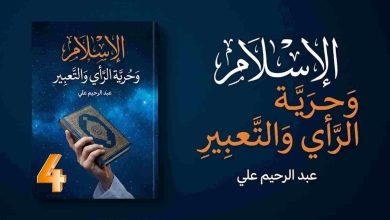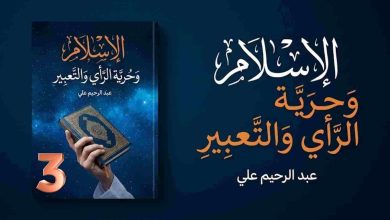د. أيمن نور يكتب: الإنسان المسطّح في عصر الاستهلاك. حين يُختزل الوعي إلى قائمة خيارات مزيفة

يظنّ البعض أن القمع يولد فقط من فوهة بندقية، أو يُدار عبر صفارات الأجهزة الأمنية.
لكن الحقيقة المؤلمة تكشف أن أخطر أشكال القمع ليست تلك التي تُراق فيها الدماء، بل تلك التي تُسكب في فناجين القهوة اليومية… قمع ناعم، تافه، لامع، يُقدَّم في إعلانات الهواتف، وفي لوائح الانتخابات، وفي وجوه المذيعين.
لم يكن هربرت ماركيوز فيلسوفًا يكتب من برج عاجي، بل شاهِدًا على مجزرة الوعي في أرقى المجتمعات الصناعية.
رأى الإنسان يُسلَب أبعاده دون طلقة واحدة، دون استجواب، دون معتقل، فقط بتقنية ذكية، وشاشة خرساء، وإعلان يهمس: “اختر… ولكن مما اخترناه نحن لك!”
هذا الكائن الجديد الذي وصفه ماركيوز بـ”الإنسان أحادي البعد” ليس ناتج قمع سلطوي مباشر، بل نتاج هندسة دقيقة للرضا العام،
حيث تُحوّل الثورة إلى ماركة، والحلم إلى سلعة، والمعارضة إلى اختيار موسمي ضمن حملات “البلاك فرايداي”.
الحداثة لم تمنح الإنسان حريته، بل جردته من قدرته على التمييز بين الحريّة والواجهة، بين الاختيار والإكراه المُقنّع.
صار يفتخر بالرفاهية التي تُخدّره، ويصطف أمام أبواب المتاجر الإلكترونية كمن ينتظر حقنةً تطيل غيبوبته الفكرية.
الثورة التي يخشاها هذا العصر ليست تلك التي تقتلع أنظمة، بل تلك التي تُعيد للإنسان وعيه بما يُسرق منه وهو يضحك،
بما يُصادَر منه وهو يصفّق. المسألة لم تعُد فيمن يحكم، بل في الكيفية التي يُعاد بها تشكيل العقل الجماعي ليقبل كل ما يُلقى إليه، حتى القيد… إذا جاء في لونٍ مبهج.
التكنولوجيا التي زُفّت إلينا كعروس العصر، صارت زوجةً صامتة لا تُنجب غير التكرار.
لم تُوسّع أفقنا، بل قزّمت أحلامنا، حوّلت اللغة من أداة للتفكير الحر إلى قناة للتكرار، ومن وسيلة للاحتجاج إلى إعلان. حتى مفردات التحرر أُفرغت من معناها، وأُعيد تعبئتها لتُسوَّق داخل نفس النظام الذي صادَرها.
لا يملك الإنسان اليوم أن يقول “لا” دون أن يُسأل عن البديل.
لا يُسمح له بأن يحلم، دون أن يُعرض عليه خيار في قائمة، وعليه أن يختار: “حلم مُعدل”، أو “حلم قابل للتقسيط”. أما الحلم الكامل، فهو غير متاح في نسختنا الحالية.
ما كتبه ماركيوز لم يكن بيانًا شيوعيًا ولا نداءً راديكاليًا، بل كان صرخة ليبرالي حرّ، يُدافع عن الإنسان ضد تسليعه،
عن الوعي ضد تدجينه، عن الحرية ضد تحويلها إلى خيار مسبق الصنع. في فلسفته قدر من المرارة النبيلة، لكنه لا يدعونا للانسحاب، بل لليقظة.
جوهر الأزمة لا يكمن في الآلة، بل في من يُشغّلها.
ليست التكنولوجيا وحدها مَن تسجننا، بل غياب سؤالنا الأخلاقي عن غايتنا، عن دورنا، عن شكل الحياة التي نريدها لأنفسنا، لا تلك التي يُراد لنا أن نعيشها دون أن نسأل لماذا.
ما نحتاجه ليس ثورة على الواقع فحسب، بل على اللغة التي تُجمّله، على المسلّمات التي تُبرّره، على التسميات التي تُخدّرنا.
نحتاج إلى أن نُعيد تعريف الإنسان، لا كمستهلك صالح، بل ككائن حرّ، يُفكر، يُخطئ، يحتجّ، ويصوغ مصيره دون وصاية.
عندما تُختزل الحرية إلى حرية اختيار شكل الهاتف، وتُختصر السياسة في أداء واجب التصويت،
وتُختزل الحياة في تطبيقات تتعقّب خطواتنا وأفكارنا، يصبح استرداد البُعد الإنساني فعلاً من أفعال المقاومة، وواجبًا وجوديًا لا يُؤجَّل.
بين عتمة الرضا المُبرمج، وضوء الحريّة الحقيقية، يقف هذا الجيل عند مفترق طرق،
لا يحتاج فيه إلى ثورة شعبية بقدر ما يحتاج إلى ثورة معرفية. فكرية. نفسية. تُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والعالم، بين الفرد والنظام، بين الحلم والممكن.
لا خلاص بلا وعي، ولا وعي دون سؤال، ولا سؤال بلا جرأة على تجاوز ما يُقال إنه “واقع”، أو “قدر”، أو “ممكن”.
فقد آن أوان التمرّد الجميل على قُبح الخضوع، وعلى أنسنة القيد، وعلى خيانة المعنى… باسم التطور والحداثة والذكاء.
والحرية – كما كتب ماركيوز – لا تعني أن نختار بين سلع، بل أن نمتلك القدرة على رفض السوق برمّته،
إن كان السوق هو ما يصادر إنسانيتنا باسم الرفاه.
فهل نستحق الحريّة؟
نعم… حين نُدرك أن أثمن ما نملكه ليس “الخيار”، بل القدرة على الحلم خارج المنظومة.