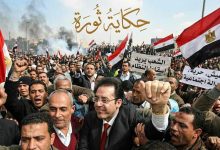في رائعته “الجريمة والعقاب”، أبدع فيودور دوستويفسكي في رسم أبعاد الصراع النفسي لشابٍّ لم يتورّع عن ارتكاب جريمة قتل، حاول بعدها تبرير فعلته النكراء بذرائع أخلاقية. ولأن الجاني عجز عن سداد إيجار مسكنه في موعده، فقد قرّر التوجّه إلى منزل مرابية لرهن ساعته، وهناك لمعت في رأسه فكرة التخلّص منها، بل أقدم على قتلها بالفعل، ومعها سيّدة أخرى صادَف وجودها في مكان الجريمة.
ورغم أنه لم يُقبَض عليه متلبّساً بارتكاب جريمته، إلا أنه حاول إقناع نفسه بأنه خلّص المجتمع من مرابية تستحقّ العقاب، معتقداً أنه “أعلى مرتبةً” من هذا النوع من البشر. وقد برع أديبنا المبدع في رسم شبكة العلاقات المحيطة ببطل الرواية، بكلّ ما يعتمل فيها من تعقيدات إنسانية أدخلته أزمةً نفسيةً وفكريةً عنيفةً، لينتهي به الحال إلى اعترافه بجريمته وتسليم نفسه للعدالة.
تذكّرتُ هذا العمل الروائي المبدع بينما كنت أتابع عبر شاشات التلفاز مشاهد التجويع والإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، وفجأة انبثق في ذهني سؤال حول نوع الإبداع الذي كان يمكن لأديب في حجم دوستويفسكي أن يستلهمه من مشاهد كهذه، لو قدّر له أن يعيش بيننا.
فالجاني الإسرائيلي يعتقد أنه يتمتّع بتفوّق أخلاقي مستمدّ من “محرقة” تعرّض لها اليهود في ألمانيا النازية، والضحية الفلسطيني شعب احتُلَّت أرضه وانتُهِكت حقوقه، ويتعرّض منذ عامَين لعمليات تجويع ممنهج وتطهير عرقي. ورغم ما يبديه من مقاومة أسطورية، وما يقدّمه من تضحياتٍ لا مثيل لها في التاريخ الإنساني، يجد نفسه محشوراً داخل بيئة محيطة عاجزة تماماً عن تقديم أيّ دعم حقيقي لنضاله المشروع. ولأن لدى المجرم الإسرائيلي ثقة تامّة في قدرته على الإفلات من العقاب، فليس من المتوقّع أن يدخل في أزمة نفسية تُفضي به إلى الاعتراف بالذنب.
لإسرائيل حلفاء أقوياء يتولّون تزويدها بكلّ ما يعينها على مواصلة ما ترتكبه من جرائم والإفلات من العقاب في الوقت نفسه
لن يكون بمقدور أحد إنقاذ الشعب الضحيّة ممّا يُرتكَب في حقّه من جرائم تشكّل وصمةَ عارٍ في جبين الإنسانية، مهما بلغ خيال الراوي، فلإسرائيل حلفاء أقوياء يتولّون تزويدها بكلّ ما يعينها على مواصلة ما ترتكبه من جرائم والإفلات من العقاب في الوقت نفسه.
صحيح أن النظام الدولي يضمّ دولاً أخرى قوية، ليست بالضرورة حليفةً لإسرائيل، ولا تتردّد في التنديد علناً بما ترتكبه من جرائم، غير أنها تعجز عن اتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ لوقف هذا السلوك الإجرامي، إمّا بسبب عدم القدرة أو انتفاء الرغبة.
وصحيح أيضاً أن دولاً كثيرة تتحدّث عن تعاطفها مع القضية الفلسطينية، في مقدّمتها الدول العربية والإسلامية، لكنّها لم تتمكّن من اتخاذ أيّ إجراء يساعد على وقف العدوان، ناهيك عن إنزال العقاب بالمعتدي.
لم يشهد النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية دولاً تشبه إسرائيل في إصرارها على تحدّي القانون الدولي. ورغم صدور أمر من المحكمة الجنائية الدولية بمثول بنيامين نتنياهو، شخصياً أمامها، إلا أن الأخير، وهو رئيس حكومة هذه الدولة العاصية، ما زال يواصل جرائم الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني، ويتصرّف كأنّه فوق القانون. ولتفسير ظهور هذه الحالة الشاذّة يتعيّن أن نأخذ في الاعتبار جملة من الحقائق المتعلّقة بمسؤولية الأطراف المعنية عمّا جرى (ويجري)
. تتعلّق الحقيقة الأولى بمسؤولية الولايات المتحدة. فهذه المسؤولية لا تقلّ عن مسؤولية إسرائيل نفسها، إن لم تكن أكبر، بدليل أن حكومة نتنياهو حدّدت لنفسها أهدافاً تتجاوز بكثير ما يمكن أن يُعدَّ ردَّة فعل طبيعي أو منطقي على ما قامت به حركة حماس في “7 أكتوبر” (2023)، إذ اتّخذت من “طوفان الأقصى” ذريعةً لإقامة “إسرائيل الكبرى”.
ولأن الولايات المتحدة تماهت تماماً مع مجمل هذه الأهداف، رغم عدم شرعيّتها، وقدّمت لإسرائيل كلّ ما تستطيع من دعم مادّي وسياسي ولوجستي واستخباراتي لتمكينها من تحقيقها، بل وصل الأمر إلى حدّ إقدام إدارة ترامب على الاشتراك مع إسرائيل في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية.
فإذا أضفنا إلى ما تقدّم أن الولايات هي الدولة الوحيدة التي بمقدورها وقف هذه الحرب في أيّ لحظة، لكنّها لم تفعل، وأنها الدولة الوحيدة التي حالت (وما تزال) دون تمكين مجلس الأمن من فرض أيّ عقوبات على إسرائيل، خصوصاً بعد أن قتلت الأخيرة مئات من موظّفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، بل وصل بها الأمر إلى حدّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لردع الأخيرة وثنيها عن مواصلة إجراءات القبض على نتنياهو ومحاكمته، لتبيّن لنا بوضوح تامّ أنها تتحمّل المسؤولية الرئيسة عن إطالة أمد الحرب.
وربّما من المفيد هنا تذكير القارئ بأن ترامب تحدّث علناً عن صغر مساحة إسرائيل وحاجتها الماسّة للتوسّع، وعن رغبته في إخلاء قطاع غزّة من سكّانه تمهيداً لإقامة “ريفييرا” مكانه، وأن نتنياهو نفسه لم يجرؤ على التحدّث علناً عن تهجير الفلسطينيين من القطاع إلا بعد أن نطق به ترامب.
تعجز دول كبرى عن اتخاذ إجراءات لوقف سلوك إسرائيل الإجرامي، إمّا بسبب عدم القدرة أو انتفاء الرغبة
تتعلّق الحقيقة الثانية بمسؤولية الدول الأوروبية، فقد انحازت الغالبية الساحقة من هذه الدول إلى إسرائيل منذ بداية الأزمة، وقدّمت لها كلّ ما تستطيع من عون مادّي ومعنوي، بل شارك بعضها مباشرة في التصدّي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية التي أُطلقت على إسرائيل.
ويلاحظ أنها لم تبدأ في اتخاذ مواقفَ مستقلّةٍ نسبياً عن الموقف الأميركي إلا متأخّراً، وبعد اندلاع مظاهرات شعبية عارمة في معظم عواصمها احتجاجاً على ما تقوم به إسرائيل من أعمال إبادة جماعية وتجويع ممنهج للشعب الفلسطيني. ورغم عدم جواز التقليل من أهمية إعلان عدة دول أوروبية رئيسة، مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وغيرها، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن التحرّك في هذا الاتجاه ينطوي على دلالةٍ يغلب عليها الطابع الرمزي.
ولأنه كان بمقدور الدول الأوروبية أن تؤثّر فعلياً في مسار الأحداث، وأن تجبر إسرائيل على التفكير جدّياً في وقف الحرب، لو أن مؤسّسات الاتحاد الأوروبي كانت قد اتّخذت قراراً بفرض عقوبات تجارية أو مالية جماعية عليها (وهو ما لم يحدث)، يمكن القول إنها تتحمّل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. وأظن أن المعلق الصحافي الإسرائيلي، جدعون ليفي، كان محقّاً تماماً حين كتب: “كان على إسرائيل أن تشكر كلّ من يعترف بدولة فلسطين، إذ جاء هذا الاعتراف بديلاً مخادعاً للخطوة الحقيقية التي كان لا بدّ من اتخاذها: العقوبات. فالاعتراف مجرّد بديل شكلي للمقاطعة والعقوبات التي يجب أن تُفرض على دولة ترتكب إبادةً جماعية. إنه مجرّد كلام أجوف تتبنّاه حكومات أوروبا المتردّدة والضعيفة، لتُظهِر لجماهيرها الغاضبة أنها ليست صامتة”.
تتعلق الحقيقة الثالثة بمسؤولية القوى الدولية الكبرى المتعاطفة إعلامياً مع القضية الفلسطينية، وفي مقدّمتها روسيا والصين. فلم يكن موقفهما في الواقع على المستوى المطلوب، بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، رغم عدم جواز التقليل من أهمية ما قدّمتاه من دعم سياسي في مجلس الأمن، ومن دعم إعلامي، عكسته بيانات الشجب والإدانة.
وكان يمكن لموقفيهما أن يكون أكثر تأثيراً بالنسبة إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات لو أنهما قرّرتا استخدام سلاح العقوبات، أو حتى مجرّد التلويح به، خصوصاً أن علاقات تجارية وعسكرية واسعة النطاق تربطهما بإسرائيل. لذا لا نعتقد أننا نظلمهما حين نقوم بتحميلهما جانباً من المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة والتجويع.
لا تقل مسؤولية الولايات المتحدة عن مسؤولية إسرائيل نفسها عن الجريمة في غزّة
أمّا مسؤولية الدول العربية والإسلامية (الحقيقة الرابعة) فهي كبيرة جدّاً، بالنظر إلى ما تدّعيه هذه الدول من التزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني. وحين تعجز دول تتحدّث باسم أكثر من مليار ونصف مليار عربي ومسلم عن إدخال مساعدات لشعب تصرّ إسرائيل على إبادته، إمّا قتلاً أو جوعاً، فلا بدّ أن يشكّل ذلك وصمة عار في جبينها.
وكان بمقدور عدد كبير منها فعل كثير لوقف هذه المأساة، من دون التورّط في الانزلاق نحو الحرب. وعلى سبيل المثال، كان بمقدور الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن تتّخذ موقفاً جماعياً بسحب سفرائها وقطع جميع أشكال العلاقات معها، أو التهديد بها على الأقلّ، لكنّها لم تقم بأيّ منهما. وكان بمقدور الدول العربية والإسلامية التي ترتبط بعلاقات خاصّة مع الولايات المتحدة، سيما الدول الغنية المؤثّرة على سوق النفط، بأن تضغط على الولايات المتحدة كي تضغط بدورها على إسرائيل، لكنّها لم تفعل.
وهناك مؤشّرات كثيرة تؤكّد أن عدداً لا يستهان به من هذه الدول فضلّ أن تنتهي الحرب بإخراج “حماس” من المعادلة، وراح ينتظر، وهذا هو ما فهمه نتنياهو وبنى مواقفه على أساسه، ومن ثمّ تمكّن من استغلاله أسوأ استغلال. لذا، يمكن القول إن تخاذل معظم الدول العربية والإسلامية في مساندة الشعب الفلسطيني في محنته، بسبب عدائها الواضح لحركة حماس، يعدّ أحد الأسباب الرئيسة لإصرار نتنياهو على التمادي في غيّه.
صدرت عن نتنياهو أخيراً تصريحاتٌ تقطع بأن طموحاته لا تقتصر على هزيمة “حماس”، وإنما تتجاوز ذلك بكثير، خصوصاً أنه يطمح لكي يُتوَّج ذات يوم ملكاً على “إسرائيل الكبرى” التي يدرك جيّداً أنها لا يمكن أن تقوم إلا بعد بناء “الهيكل الثالث”. وما لم تتمكّن الدول العربية والإسلامية من اتخاذ إجراءات تجبر إسرائيل والولايات المتحدة على وقف الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والمجاعة، وفتح الباب أمام آفاق حقيقية لتسوية عادلة لقضيته، فسوف تصحو هذه الدول ذات يوم (ليس ببعيد) على مشهد المسجد الأقصى وهو يُهدَم لإقامة الهيكل على أنقاضه.