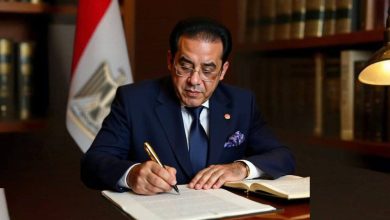هوية على مائدة الجوع، صورة موجعة، وسؤال يقطر ألماً، هل ما زال المصريون أبناء حضارتهم، أم أضاعوا في زحام الفقر ما تبقى من ملامحهم.
الجواب عسير، فلا (نعم) تجدي، ولا (لا) تنصف، إذ وحده التاريخ سيشهد، والأرض ستكتب.
لكن مجرد طرح السؤال، في حد ذاته، نذير شؤم، إذ أن ضياع الهوية لا يعني فقدان اسم أو مظهر، بل يعني اقتلاع الجذور، وانهيار الحاضر، إنتظاراً لمستقبل آخر مختلف، تغدو فيه (خيانة) اليوم، (وطنية) بمعايير المستقبل المختلف.
إنها صيحة في واد، وناقوس خطر لا يسمعه إلا من أرهقهم الجوع، ففئات من الشعب تتلوى ألماً، ولا حكومة تواسي، ولا تكافل يداوي.
فالصحة سقطت في هوة عميقة، والدواء صار حلماً بعيداً، والطبيب بات أسير عجزه.
والسكن تحول إلى جدار من نار، إيجارات ملتهبة، وعقارات لا يقدر على شرائها إلا قلة، والبقية إما لصوص أو منتفعين.
أما التعليم، فحجرات مكتظة بأجساد التلاميذ، تعلمهم العنف قبل أن تعلمهم الكلمات، وتغرس فيهم أن الحقوق لا تؤخذ إلا باليد، لا بالقانون، ذاك الواقع المرير في مدارس اليوم.
فما الوطن إذن : أهو أرض تحرس بالدبابات، أم حياة كريمة تصان بالعدل ..
إن الوطن حياة، وكرامة، ومسكن، ودواء، وعلم، وعدالة، وهذا ما فهمه قديماً (جمال عبد الناصر)، فرفع من شأن الفلاح، والعامل، فجعل الولاء للوطن أغنية في القلوب.
ولكن حين تغيب الحقوق، تتلاشى الواجبات، ويصبح الوطن في أعين الناس مسرحاً للمنتفعين.
واليوم، في زمن الشاشات المفتوحة، يرى الجائع بأم عينه بذخ الساحل الشمالي، حيث تنفق الملايين على نزوات عابثة، تكفي لإنقاذ أجيال من البسطاء.
في النهاية :
مصر اليوم تمر بخلل عظيم، فقد غابت العدالة في كل شيء، وانصرفت عن العامة، ورحلت إلى الخاصة.
فإن لم يعالج الخلل سريعاً، فانتظروا ثورة لا تبقي ولا تذر.
ثورة تهدم قبل أن تبني، وتكسر كل وهم في صدور الناس عن (عسكر) يدعون حماية الوطن.
فالعسكر الذين كانوا في زمن (عبد الناصر) رفعوا الفلاح والعامل، أما عسكر اليوم، فما رفعوا إلا الفئة الحاكمة، وأهملوا عامة الشعب.
وعلى الله قصد السبيل