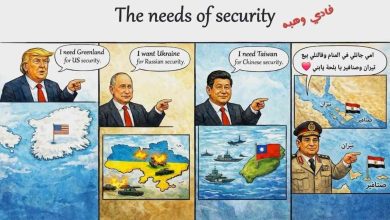تشكل الأنظمة الديكتاتورية إشكالية تاريخية مستمرة، حيث لا يقتصر أثرها المدمر على فترة حكمها فحسب، بل يمتد ليطال مرحلة سقوطها أيضًا، مُخلّفةً وراءها دمارًا شاملاً يصعب ترميمه.
والمفارقة اللافتة أن هذه الأنظمة، على الرغم من سجلها الحافل بالقتل والقمع، تمكنت دائمًا من تقديم نفسها بصورة مزيفة، مدعية السعي لتحقيق قيم سامية كالحرية والعدالة، بينما كان همها الوحيد هو التمسك بالسلطة وتوريثها، لتصبح شعاراتها مجرد غطاء باهت يفتقر لأي مضمون حقيقي مع مرور الوقت.
غير أن الخطر الأكبر لا يكمن في الديكتاتورية القائمة فقط، بل في منهجية إسقاطها.
فالعنف والثأر، وإن نجحا في إزاحة نظام مستبد عن كرسي الحكم، فإنهما يفشلان حتمًا في تحقيق غايتين أساسيتين: الأولى، استئصال الشهية للاستبداد المتجذرة في النفوس بعد عقود من القهر.
والثانية، والأهم، هي أن استخدام أدوات النظام الديكتاتوري ذاتها من عنف وإقصاء يؤدي حتمًا إلى ولادة ديكتاتورية جديدة، وإن كانت بلباس مختلف وشعارات جديدة، مما يضع المجتمع في حلقة مفرغة من الاستبداد.
ولكسر هذه الحلقة، يبرز ضرورة ملحة لتبني آليات نضالية جديدة تقوم على أسس أخلاقية راسخة، يكون هدفها ليس مجرد إسقاط الطغيان، بل إقامة نظام عادل يحول دون عودته.
فمواجهة الاستبداد بالاستبداد ضرب من العبثية التاريخية، والسبيل الوحيد لضمان انتقال ناجح إلى الحرية هو الالتزام بمبادئ واضحة، يكون النضال السلمي فيها خيارًا استراتيجيًا ثابتًا لا يتزعزع، وليس مجرد تكتيك مرحلي.
ويقتضي هذا النجاح وجود رؤية سياسية واضحة المعالم تسبق أي تحرك شعبي.
فالهدف يجب أن يتعدى إسقاط الحاكم إلى بناء نظام بديل قائم على العدالة، بينما يجب أن ترتكز الاستراتيجية على خلق بيئة ملائمة للنضال السلمي ونشر الوعي بأهميته، حتى تحت أقسى ظروف القمع.
وقد تنبثق هذه الاستراتيجية قبل انطلاق الاحتجاجات أو تتشكل بعد تفجرها، لكن الثابت أن إغفال هذه المعادلة الأخلاقية والسياسية المعقدة يهدد بإجهاض أي ثورة، مهما بدت ناجحة في بدايتها، ويُعيد إنتاج النظام المستبد نفسه تحت مسميات جديدة، والثورة قادمه لا محالة.