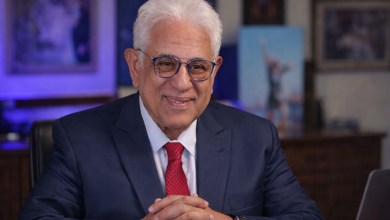تمثل السمة الأساسية للنظام الشمولي تركيزَ كل السلطات بين يدي الحاكم، حيث تُحوَّل مؤسسات الدولة إلى أدوات لإسقاط شخصيته ونظرياته وسلوكه على كافة هياكل الحكم. فتذوب حدود الدولة وسياستها وإعلامها في شخص الحاكم المطلق، ليصبح هو التجسيد الوحيد للدولة وخارج إرادته لا وجود لكيان مستقل.
يروج هذا النظام لصورة “المنقذ المعصوم” و”المفكر الأوحد” و”القائد الذي لا يُضاهى”، في عملية تأليه تهدف إلى إبادة أي صوت منافس أو أي إرادة مستقلة، حيث أن أي اقتراب من دائرة نفوذه المقدسة! يصطدم بقمع لا هوادة فيه. يعتمد استمرار هذه النظم على آلية مزدوجة: الأولى تتمثل في تفكيك النسيج المجتمعي عبر تهميش الأفراد والجماعات، وهز ثقة الإنسان في نفسه وقدراته، وتشويه مكوناته العاطفية والعقلية والأخلاقية.
تتحول الحياة اليومية إلى سلسلة من الخوف والترقب، حيث تُسلب المبادرة من الشعوب لتبقى لسنوات تحت سطوة القمع، عاجزة عن التحرر من قيود العبودية الطوعية التي يُروج لها على أنها قدر محتوم وشرعية مفترضة.
الركيزة الثانية هي السيطرة المطلقة على موارد الدولة واقتصادها، حيث يعمل الحاكم منذ لحظة توليه السلطة على حصر الثروة والسلطة في يديه وفي يد حلقة ضيقة من المحاسيب والمقربين من العائلة الحاكمة ومشايخ الطوائف والاعلاميين والصحفين ورجال الجيش والشرطه والقضاء الفاسدين هذه السيطرة المزدوجة – على العقل والرزق – تخلق واقعاً يشعر فيه المجتمع بالعجز عن التغيير، فينزع إلى تقبل “أقل الخسائر” تحت نير النظام بدلاً من السعي لتحقيق “أكبر المكاسب” عبر تحدي سلطته.
ليس الخروج على النظام الشمولي عمليةً هينة أو حدثاً عابراً يمكن إنجازه بين عشية وضحاها، بل هو خيار استراتيجي ينبع من قناعة راسخة تتبنى رؤى وأفكاراً وخطط عمل واضحة، تهدف إلى فرز الواقع المرير عما يجب أن يكون، أي الانتقال من حالة الاستلاب إلى حالة التحرر.
والحقيقة الجوهرية هنا هي أن شرعية أي نظام ديكتاتوري، مهما بلغت قوته وقمعه، لا تُستمد إلا من خلال قبول الشعوب به أو صمتها عنه. فبدون “شعب مُشرّع” للاستبداد، ولو بالسكوت، لا يمكن للديكتاتورية أن تستمر. وعليه، فإن الخطوة الأولى والأهم في مسيرة التفكيك هذه هي سحب الشرعية الشعبية من النظام، وكسر حاجز الصمت والخوف.
وفي حين يبدو المجتمع الدولي متحفظاً في الغالب على دعم عملية التغيير الجذري، بل وقد يفضل الاستقرار الوهمي على المخاطرة بتغيير غير مضمون العواقب، تبقى المهمة الأساسية ملقاة على عاتق القوى الوطنية الداخلية.
يجب أن تبدأ الشعوب في استعادة زمام المبادرة عبر سحب السلطة والموارد من يد النظام بشكل عملي، وذلك من خلال بلورة مشروع وطني جامع. هذا المشروع يجب أن يكون ثمرة جهد تشاركي تضطلع به كافة – أو أغلب – القوى المناضلة الحقيقية، وأن يتضمن رؤية واضحة وجدولاً زمنياً واقعياً يستشرف مخاطر المرحلة الانتقالية بين سقوط الاستبداد وقيام الديمقراطية.
إذا ما نجح هذا المشروع في تشخيص علل النظام السابق واستغلال مواطن ضعفه وهشاشته، فإنه سيتحول إلى أداة جاذبة للقوى الصامتة (“الرمادية”) وحتى لأجزاء من قاعدة النظام نفسه، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية ووضوح تصدعات السلطة. عندها فقط، يمكن لكفة الديمقراطية أن ترجح وتتخطى مخاطر المرحلة الانتقالية ومكائد المتربصين بها. والثورة قادمة لا محالة