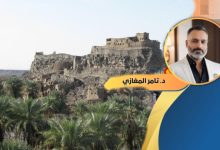“تستعد إثيوبيا للافتتاح الرسمي لأحد أكبر السدود في العالم على رافد نهر النيل الأزرق. في حين يوفر النيل الأبيض حصة ثابتة، ولكن صغيرة نسبيًا من المياه (حوالي 10%–15%)، يساهم النيل الأزرق بحوالي 70%–85% من إجمالي تدفق مياه النيل.
تم تشييد السد بين عامي 2011 و2025، والغرض الأساسي منه هو إنتاج الكهرباء لتخفيف النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا وتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.
ويُعد السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومن بين أكبر 20 محطة في العالم، بقدرة كهربائية تبلغ 5.15 جيجاواط، التوقعات السنوية لتوليد الطاقة تبلغ 16153 جيجاوات ساعة (ج و س)، أي ما يعادل عامل حمل المحطة (أو عامل الانتاج) بنسبة 28.6%.
ويقدم تمويل السد (حوالي 5 مليار دولار) دروساً حيوية في دبلوماسية البنية التحتية والسيادة الوطنية.
وخلافاً للعديد من المشاريع الأفريقية الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على القروض المقدمة من الصين أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فقد تم تمويل البناء الأساسي للسد إلى حد كبير داخلياً من خلال المليارات التي تم جمعها عن طريق السندات الحكومية والمساهمات العامة. وقد وفرت هذه الاستراتيجية لإثيوبيا نفوذاً دبلوماسياً حاسماً.
ومع ذلك، تظل الصين لاعباً مهماً من خلال تمويل خطوط النقل الرئيسية ودعم البنية التحتية من خلال القروض المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الصيني، في حين تم منح عقود الهندسة والبناء لشركات صينية.
ويوضح مشروع السد التحديات الأساسية والتعقيدات التي تواجه دبلوماسية الطاقة في الممارسة العملية.
إن الافتقار إلى اتفاقيات ملزمة وثقة متبادلة مستقرة بين إثيوبيا والسودان ومصر يخلق مخاطر نقص المياه، والاضطرابات الاقتصادية، والصراع المحتمل داخل منطقة حساسة جيوسياسيا.
إن إعلان مصر في منتصف عام 2025 عن توقف المفاوضات والتزامها الراسخ بحماية حقوقها المائية يسلط الضوء على خطورة هذه المخاطر.
وبالنسبة لمصر، التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة على نهر النيل للحصول على أكثر من 90% من مياههم، فإن السد يشكل تحدياً وجودياً، ويغذي المخاوف العميقة والضرورة الديبلوماسية الملحة.
وارتفعت احتياجات البلاد من المياه مع نمو عدد سكانها وتوسع اقتصادها بشكل كبير.
وبدلاً من تحسين وتحديث البنية التحتية للمياه، وتقليل ممارسات الري المهدرة، وتحسين استخدام المياه بشكل عام، ركزت مصر على مشاريع ضخمة تفرض ضغوطاً كبيرة على موارد المياه النادرة في المنطقة.
وأثار السودان، الذي يخوض حربا أهلية مدمرة منذ عام 2023، مخاوف بشأن تأثير السد الإثيوبي على عمليات السدود الخاصة به. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة إدارة خطط التنمية في الخرطوم.
ويؤثر السد على 11 دولة، اثنتان في اتجاه مجرى النهر وتسعة في اتجاه المنبع. وتقع مصر والسودان في اتجاه مجرى النهر. ولا يحصلون على مياه النهر إلا بعد مروره عبر دول المنبع التسع.
لقد هيمنت الاتفاقيات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية على الإطار القانوني الذي ينظم تخصيص مياه النيل. وقد احتضنت الدولتين الواقعتين أسفل النهر، السودان ومصر، هذه الدول، ولكن الدول التسع الواقعة أعلى النهر تنافست عليها.
ومن أهم هذه الاتفاقيات المعاهدة الإنجليزية المصرية لعام 1929، والمعاهدة المصرية السودانية لعام 1959.
ولطالما زعمت إثيوبيا وغيرها من دول المنبع أنها لم تكن أطرافاً في معاهدات الحقبة الاستعمارية، وبالتالي فهي غير ملزمة بها.
ما هي المبادئ الدولية التي توجه استخدام المياه عبر الحدود؟
ركائز القانون الدولي للمياه العابرة للحدود هي:
(أ) الاستخدام العادل والمعقول
(ب) الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم
(ت) واجب التعاون.
وقد لاحظ علماء القانون الدوليون أن معاهدة النيل لعام 1959 تتناقض بشكل حاد مع هذه المبادئ. فهو يتجاهل الحقوق السيادية للدول المشاطئة الأخرى في حصتها العادلة من نهر النيل ويتدخل في تنميتها.
ومن ناحية أخرى، إذا تمكنت البلدان الثلاثة من التغلب على المواجهة والتحرك نحو الإدارة التعاونية لموارد النيل، فإن السد يحمل القدرة على تعزيز تقاسم السلطة على المستوى الإقليمي، والتنمية المستدامة، وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتوضح هذه الحالة كيف يجب على دبلوماسية الطاقة المعاصرة أن تجمع بشكل فعال بين الخبرة الفنية والاعتبارات البيئية والمفاوضات السياسية لإدارة الموارد المتجددة المشتركة بشكل بناء ومستدام