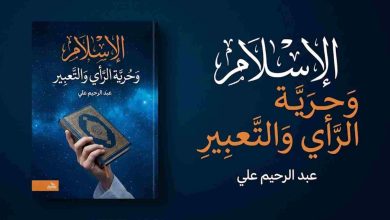الحياة سلسلة من الحروب. حروب مع الآخرين، وحروب أكثر مع ذواتنا. حروب لا نستأذنها ولا تستأذننا، نُزَفّ إليها كما يُزفّ العريس إلى ليلةٍ لا يعرفها. نخرج منها أحيانًا بجرحٍ صغير، وأحيانًا بأثقالٍ من أسئلة لا يملك العقل شجاعة أن يجاوبها، فتظلّ معلّقة بين السماء والأرض، كأمنية لم تكتمل.
أسئلة العمر تتزاحم كالأطفال في زحام المدارس: ماذا بعد؟ هل اخترنا الطريق حقًا؟
أم أن الطريق هو الذي اختارنا؟ نؤجّل الإجابة كما نؤجّل أحلامنا، نضعها على رفّ الغد، ثم نكتشف أنّ الغد ليس أكثر رحمةً من الأمس، وأن الإجابة كانت قريبة لكننا لم نرها إلا في عتمة الطريق.
الحياة لا تُخلو من المنغصات، لكن المشكلة أننا نتقن الهروب. نهرب إلى صمتٍ ملوّن، إلى صبرٍ ثقيل، إلى ترفّعٍ يظنّه الآخرون تخليًا. فنصبح قافلة من وجعٍ فرديّ، يمشي كل واحدٍ فيها بلا رفيق، وكأن المعنى اختبأ خلف الركام.
نمضي بالجاذبية الأرضية، نهرٌ يسيل نحو المصبّ. نحمل أحلامنا في حقائب مثقوبة، نكتشف عند كل محطة أن الأثقال أشدّ مما تحتمل ظهورنا، وأن الطريق يزداد وعورة، كأنّ القدر يتلذذ برؤيتنا نتعثّر.
نعيش بين خيبات تتكاثر كالأمطار، وأشواقٍ للوطن تنكسر كالأغنية قبل أن تبلغ آخر بيت.
حياتي قصيدة ناقصة. بداياتها رائحة خبز أمي، وصوت أبي، وسكينة بيتٍ صغير في صباح الوطن. أما نهاياتها، فمخاوف غربة، وجوه غابت، وأحلام انطفأت قبل أن تضيء. نغنّي للحياة، ونعلم أنها أسرع من خطواتنا، كما نعلم أن الوطن يمضي نحو الانهيار أسرع من أحلامنا المؤجّلة.
صار الوطن، والبيت، والحب، طيفًا يراودني في المنام، وجرحًا أسكنه قبل أن يسكنني. يشيخ مثلي، ويجرح مثلي، لكنه يبقى حاضرًا، كالأم التي وإن غابت لا تغيب.
أحيانًا نمشي في دروب العمر مثل عشاق قدامى، نجرّ أسئلتنا الثقيلة كما نجرّ ذاكرة مثقوبة. نسمع صدى أصواتنا في الفراغ، فنظنّه جوابًا، فإذا به سؤال جديد يتولّد من رماد أسئلة قديمة. وكأننا محكومون أن نظلّ في البحث، لا لنصل إلى الحقيقة، بل لنظلّ أحياءً بمجرد السعي إليها.
مشكلتي الكبرى، أنني أحبّ الاستماع لأسطوانات “الستّ” ذات الوجه الواحد، الأغنية الواحدة، التجربة الكاملة المكتفية بذاتها. بينما شركاء العمر يرون الحياة قرصًا مدمجًا، مليئًا بالمقاطع المتناقضة، أصوات تصعد كنشيد، وأخرى تهبط كأنين، لكنها تكتسب عندهم جمالها من نقصانها، ومن جنونها، ومن غموض الآتي بعدها.
لو عرفت أم كلثوم كم المتاعب التي سبّبتها لي في حياتي، لطلبت يدي لتُرضيني، أو لأصدرت “سي دي” مشتركًا مع عمرو دياب وكاظم الساهر، وربما مع شاكوش أيضًا! علّها تعيد لقصيدتي الناقصة بيتها المفقود، ولحياتي معناها الغائب، ولأسئلتي بعض الجواب.
وهكذا بدا زواجي من أم كلثوم، زواجًا بلا مأذون، وبلا شهود، لكنه طويل مثل ليل أغانيها، وحقيقي مثل وجعي حين أفتقدها. كنت أظنه نزوةً عابرة، فإذا به رفيق دربٍ ممتد، يمتحن صبري، ويغذّي وحدتي، ويملأ فراغ القلب بأغنية واحدة أعيدها ألف مرة، وكأنها صلاة لا تملّها الروح.
ومعها، لا أحتاج إلى اعترافٍ آخر، يكفيني أن تبوح هي عني بما لم أستطع قوله:
“أعطني حريتي أطلق يديّا
إنني أعطيتُ ما استبقيتُ شيّا”
“فكروني تاني في حبك
ونسيت إني نسيت زمان”
“هذه ليلتي وحلم حياتي
بين ماضٍ من الزمان وآتِ”
لعلها ليلتي فعلًا، ليلة زفاف مؤجلة، لم تُكتب على ورق رسمي، لكنها وُقّعت بالحبر السرّي للأغاني، وزُففت فيها لا إلى عروسٍ من لحمٍ ودم، بل إلى أغنية واحدة، امرأة واحدة، وطن واحد.