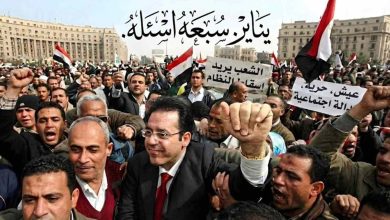مقدمة
لم تكن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجرد ورقة سياسية عابرة، أو محاولة لإحياء مسار تفاوضي ميّت منذ سنوات، بل جاءت لتكون مشروعًا استراتيجيًا متكاملًا لإعادة صياغة الشرق الأوسط.
“الخطة الكبرى” كما أسماها ترامب، لا تتعلق فقط بالقضية الفلسطينية، بل تمس بنية الإقليم بأكمله، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى، تُعيد فيها القوى الكبرى رسم الخرائط وفق مصالحها.
ما الذي تعنيه الخطة؟
جوهر الخطة يقوم على إنهاء أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفصل غزة عن الضفة الغربية، وتحويل القطاع إلى كيان منزوع السيادة يخضع لوصاية أمريكية–بريطانية مباشرة من دون أي غطاء أممي أو شرعية دولية.
ومع بقاء الاحتلال الإسرائيلي ممسكًا بالحدود والمعابر، تتحول غزة إلى “منطقة اختبار” لاحتلال متعدد الطبقات: احتلال إسرائيلي مباشر، وصاية دولية، وانتداب غربي جديد.
الأهداف المعلنة
ترامب وحلفاؤه يقدمون الخطة باعتبارها طريقًا إلى “السلام” و”الأمن”، لكن الواقع يكشف غير ذلك:
- إسرائيل تُمنح النصر الرمزي الذي عجزت عن تحقيقه ميدانيًا بعد حرب طويلة.
- نتنياهو يجد في الخطة مخرجًا من أزماته الداخلية ومحاكم الفساد.
- ترامب نفسه يسعى لإنجاز تاريخي يعيد تقديمه كزعيم عالمي، ويمنحه أملًا في جائزة نوبل للسلام.
الأهداف الخفية
وراء الأهداف السياسية، تكمن أطماع اقتصادية صريحة.
ترامب تحدث علنًا عن غزة كـ”واجهة بحرية عقارية” مميزة، مستنكرًا انسحاب إسرائيل منها عام 2005.
هذا يكشف أن الخطة ليست فقط سياسية، بل مشروعًا استثماريًا عقاريًا ضخمًا، وراءه مصالح الشركات الكبرى، والسيطرة على موارد الغاز قبالة سواحل غزة، وتحويل القطاع من ساحة مقاومة إلى مشروع تجاري مربح.
آليات التنفيذ
الخطة تحدد آليات عملية لتنفيذها:
- نزع السلاح بقيادة توني بلير وبمشاركة إسرائيلية–دولية، لتدمير الأنفاق ومصادرة الصواريخ.
- مطاردة المقاومين عبر بناء سجون خاصة وتصنيف آلاف الفلسطينيين كـ”مشتبه بهم”.
- الميليشيات العميلة مثل المستعربين وأبو شباب لتنفيذ الاغتيالات ونشر الخوف.
- الانتداب الدولي بلا شرعية من الأمم المتحدة، بما يمهّد لسوابق مشابهة في أماكن أخرى من العالم.
دروس التاريخ
التاريخ يعلّمنا أن تسليم السلاح لم يجلب يومًا سوى المذابح:
- بغداد 1258م: سلّم الناس سلاحهم لهولاكو، فكانت المذبحة وسقوط الخلافة.
- الأندلس 1492م: انتهى تسليم السلاح بالتهجير والتنصير القسري.
- الجزائر 1830م: أدى الاستسلام إلى استعمار دام أكثر من قرن.
- فلسطين 1948م: القرى التي سلّمت سلاحها تعرضت للمجازر والتهجير.
- البوسنة 1995م: نزع السلاح تحت إشراف أممي انتهى بمذبحة سربرنيتسا.
الدرس واحد: من يتخلى عن سلاحه يسلم رقبته لجلاده.
الانعكاسات على الشعوب العربية
الخطة لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تضرب عمق المجتمعات العربية.
إدخال قوات عربية في غزة يعني تحويل الصراع إلى مواجهة فلسطينية–عربية، وهو أخطر ما يمكن أن يحدث:
- فتنة داخلية بين الشعوب والأنظمة.
- انقسام الجيوش عن قضايا الأمة.
- استنزاف القدرات العربية في معارك عبثية ضد الشعوب بدل مواجهة الاحتلال.
الأبعاد الاقتصادية
إلى جانب الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، تفتح الخطة شهية الشركات العالمية على “إعادة الإعمار”.
لكن إعادة الإعمار هنا ليست من أجل الفلسطينيين، بل من أجل تحويل القطاع إلى مشروع اقتصادي مربح.
وبذلك يُستبدل الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي، تتحكم فيه الشركات والعقود بدلًا من الدبابات.
المشهد الدولي
الخطة في جوهرها مشروع أمريكي–بريطاني–إسرائيلي، بينما أوروبا تتأرجح بين الدعم والتردد.
لكن أي اهتزاز كبير في الشرق الأوسط لا يمر من دون أن تترقبه القوى المنافسة.
- روسيا ليست شريكة في الخطة، لكنها تتابع بدقة، وقد تسعى لاستغلال أي فراغ جديد لتعزيز حضورها العسكري أو تمرير صفقات سلاح.
- الصين لا تصطف في خندق واشنطن، لكنها تنظر إلى إعادة الإعمار وما يرافقها من مشاريع كبرى كبوابة لمد نفوذها الاقتصادي عبر “الحزام والطريق”.
إذن، بينما يريد الغرب جني الثمار المباشرة، تدرك موسكو وبكين أن كل خطة أمريكية تحمل ثغرات يمكن استغلالها لاحقًا.
المسار الاستراتيجي الطويل
منذ سايكس–بيكو وحتى مشاريع “الشرق الأوسط الجديد”، كان الهدف دائمًا إعادة تقسيم المنطقة وتفكيكها.
خطة ترامب ليست سوى حلقة جديدة في هذا المسار، حيث تُستخدم غزة كمدخل لإعادة رسم الخريطة، وتفكيك التحالفات، وإعادة تشكيل الهوية السياسية للأمة.
خدعة السلام وتمهيد الحرب
الخطة صُممت لتكون “فخًا”:
- إن قُبلت، فهي وصاية وانتداب ونزع سلاح.
- وإن رُفضت، فهي ذريعة لحرب جديدة أشد فتكًا.
السلام هنا ليس سوى خدعة سياسية لتبرير المرحلة القادمة من الصراع، والنتيجة واحدة: المنطقة على أعتاب إعادة تقسيم شاملة.
هل يكتفي العرب والمسلمون بدور المتفرج؟
الخطر الأكبر ليس في “خطة ترامب” بحد ذاتها، بل في أن تتحول الأمة إلى مجرد متفرج على ما يُرسم لها.
التفرج يعني الاستسلام لمعادلة يضعها الآخرون، بينما الفعل يعني أن العرب والمسلمين يستعيدون زمام المبادرة.
إن التاريخ والواقع يفرضان واجبًا واضحًا: لا مكان للحياد، ولا ترف للانتظار.
الأخطر: عندما يشرعن بعض الدول الإسلامية هذه الخطوة
الأخطر من مجرد التفرّج أن تتحول بعض الدول الإسلامية — لأسباب داخلية أو ضغط خارجي أو مطامع اقتصادية — إلى شركاءٍ يضفون شرعيةً على مشروعٍ يسلب شعوبًا حقَّها ويمنح احتلالًا غطاءً سياسيًا.
هذه الخيانة المزدوجة لا تقوّض وحدَةَ الأمة فحسب، بل تُحوّل الصراع مِن مقاومةٍ وطنيةٍ إلى «مشروع إدارة مناطق» بمباركة عربية رسمية.
نتائج ذلك كارثية: تُقسَّم المواقف الوطنية، وتنهار المواقف الشعبية أمام حكوماتٍ تقرر نيابةً عن شعوبها، وتُستخدم الموارد الاقتصادية والسياسية لتمرير عملية احتلال مُنظَّمة.
لمواجهة هذا السيناريو لا يكفي النداء الشعبي وحدَه.
المطلوب إجراءات عملية: قطعُ أي تطبيعٍ سياسيٍّ أو أمنيٍّ مع مشاريع الوصاية؛ فتحُ قنوات تحركٍ شعبيةٍ ودبلوماسيةٍ مضادة؛ توحيد الموقف الرسمي الشعبي في مؤسسات إقليمية (جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي) لرفض الانتداب والانتقال إلى آليات ضغط حقيقية؛ وتقديمُ بدائلٍ للتعاون الاقتصادي تُبقي خيار الشعب الفلسطيني واستقلاليته في مقدمة الأولويات.
خاتمة
أيها السادة… لسنا أمام مبادرة سياسية، بل أمام مشروع استراتيجي يهدد وجود الأمة. “الخطة الكبرى” ليست بابًا للسلام، بل جسرًا نحو حرب كبرى تعيد رسم الشرق الأوسط.
من يتخلى عن سلاحه يفرّط في حاضره ومستقبله، ومن يقبل الوصاية يفتح الباب لاستعمار جديد.
التاريخ يخبرنا أن الشعوب لا تموت مهما اشتد الحصار، وأن المقاومة، رغم كلفتها، هي السبيل الوحيد لحماية الكرامة.
قد تُقرع طبول الحرب، لكن من رحم الحرب يولد فجر جديد. والسؤال: هل نحن مستعدون للثمن؟