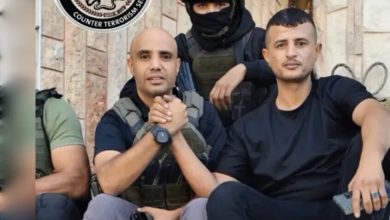إبراهيم عبد الكريم يكشف في دراسة جديدة: إسرائيل تسعى للسيطرة على الجنوب السوري بعد الجولان

مقدمة
تواصلت التوغلات والهجمات الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، الواقعة شرق منطقة الجولان المحتلة. ويتبين من ذلك أن إسرائيل لجأت إلى تحديث حساباتها الجارية بشأن هذه المناطق، منذ استلام الإدارة الجديدة في سوريا مقاليد السلطة إثر سقوط نظام بشار الأسد في 8/12/2024.
وأضافت إسرائيل هذا التحديث إلى توجهاتها الاستراتيجية إزاء سوريا، بطريقة أفضت إلى صياغة سياسة تدخلية واضحة، تتضمن المزج بين التطلعات المرسومة والممارسات العملية، لتكريس واقع جديد يتلخص في تحويل الجنوب السوري إلى رقعة نفوذ وهيمنة حالياً، مع مستقبل مفتوح على الاحتمالات.
وتتجلى المحصلة الناتجة عن تضافر مستجدات العمل الإسرائيلي في مناطق الجنوب السوري مع الصيغ التقليدية التي كانت تعتمدها إسرائيل حيال هذه المناطق، عبر أشكال واضحة من التمادي الذي يُراد له أن يدفع العهد الجديد في سوريا إلى الاستجابة لإملاءات الاحتلال، التي اتسع الحديث عنها رسمياً وفي الأوساط الإعلامية والبحثية الإسرائيلية.
ملامح المشروع الإسرائيلي
تعنى هذه الدراسة التوثيقية التحليلية برسم المشهد الذي تسعى إسرائيل إلى تكوينه واستكماله في الجنوب السوري، في منحى توطيد تحكمها به، واستغلال هذا التحكم لخدمة مصالحها الذاتية، راهناً ومستقبلاً.
وتفترض الدراسة أن سعي إسرائيل في هذا الاتجاه يمثل مرحلة ثانية بعد احتلال منطقة الجولان عام 1967، في إطار مشروع توسعي متعدد المراحل يمتد إلى مناطق سورية أخرى.
ولفحص مدى مصداقية هذا الافتراض، يجري الربط بين الطروحات الأيديولوجية الصهيونية والاعتبارات البراغماتية على مستوى الممارسات الأمنية، بحيث تتكشف صورة المشروع القائم على:
- البيئة الاستراتيجية للتمادي الإسرائيلي.
- المرويات التناخية كخلفية للسيطرة.
- الأطماع الصهيونية التاريخية.
- ملكيات الأراضي ومحاولات الاستيطان اليهودية في حوران.
- المطالبات المتكررة بالملكيات اليهودية.
- احتلال الجولان كخطوة على المسار التوسعي.
البيئة الاستراتيجية للتمادي الإسرائيلي في الجنوب السوري
يُعدّ السعي الإسرائيلي للسيطرة على مناطق الجنوب السوري حالة نموذجية لاستغلال الظروف والأحداث التي شهدت متغيرات طرأت في سوريا والإقليم.
في صدارة المحفزات التي تدفع إسرائيل إلى التوسع بعد سقوط نظام الأسد:
- ما تمتلكه من قدرات تولّد لديها إحساساً بإمكانية مواصلة بسط هيمنتها على محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، ولا سيّما الجنوب السوري الغربي والجنوبي.
- إدراكها أنها في وضعية تمكنها من إيجاد نظام جديد في المنطقة، خالٍ من إرهاصات الهجوم الاستراتيجي السوري.
- تحجيم ومحاصرة حزب الله.
- كسر التحدي الإيراني الذي كان يتجلى في المواقع النووية والعسكرية الإيرانية بمساعدة أمريكية.
ولا شك أن انسحاب إيران مرغمة من سوريا، ساهم في تصفير المخاطر، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ عمليات “هندسة الجوار”، لتثبيت وضع الأردن ومصر والتعاون معهما في منع تأثيرات الحدث السوري من اختراق حدودهما.
المرويات التناخية كخلفية للسيطرة
تشكل نصوص عديدة من “التناخ” (العهد القديم) جزءاً من البنية الأيديولوجية الصهيونية، حيث جرى إسقاط هذه المرويات على الجغرافيا السورية الجنوبية بطريقة مصطنعة، في محاولة لشرعنة السيطرة الإسرائيلية.
وتشير الدراسة إلى أن الأدبيات البحثية والإعلامية الإسرائيلية عملت على تسويق هذه المطابقات المصطنعة، عبر نسب فترات تاريخية إلى مناطق مثل الجولان وحوران، وطمس الهوية العربية السورية الأصلية لهما.
محاولات طمس الهوية
تجلت هذه الجهود في:
- تنقيبات أثرية متحيزة، تغيب عنها المؤسسات الدولية الشرعية.
- تحريف أو انتحال العديد من الآثار الآرامية والكنعانية والبيزنطية والإسلامية والمسيحية وتقديمها كآثار يهودية.
- نشر خرائط تزعم وقوع منطقتي الجولان وحوران ضمن “سبط منسى” التاريخي.
عملية “سهم الباشان”
أطلقت إسرائيل تسمية “عملية سهم الباشان” على خططها العسكرية لتدمير القدرات السورية والتوغل شرق الجولان، وهي تسمية ذات دلالة رمزية تستند إلى المرويات التوراتية عن “باشان”، التي تصفها المصادر العبرية كمجال تاريخي لليهود.
رمزية باشان وسبط منسى
- بحسب هذه المرويات، يربط الخطاب الإسرائيلي بين “باشان” والجولان وحوران.
- تُعرض خرائط تظهر الجولان المحتل كجزء من أراضي سبط منسى ضمن الأسباط الاثني عشر.
- تستند الدراسات العبرية إلى إشارات توراتية لتصوير المنطقة كـ “أرض خصبة” قامت فيها مستوطنات يهودية قديمة.
الخلاصة
توظف إسرائيل هذه المرويات كأداة أيديولوجية لإضفاء شرعية على أطماعها التوسعية، رغم افتقارها لأي سند تاريخي أو قانوني. وتؤكد الدراسة أن الهدف النهائي هو طمس الهوية العربية السورية للجنوب وإعادة إنتاجه كجزء من “أرض إسرائيل الكبرى”.
الأطماع الصهيونية التاريخية في الجنوب السوري
بدايات المشروع التوسعي
منذ بدايات القرن العشرين لم تُخفِ الحركة الصهيونية أطماعها في أراضٍ تقع شمال وشرق فلسطين، بما يشمل كامل الجولان وأجزاء من حوران. ففي بيانات مبكرة لقيادات صهيونية مثل حاييم وايزمان، طُرحت فكرة “الدولة القادمة على الطريق” التي تتجاوز حدود فلسطين التاريخية.
مؤتمر فرساي 1919
في فبراير/شباط 1919، تقدمت المنظمة الصهيونية بمذكرة إلى مؤتمر فرساي تطالب فيها بتوسيع حدود “الوطن القومي اليهودي” ليشمل أراضٍ واسعة تمتد من صيدا في لبنان شمالاً، حتى خليج العقبة جنوبًا، متضمناً الجولان وقسماً كبيراً من حوران.
تصريحات قادة الحركة الصهيونية
في اجتماع اللجنة التنفيذية الصهيونية بلندن (26/6/1926)، قال وايزمان:
“سيأتي يوم يستوطن فيه ملايين اليهود أرض إسرائيل، وستكون هذه الأرض صغيرة بالنظر إلى متطلبات التاريخ. وإن الدولة اليهودية، مهما كان طابعها، سوف تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات”.
الاستيطان كأداة توسع
اعتمدت الحركة الصهيونية على أدوات استيطانية لترسيخ هذه الأطماع، منها:
- إنشاء جمعية الاستعمار اليهودي JCA عام 1891، التي سُجلت في لندن بهدف شراء الأراضي وتوطين اليهود من أوروبا الشرقية.
- تأسيس جمعية بيكا PICA على يد البارون إدموند دي روتشيلد لإدارة مشاريع الاستيطان الزراعي في فلسطين وجنوب سوريا.
- نشاطات “المنظمة الصهيونية العالمية” منذ مؤتمر بال 1897، التي وضعت الجنوب السوري ضمن خريطة أطماعها.
توثيق الاستيطان اليهودي
وثقت الدراسة نشاطات استيطانية في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث نُظمت رحلات صهيونية إلى الجولان وحوران بإشراف مؤرخين وباحثين يهود لتوثيق الروابط المزعومة مع التاريخ اليهودي، وتثبيت فكرة “إسرائيل الكبرى”.
الخلاصة
تؤكد الدراسة أن هذه الأطماع ليست طارئة، بل متجذرة في الفكر الصهيوني منذ أكثر من قرن. ومع سقوط نظام الأسد، تجد إسرائيل في الجنوب السوري فرصة تاريخية لإحياء هذه المطالب التوسعية وربطها بخطاب “الحق التاريخي”.
ملكيّات الأراضي ومحاولات الاستيطان اليهودية في حوران
1) الموجة الأولى (أواخر القرن 19 – مطلع القرن 20)
- شراء الأراضي: ابتداءً من 1891–1895 تحرّكت أذرع صهيونية (JCA ثم PICA) عبر وسطاء مثل المهندس يوسف زايدنِر لشراء مساحات واسعة شرقي الجولان وغرب درعا (نحو 80–150 ألف دونم وفق المصادر الصهيونية)، قُسِّمت لتأسيس مستوطنات تجريبية.
- النقاط المستهدفة: محيط مَزِيريب، سَحْم الجولان، جِلِّين، بُسْطاس، قَرْقَس، مع محاولات في خان الشيح وبيت تيما شمالاً.
- الاستقدام السكاني: وُجّهت عائلات مهاجرة من رومانيا وبلغاريا وروسيا وغيرها للإقامة الزراعية، بدعم أمني ولوجستي من منظمات مثل الهَشّومير (الحارس) ودوائر “العمل العبري”.
2) عوائق الإرساء والفشل المرحلي
- رفض محلي وأمني: واجهت المستعمرات الوليدة هجمات/مقاومة أهلية وبيئة عدائية من السلطات العثمانية، إضافةً إلى عزلة تامة عن كتلة الاستيطان في فلسطين.
- تدهور الاستيطان: بين 1898 و1901 بدأ التخلّي التدريجي عن النقاط الزراعية؛ غادرت معظم العائلات، لكن الملكية القانونية بقيت باسم روتشيلد/“بيكا”، تُدار عبر عقود إيجار مع مزارعين محليين استمروا بدفع الضرائب.
3) إحياء المحاولات بعد الحرب العالمية الأولى
- تجديد الطموح: بعد 1918، عادت المؤسسة الصهيونية لتقييم “جدوى” حوران والجولان. أُرسلت وفود من “كتبية العمل” وأنصار يوسف ترومبلدور لدراسة إعادة الاستيطان وتأمين الحماية.
- نشاطات شراء/مسح: خلال 1934–1944 دارت مساعي توسيع الملكيات وتجميع “كواشين” وأوراق ملكية، ونشر خرائط تُظهر ثلاث كتل لملكية روتشيلد شرق الجولان (شمالية/وسطى/جنوبية) مع نقاط استيطان مُتخيَّلة حول نوى–درعا–حوران.
4) الإطار القانوني والسياسي حتى الاستقلال السوري
- نزاعات الملكية: ظلت شركات روتشيلد وPICA تُلوِّح بحجج الملكية أمام المحاكم، وتستخدم “الكواشين” كأداة ضغط سياسية/إعلامية.
- التأميم السوري (1946): مع الاستقلال، أمّمت الدولة السورية أملاك اليهود في حوران باعتبارها أملاك دولة/وقف عام، فتراجعت القدرة القانونية على إحياء تلك الملكيات.
- الوضع عشية 1947: تُشير السجلات الصهيونية إلى وجود نحو 14 موقعاً استيطانياً مُسجلاً تاريخياً في نطاق حوران (كأسماء/مطالبات)، مع غياب وجود سكاني يهودي فعلي على الأرض.
5) الخلاصة التحليلية
- محاولات الاستيطان بحوران كانت أداة تمهيدية لمشروع توسعي يتجاوز حدود فلسطين، هدفها خلق سند ملكي/تاريخي يُستثمر لاحقاً.
- فشلها الميداني لم يُنهِ الورقة القانونية/الإعلامية؛ إذ بقيت تُستَحضَر دوريّاً لتبرير مطالب لاحقة وربط الجنوب السوري بخريطة “إسرائيل الكبرى”.
المطالبات المتكررة بالملكيّات اليهودية في الجنوب السوري
استدعاء مستمر للملف
منذ فشل محاولات الاستيطان المباشر في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لم تتوقف المؤسسات الصهيونية عن استدعاء ملف الملكيات اليهودية في حوران والجولان. فقد جرى استخدامه كورقة سياسية وإعلامية لإبراز ما سُمّي بـ”الحقوق التاريخية لليهود” في الجنوب السوري.
استخدام “الكواشين” كأداة ضغط
احتفظت جمعيات مثل بيكا PICA بوثائق الملكيات (الكواشين) وواصلت تسجيلها في أرشيفات خاصة.
هذه الوثائق استُخدمت مرارًا كورقة ضغط في المحافل الدولية والإسرائيلية، حيث يُقدَّم ملف حوران على أنه جزء من “الإرث الوطني اليهودي”.
كما ظهرت هذه المطالبات في الأبحاث الأكاديمية والخرائط التي نشرتها مراكز دراسات إسرائيلية خلال العقود الماضية.
في الخطاب السياسي والإعلامي
أعادت إسرائيل في مناسبات متعددة طرح مسألة “الملكيّات اليهودية” عند أي نقاش يتعلق بالحدود مع سوريا، أو في سياق الترتيبات الأمنية والسياسية بالمنطقة.
على سبيل المثال، تُبرز مراكز بحث إسرائيلية بين الحين والآخر أن “الجنوب السوري يحتوي على أراضٍ كان يمتلكها اليهود قبل أكثر من قرن”.
في الإعلام العبري، يُسوَّق هذا الملف باعتباره “ذخيرة تفاوضية” لإبقاء باب التوسع مفتوحًا نحو الشرق.
الأبعاد الاستراتيجية للمطالبة
تثبيت شرعية زائفة: تمنح هذه الادعاءات إسرائيل ذريعة للتمسك بمطالب جغرافية خارج فلسطين التاريخية.
التأثير على مستقبل المفاوضات: يوضع ملف الملكيات على الطاولة كورقة مساومة سياسية، لا سيما في أي تسوية مستقبلية تخص الجولان أو الجنوب السوري.
التكامل مع الرواية الدينية: تُستخدم الملكيات كدليل “واقعي” داعم للمرويات التوراتية حول باشان وسبط منسى، بما يُكمل سردية السيطرة الأيديولوجية والسياسية.
الخلاصة
تحوّل ملف “الملكيّات اليهودية” من مجرد محاولات استيطانية فاشلة إلى ورقة سياسية حية توظفها إسرائيل بين حين وآخر. فهو يشكل عنصرًا مكمّلًا لمشروعها التوسعي في الجنوب السوري، ويُستثمر إعلاميًا وبحثيًا لإضفاء الشرعية على أطماعها الإقليمية.
احتلال الجولان كخطوة على المسار التوسعي
1967: البداية الحاسمة
جاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان خلال حرب يونيو/حزيران 1967 ليكون الفصل الأبرز في المشروع التوسعي. فقد سيطرت على مساحة تُقدَّر بـ 1200 كم²، تضم نحو 200 قرية ومزرعة سورية، وتم تهجير أكثر من 130 ألف مواطن سوري، بينهم غالبية من أبناء مدينة القنيطرة.
الترسيم الاستيطاني
مباشرة بعد الاحتلال، شرعت إسرائيل في إقامة مستوطنات زراعية وعسكرية داخل الجولان.
بحلول الثمانينيات، كان هناك أكثر من 30 مستوطنة، تتركز في الشمال والوسط، مع محاولات لربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية.
عام 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي “قانون ضم الجولان”، الذي رفضه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 497 واعتبره لاغيًا.
الجولان في العقيدة الأمنية الإسرائيلية
الجولان يشكّل حزامًا استراتيجيًا يحمي شمال فلسطين المحتلة ويشرف على دمشق.
منذ 1967 وحتى اليوم، تمثل المنطقة قاعدة متقدمة للعمليات العسكرية والاستخباراتية.
الدراسة تؤكد أن السيطرة على الجولان لم تكن مجرد خطوة دفاعية، بل مرحلة انتقالية في مشروع أوسع يستهدف الجنوب السوري بكامله.
ربط الجولان بالجنوب السوري
بعد عقود من الاحتلال، بدأت إسرائيل تنظر إلى الجولان كمنصة للتمدد شرقًا وجنوبًا.
الاستيطان والضمّ القانوني والإدارة المدنية لم يكن هدفًا نهائيًا، بل مقدمة لإعادة إنتاج سيناريو مشابه في درعا والسويداء.
الخطة التوسعية تتكامل مع خطاب “المنطقة الأمنية” الذي يمدّ حدود السيطرة الإسرائيلية عشرات الكيلومترات داخل سوريا.
الخلاصة
احتلال الجولان لم يكن نهاية المطاف، بل محطة تأسيسية لمشروع توسعي متدرج.
تعتبره إسرائيل الخطوة الأولى على طريق تحويل الجنوب السوري إلى منطقة نفوذ مباشر، تربط بين الأبعاد العسكرية والأمنية من جهة، والمرويات الدينية والتاريخية من جهة أخرى.
التوغلات العسكرية والممارسات الإسرائيلية الجارية في الجنوب السوري
اجتياح المنطقة العازلة
تشير الدراسة إلى أن إسرائيل كثّفت منذ سقوط نظام الأسد عملياتها العسكرية في المنطقة العازلة شرق الجولان، حيث نفّذت اجتياحات متكررة ونصبت نقاط مراقبة وقواعد ميدانية جديدة.
الهدف المعلن هو منع تمركز أي قوى معادية، لكن جوهر الخطوة يتمثل في تكريس حضور أمني دائم يتجاوز الخطوط الحمراء لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974.
إنشاء قواعد ومواقع عسكرية
- أقامت إسرائيل مواقع عسكرية متقدمة على امتداد المنطقة من جبل الشيخ حتى ريف درعا.
- تم ربط هذه المواقع بأنظمة مراقبة إلكترونية ورادارات متطورة، لتأمين سيطرة كاملة على المجال الجغرافي.
- كما جرى استخدام الطائرات المسيّرة بشكل يومي لمتابعة التحركات داخل العمق السوري.
الممارسات الجارية
- عمليات اعتقال وتفتيش تستهدف سكان القرى القريبة من خط الفصل.
- تجريف للأراضي والبنية التحتية بهدف خلق مناطق عازلة طبيعية.
- قصف جوي متكرر لمواقع داخل الجنوب السوري، بزعم استهداف مجموعات مرتبطة بإيران أو حزب الله.
تمسك بالمناطق الأمنية
تتمسك إسرائيل بفرض ما تسميه “المناطق الأمنية”، والتي تمتد لعشرات الكيلومترات داخل الأراضي السورية.
وترى الدراسة أن هذه المناطق تشكّل خطوطًا حمراء إسرائيلية تمنع أي طرف آخر من التواجد أو التسلح فيها، بما يضمن بقاء الجنوب السوري في دائرة النفوذ الإسرائيلي المباشر.
الارتباط بالاستراتيجية الجديدة تجاه سوريا
ترتبط هذه الممارسات الميدانية بالاستراتيجية الإسرائيلية الأشمل بعد سقوط الأسد، والتي تقوم على:
- إبعاد إيران وحزب الله عن الحدود.
- إعادة هندسة الجغرافيا الأمنية للجنوب السوري.
- تهيئة الأرضية لمرحلة تفاوضية يكون فيها لإسرائيل اليد العليا.
الخلاصة
ترى الدراسة أن التوغلات الإسرائيلية لم تعد عمليات محدودة أو استثنائية، بل أصبحت جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الجنوب السوري أمنيًا وعسكريًا، بما يكرّس واقعًا جديدًا على الأرض يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
الملف الدرزي ودوره في التشكيل الأمني الإسرائيلي
توظيف الطائفة الدرزية
تسلّط الدراسة الضوء على كيفية تعامل إسرائيل مع الطائفة الدرزية في الجنوب السوري، معتبرةً أن هذا الملف أصبح جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية.
فقد حاولت تل أبيب توظيف الحضور الدرزي ليكون حاجزًا اجتماعيًا وجغرافيًا في مواجهة القوى المعادية لها بالمنطقة.
أدوات التأثير الإسرائيلي
- المساعدات الإنسانية: تقديم مواد غذائية ودوائية إلى القرى الدرزية القريبة من خط الفصل.
- الدعم الإعلامي والسياسي: تصوير الدروز كأقلية “مهددة”، بما يستدعي تدخلًا إسرائيليًا لحمايتهم.
- التواصل مع القيادات المحلية: بناء قنوات اتصال مباشرة مع وجهاء وزعامات محلية لتعزيز النفوذ الإسرائيلي.
الأهداف الاستراتيجية
- خلق حزام سكاني متعاون مع إسرائيل يساهم في تقليص نفوذ خصومها (إيران – حزب الله – فصائل المقاومة).
- استثمار العلاقات مع الدروز لتمرير مشاريع “المناطق الأمنية” في الجنوب.
- تقديم نموذج “مجتمع محلي محمي” يبرر التواجد الإسرائيلي في الخطاب الدولي.
التحديات أمام هذا التوظيف
رغم هذه الجهود، تشير الدراسة إلى وجود انقسام داخلي في الموقف الدرزي تجاه إسرائيل، حيث يرفض جزء كبير من المجتمع المحلي أي تعاون مباشر معها، ويتمسك بالهوية الوطنية السورية.
كما يثير هذا التوظيف مخاوف من إشعال فتنة طائفية تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب وحدة النسيج الاجتماعي السوري.
الخلاصة
الملف الدرزي بالنسبة لإسرائيل ليس مجرد قضية إنسانية، بل أداة استراتيجية تسعى عبرها لخلق بيئة اجتماعية تساند نفوذها العسكري والأمني في الجنوب السوري. وهو ما يشكل جزءًا من سياسة أوسع لإعادة هندسة المشهد المحلي بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية.
الاتفاقات الأمنية غير المعلنة والتفاهمات الدولية حول الجنوب السوري
ملامح التفاهمات
تشير الدراسة إلى وجود قنوات خلفية دولية تتناول مستقبل الجنوب السوري، بعضها عبر وساطات أوروبية في باريس، وتتضمن نقاشات حول ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل والسلطات السورية بعد سقوط نظام الأسد.
هذه التفاهمات غير معلنة رسميًا، لكنها تستند إلى تسريبات وتصريحات من مسؤولين إقليميين ودوليين.
أبرز البنود المسرّبة
- تشكيل مجالس محلية في قرى وبلدات الجنوب، تعمل تحت إشراف مباشر من قوى دولية.
- نزع السلاح الثقيل من الفصائل المحلية، مع فرض قيود على حيازة الأسلحة الخفيفة.
- استمرار وجود عسكري إسرائيلي في قمة جبل الشيخ ومناطق محددة، تحت ذريعة “منع التهديدات”.
- ضمانات أمريكية وفرنسية لإسرائيل تتعلق بأمن الحدود الشمالية.
الدور الأمريكي والأوروبي
- الولايات المتحدة تعتبر الجنوب السوري جزءًا من “معادلة أمن إسرائيل”، وتدعم بقاء قواتها فيه إلى أجل غير محدد.
- فرنسا، بحسب الدراسة، لعبت دور الوسيط في إعداد مسودة اتفاق أمني يتضمن إشرافًا دوليًا واسعًا، مقابل تسهيلات اقتصادية للنظام الجديد في دمشق.
المخاطر على السيادة السورية
تلفت الدراسة إلى أن هذه الترتيبات تؤدي عمليًا إلى تقويض السيادة السورية في الجنوب، عبر تحويله إلى منطقة وصاية دولية – إسرائيلية – أمريكية، شبيهة بما حدث في مناطق أخرى خضعت لإدارة انتقالية متعددة الجنسيات.
الخلاصة
توضح الدراسة أن الحديث عن اتفاقات أمنية غير معلنة يمثل جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية في الجنوب السوري بموافقة دولية.
وتحذر من أن هذه التفاهمات ستُحوّل المنطقة إلى إقليم منزوع السيادة، مرتهن لإسرائيل وحلفائها، ما يجعل أي استعادة للقرار السوري أمرًا شديد الصعوبة.
الخاتمة والنتائج
ملامح المشروع الإسرائيلي
خلصت الدراسة إلى أن إسرائيل تنفذ مشروعًا توسعيًا ممنهجًا في الجنوب السوري، يقوم على مزيج من:
- المرويات الدينية والتاريخية (باشان – سبط منسى – أطماع صهيونية قديمة).
- الأدوات القانونية والسياسية (الملكيّات اليهودية القديمة كأوراق ضغط).
- التحركات العسكرية والأمنية (التوغلات – القواعد – المناطق الأمنية – عمليات القصف والاعتقال).
- التأثير الاجتماعي (توظيف الملف الدرزي وتحويله إلى حاجز بشري يخدم إسرائيل).
- التفاهمات الدولية (اتفاقات أمنية غير معلنة تشرعن وجودها وتمنحها غطاءً دوليًا).
المخاطر الاستراتيجية
- فقدان الجنوب السوري لسيادته الفعلية وتحوله إلى منطقة وصاية أمنية إسرائيلية – دولية.
- تكريس واقع تقسيمي يُضعف وحدة سوريا ويمنح إسرائيل مجال نفوذ يتجاوز حدود الجولان.
- تحويل التهديدات المحتملة إلى ذرائع لمزيد من التوسع وفرض الشروط.
- إعادة رسم خريطة التحالفات الإقليمية على نحو يجعل أمن إسرائيل أولوية دولية.
التوصيات التي تطرحها الدراسة
- ضرورة مواجهة الطروحات التوراتية التي تُستخدم لتزييف التاريخ وإضفاء شرعية زائفة.
- العمل على كشف ملف الملكيات اليهودية واعتبارها جزءًا من محاولات استيطانية فاشلة لا تُنتج حقوقًا.
- تعزيز الحضور السوري والعربي والدولي في الجنوب لمنع تكريس النفوذ الإسرائيلي.
- توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة مشروع “المنطقة الأمنية” الذي يتوسع على حساب السيادة الوطنية.
الخلاصة العامة
تعتبر الدراسة أن السيطرة الإسرائيلية على الجنوب السوري ليست خطوة تكتيكية مؤقتة، بل فصل تمهيدي في مشروع توسعي أوسع، يستهدف إعادة صياغة الحدود والوقائع الجغرافية والديموغرافية في المنطقة.
إنها محاولة لإعادة إنتاج سيناريو الجولان، ولكن على نطاق أوسع، مستندةً إلى خليط من المرويات الدينية، الادعاءات التاريخية، التدخلات العسكرية، والتفاهمات الدولية.