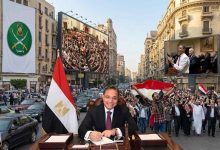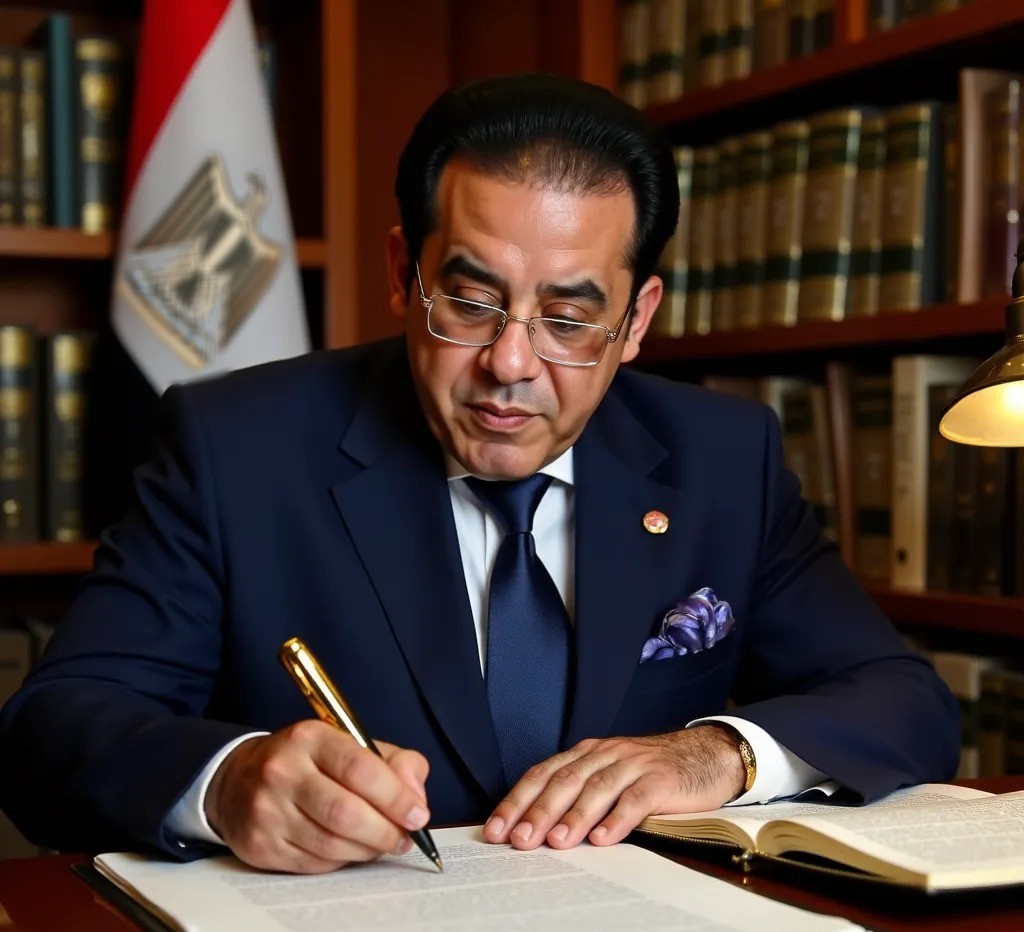
في حياة كل إنسان معلم يبقى اسمه محفورًا في الذاكرة لا لمجرد أنه درّسه، بل لأنه ربّاه، وصاغ ملامح جوهره، في اللحظة التي لم يكن فيها قد اكتمل بعد.
كان رشدي عبد الباري، مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية في المنصورة، من أولئك الرجال الذين يتركون فيك أثرًا يشبه الوصية، لا يُمحى ولا يُعاد إنتاجه.
لم تكن المدرسة مجرد مبنى إداري ينتمي للدولة، بل كانت جسرًا بين الطفولة والرجولة، بين الحياء الأول والصوت الأول، وبين الحلم المجرد والموقف العملي.
في ذلك الفضاء، بدأ أول تحدٍّ حقيقي.
كنتُ، وأنا في بدايات المرحلة الثانوية، رئيسًا لاتحاد المدرسة، ثم اتحاد الإدارة، ثم المحافظة، وصولًا إلى رئاسة اتحاد طلاب الجمهورية. كانت الطموحات تكبر كلما حملت حقيبتي، ولم أكن أبحث عن المناصب، بل عن المدى… عن الفكرة التي تسكنني.
أحد تلك التحديات التي صاغت ملامح شخصيتي، كانت رغبتنا في بناء مسجد داخل المدرسة، حيث لم يكن في المنطقة المحيطة – بين توريل وجديلة – أي مسجد قريب يمكن للتلاميذ أن يقيموا فيه الصلاة.
وقف إلى جانبي في الاتحاد زملاء مخلصون: نبيل، علاء، مجدي… وآخرون. وعلى الجانب الآخر، وقف مدير المدرسة، الأستاذ رشدي عبد الباري، اليساري الفكر، الليبرالي الهوى، لا بالانتماء الحزبي، بل بالسليقة الإنسانية، والسعة الأخلاقية.
اعترض وقتها على الفكرة، لا عداءً للدين، بل باعتبار أن المدرسة ليست مكانًا للأنشطة الطائفية – كما عبّر – بل للتعليم.
لم يكن رفضه حادًا، لكنه كان حازمًا. وكان أمامي خياران: أن أشتبك… أو أن أُقنع. فاخترت الإقناع. استعنت بصفتي رئيسًا لاتحاد طلاب الجمهورية، وخاطبت وزير التعليم وقتها د. مصطفى كمال حلمي، فجاءني الرد بالموافقة بشرط أن يتم البناء بالجهود الذاتية.
بدأت رحلة لا تُشبه أعمارنا.
جمعنا التبرعات في صناديق خشبية من صنع أيدينا، ووقفنا بها أمام المساجد، وطرقنا أبواب أهل الخير، وكان من بينهم رجل كريم هو المهندس محمود عبد العزيز، عضو مجلس الآباء، الذي تكفّل بالبناء حين ضاقت مواردنا.
كان المسجد أول نصر نُشيّده بالإرادة، لا بالإمكانات.
وأذكر أن الأستاذ رشدي عبد الباري لم يُمانع بعد موافقة الوزارة، بل تابع المشروع بصدر رحب، ومهنية لا تُنسى.
وهنا، بدأت أرى فيه ما هو أبعد من “مدير المدرسة”… رأيت فيه رجلًا يُجادلك… لكنه لا يُقصيك، يختلف معك… دون أن ينزع عنك شرعية الحلم.
في ذات المرحلة، كنت أتعرف على ملامح الحياة الأوسع. في جمصة، على الرمال الناعمة، بدأت أولى مشاعر الحب، وشرارات الانجذاب الطفولي، التي لا تشبه القصص في كتب القراءة، بل تشبه الارتباك في عيون الصغار حين يتحدثون عن شيء لا يعرفونه… لكنهم يشعرونه.
مرت سنوات، وتفتّحت قصة جديدة، أكثر نضجًا، مع زميلة في الاتحاد، ابنة أسرة برلمانية.
كنا نكتب الرسائل، كما تُكتب القصائد، ونمارس الحلم بوعي مرتعش.
لكن الحلم انكسر حين كتبتُ بيانًا أدان استقبال الرئيس السادات للشاه الإيراني، بعد ثورة شعبه.
تم اعتقالي لعدة أيام، وكانت تلك اللحظة فاصلة، ليس فقط سياسيًا… بل شخصيًا.
الفتاة انسحبت بهدوء. لم يكن انسحابها خيانة، بل خشية.
كانت أسرتها تمر بظرف سياسي دقيق، ووجودي في حياتها، وأنا قيد الاعتقال، كان كمن يسكب الزيت على نار لم تطفأ بعد.
في الزنزانة، كتبتُ:
“لم يكن القيد هو الألم… بل الفقد، حين يأتيك من أقرب قلب، خشية عليك.” بين المسجد الذي شيّدناه، والحب الذي وُئد في لحظة سياسية، والبيان الذي جلب الاعتقال، تشكّلت بعض ملامحي الأولى.
لكنني أعود دومًا إلى وجه رشدي عبد الباري في المشهد الأول:
الرجل الذي اختلف معي، لكنه لم يمنعني.
المدير الذي خالف قناعاتي، دون أن يخنق صوتي.
المعلّم الذي لم أنتمِ أبدًا لمدرسته الفكرية، لكني أُدين له بتعلّم أسمى دروسها: سعة الصدر، وقبول المختلف، والاحتكام للعقل قبل العاطفة.
في عيد المعلم، لا أُهدي شكري لمن منحني الدرجات، بل لمن منحني الرؤية. ولم يكن رشدي عبد الباري يومًا خصمًا… بل كان أوّل من منحني الحق أن أكون رأيًا… وأن أدفع ثمنه