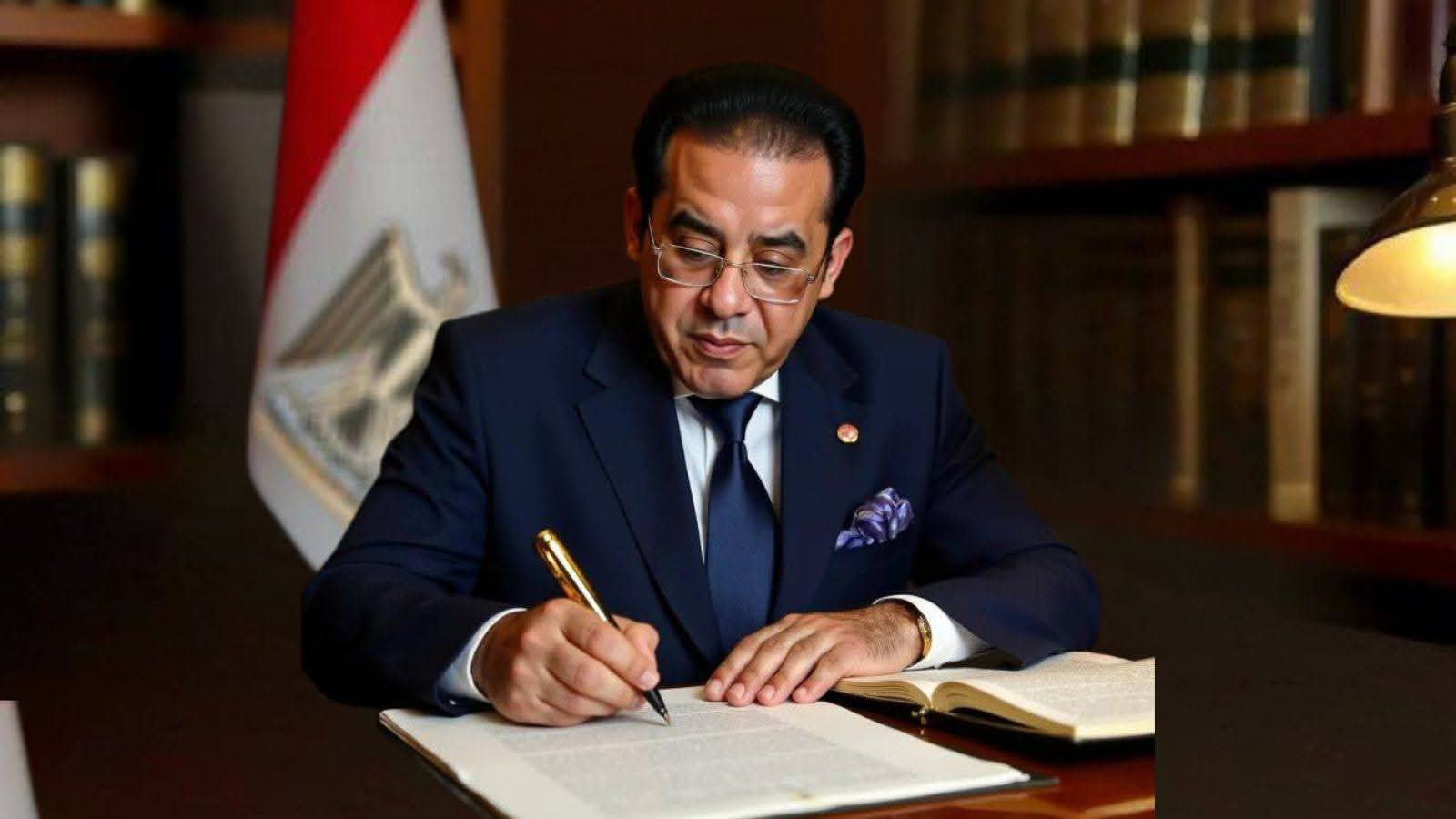
لم أتمالك نفسي من الضحك وأنا أستمع، فجر هذا اليوم، إلى كتابٍ مسموعٍ عن محاورة أفلاطون مع السفسطائي؛ تلك الشخصية التي أراد أفلاطون تفكيكها، لا بوصفها مجرد مذهبٍ فلسفي، بل كداءٍ اجتماعيٍّ مزمنٍ يتسلّل إلى العقول عبر بوّابات البلاغة الكاذبة.
كنت أستمع، وكل بضع دقائق، أوقف التسجيل لأغرق في ضحكٍ يشبه البكاء، مرددًا بيني وبين نفسي: “هذا فلان… وذاك فلان!” حتى استيقظت زوجتي فزعةً من نومها، وقد ظنّت أن حرارة رأسي بلغت درجة الهذيان. وددت أن أقول لها: “أُحَدِّثُ أفلاطون”، لكني خشيت أن أبدو كمن فقد صوابه في زمنٍ فقد صوته.
في هذا الكتاب الموحِي، المغبَّر بتراب الواقع، كنت أقرأ ملامح من يعيشون بيننا:
ذلك المتكلّم البارع الذي يدّعي الحكمة، ولا يطلب الحقيقة، بل يسعى إلى الانتصار في الجدل، ولو بالكذب.
ذلك الإعلاميّ الاستعراضيّ، النرجسيّ الفكريّ، الذي يعرف كيف يتكلّم، لكنه لا يعرف كيف يفهم.
يقتبس الآيات والأحاديث كما يقتبس الممثّل جُمله، بلا فهمٍ ولا وعي.
تذكّرت حينها موقفًا منذ قرابة عقدين، حين اتصل بي اللواء رؤوف المناوي، وكان مسؤولًا عن الإعلام بوزارة الداخلية، ودعاني إلى برنامجٍ رمضانيٍّ “ثقافيٍّ للمثقفين”. قبلت على مضض. جلست أمام إعلاميةٍ شهيرة في القناة الثانية، وبدأ الحوار بأسئلةٍ غريبة، إلى أن قالت لي: “هل تحب أن تطّلع على الأوراق قبل التصوير؟”
أبديت دهشتي، فخطف المخرج الأوراق من يدها، وصاح: “يا مدام، دي أسئلة الأستاذ كمال الشناوي!”
ضحكت… واعتذرت عن استكمال الحلقة.
من يومها أدركت أن السفسطائيين الجدد قد احتلّوا الشاشات.
زملاء إعلاميّون، يلقون الأسئلة كما يُلقى حجرٌ في بحيرةٍ راكدة، ثم ينشغلون عن الاستماع بما سيقول الضيف، لأنهم غارقون في تحضير السؤال التالي.
إنهم لا يبحثون عن المعنى، بل عن المشهد. لا يكتبون ليفكروا، بل ليُصفّق لهم الناس.
أفلاطون سأل في محاورته الخالدة:
كيف نميّز العارف الحقيقي من المتذاكي؟
كيف نفرّق بين الباحث عن النور والمتلاعب بالظل؟
من يتكلّم خدمةً للمعرفة والوطن، ومن يتكلّم خدمةً للذات ولجحيم الشهرة؟
ووصف السفسطائي بأنه صيّادُ جمهورٍ، يستخدم الكلام كفخٍّ مخادعٍ ليصنع واقعًا زائفًا.
وحين أراد التمييز بين الوجود الحقيقي والوجود الوهمي، بدا كأنه يصف واقعنا الإعلامي والسوشياليّ، بكل صوره ووجوهه وأقنعته.
ثم جاءت تلك الجملة التي ظلّ صداها يرنّ في أذني طويلًا:
“الحقيقة لا تنتصر لأنها أقوى، بل لأن الوعي يمنحها قوتها.”
“والزيف لا ينتصر لأنه قوي، بل لأن الناس لا يرونه زيفًا.”
يا لها من كلماتٍ تُفسِّر زماننا، زمن السوشيال ميديا، حيث يُصنع الأبطال من الورق، وتُصاغ الهالات من الدخان.
زمنٌ تُقاس فيه العقول بعدد المتابعين، لا بعدد الأفكار.
أتذكّر حين قال نيتشه: “هم يُمثّلون… لا يُفكّرون.”
كأنه يصف هؤلاء الذين يتغذّون على التصفيق، لا على صفاء المعنى ونبل الهدف.
يمتلكون نيران الصوت، لكنهم بلا روح.
أخطر ما فيهم أنهم يُقنعون العقل بأنه يُفكّر، بينما هو فقط يستهلك الكلام.
إنهم النماذج التي تراها اليوم على الشاشات والمنصّات…
يتقنون فنّ القول، لكنهم يفتقرون إلى جوهره.
يتحدّثون عن الحرية والكرامة، وهم أوّل من يفرّط فيها حين يُعرَض عليهم مقعدٌ أو منبر.
ضحكت طويلًا وأنا أسمع صفحات هذا الكتاب، وشعرت وكأن أفلاطون، من زمنه البعيد، يُمسك هؤلاء من أعناقهم، لا لينهرهم، بل ليعرّيهم أمام أعيننا.
أسلوبه الحواريّ يشبه المحاكمة… محاكمةً فكريةً عادلةً، تميّز بين الصدق والزيف، بين الفكر والتصفيق، بين الحقيقة والديكور.
وحين تُغلق الكتاب، يظلّ داخلك ضوءٌ صغيرٌ يقول لك:
من يقتبس دون فهم… من يتفلسف دون روح… من يتحدّث بلا وعي…
ليس إلا سفسطائيًّا جديدًا في ثوبٍ حديث.









