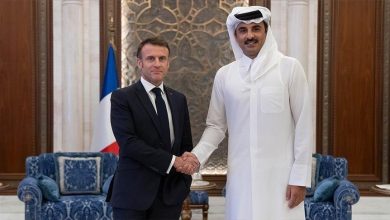إقليم صومالي لاند ينفي الاتفاق مع إسرائيل على بناء قواعد عسكرية

نفى إقليم أرض الصومال اليوم الخميس، الاتهامات بالموافقة على استضافة منشآت عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين نازحين من قطاع غزة مقابل اعتراف إسرائيل باستقلاله.
وأصدرت وزارة خارجية الإقليم بيانا رسميا وصفت فيه هذه الادعاءات بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن تعاملها مع تل أبيب “دبلوماسي بحت” ويتم “في احترام كامل للقانون الدولي”.
وقال وزير خارجية صومالي لاند إنه لم تجرَ أي مفاوضات حول هذه المواضيع.
وجاء النفي ردا على تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي قال في مقابلة إن “صومالي لاند قبلت ثلاثة شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف: توطين فلسطينيين، وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة الماضية اعتراف إسرائيل بـ”صومالي لاند كدولة مستقلة وذات سيادة”.