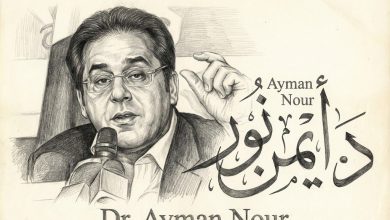في زمنٍ خفتت فيه الأصوات التي تجمع بين المروءة والهيبة، يبقى اسم عبد الفتاح الشافعي حاضرًا كأغنيةٍ صافيةٍ من زمنٍ ليبراليٍّ جميل. هو البرلماني الذي مثّل زفتى، لا كدائرةٍ انتخابية فحسب، بل كرمزٍ لتاريخها الممتد من أحمد الجندي إلى أبناء مدرستها الليبرالية الحديثة.
كان نائبًا عن الناس قبل أن يكون نائبًا عن حزب، وصوتًا للعقل والعدالة في زمنٍ علا فيه الصخب على الحقيقة.
عرفته تحت القبة، وزاملته في برلمانٍ كان ما يزال يعرف للكرامة مقعدًا وللحوار احترامًا.
كان عبد الفتاح الشافعي عمدة البرلمان بحق، شيخًا في وقاره، شابًا في اندفاعه، خفيف الظل في المواقف الثقيلة، قوي القلب في لحظات العصف.
وكنت أراه، حين يتحدث، يمزج بين بلاغة القاضي ودفء الفلاح، بين سخرية الحكيم وصرامة الموقف.
جمع بيننا أكثر من مقعد، وأكثر من معركة، لكن أهمّها كانت في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2005.
في ذلك اليوم الذي شهد مؤتمر المحلة الكبرى، أرادت السلطة أن تُفشل المهرجان الانتخابي الكبير بإسقاط المنصّة التي كنا نخطب فوقها. كانت الحشود تزأر، والأنوار ترتجف، وسقطت المنصة بالفعل، فسقطتُ أنا ومن معي، وكان إلى جواري عبد الفتاح الشافعي.
تساندنا وسط الفوضى، نهضنا من بين الخشب المنكسر والغبار المتصاعد، وتبادلنا نظرةً فيها ابتسامةٌ صغيرة ومعناها: “لن نُسقط كما سقطت المنصّة.”
صعدنا معًا مجددًا، وأكملنا الخطاب بين الهتاف والدخان، حتى تحوّل ما أرادوه فشلاً إلى ملحمة جماهيرية لن تُنسى. لم يكن عبد الفتاح يومها نائبًا عن دائرةٍ أو حزب، بل عن فكرةٍ كاملة اسمها الرجولة حين تكون موقفًا.
كان في كل معركةٍ وطنية رفيقًا وشريكًا في النجاح، لا يسعى إلى صدارةٍ ولا يهرب من مسؤولية.
عرفته كما يعرف البحرُ الموجةَ التي لا تهدأ، وكما يعرف الليلُ نجمه الذي لا يغيب. وفي الحزب، كما في البرلمان، كان هو رجل التوازن حين تتشابك المواقف، وشيخ الحكماء حين تحتدم الخلافات،
يختصر الحِكمة في جملةٍ واحدة، ويربط الجرح بالضحكة، ليعود الصفّ موحّدًا بعد انقسام.
لم يكن عبد الفتاح الشافعي سياسيًّا فقط، بل كان مدرسةً في الأخلاق العامة. كان يؤمن أن الليبرالية ليست نظرياتٍ مستوردة، بل امتدادٌ طبيعيٌّ لنُبل المصري حين يرفض الظلم ويصون الكرامة.
حين يتحدث عن العدالة، تشعر أنك أمام قاضٍ في محراب، وحين يروي قصةً من زفتي، تظن أنك تسمعها من راوٍ قديمٍ يجلس على ضفة النيل. في قاعة البرلمان، كان بين مَن أطلقتُ عليهم “صفوف المقاتلين”.
لا يُجامل وزيرًا، ولا يخشى هتافًا، يقف شامخًا كعمودٍ من طين الوطن اليابس، صُنع ليتحمل لا لينكسر.
وحين يتحدث، يختصر الموقف بكلماتٍ من ذهب، ويعود إلى مقعده كأن شيئًا لم يكن.
لم يكن أحدٌ في البرلمان إلا ويحبه.
كان إذا دخل القاعة عمّ الضحك، وإذا غادرها ساد الصمت احترامًا.
يمزح في خفة، ويُعاتب في لطف، ويُصحّح الخطأ وكأنه يُربّت على كتف صاحبه لا يوبّخه.
في مواقفه الوطنية، كان صوتًا ضد التسلّط، وضد التزييف. رفض إغراءات السلطة، واحتفظ لنفسه بمسافةٍ آمنةٍ بين الكرامة والمصلحة، وكان يرى في العدالة الاجتماعية امتحانًا للنائب قبل أن تكون واجبًا للحكومة.
في حزب غد الثورة، كان أحد رموز لجنة الحكماء،
وعندما يُذكر اسمه في الحزب، يُذكر كابتسامةٍ طيبةٍ وسط زحامٍ من المواقف الصاخبة. يحمل في جيبه نكتةً، وفي قلبه رأيًا، وفي صوته صدقًا لا يخطئه أحد.
كان يقول لي دائمًا:
“إذا كنتَ تطلب الكلمة، فاحملها كمن يحمل رايةً لا سيفًا، فالسيوف تجرح، أما الرايات فتهدي الطريق.”
تلك الجملة ظلّت ترنّ في أذني كلما وقفت على منصةٍ، وكلما اشتدّ حولي الضجيج.
عبد الفتاح الشافعي، في حياته، لم يكن نائبًا عن زفتي فقط، بل نائبًا عن روح مصر التي تُعلي من شأن المروءة قبل السياسة، والتي تعرف أن خفة الروح لا تناقض عمق الفكر، زأن الرجولة ليست صوتًا مرتفعًا، بل مبدأ لا ينكسر.
واليوم، أكتب عنه لا لأُحيي الماضي، بل لأقول إنّ هذا الرجل لم يكن “صفحةً في التاريخ”، بل فصلًا من كتاب الإنسانية في العمل العام، ورمزًا لوطنٍ حين نبحث عن “النائب المثالي” فلا نجد إلا صورته.
سلامٌ عليك يا عبد الفتاح الشافعي، يا من جعلت من السياسة مساحةً للفرح، ومن الموقف لوحةً من الكبرياء.
حفظك الله، وأطال عمرك، وجعل في سيرتك دربًا يهتدي به الجيل الجديد من أبناء زفتي ومصر كلها.