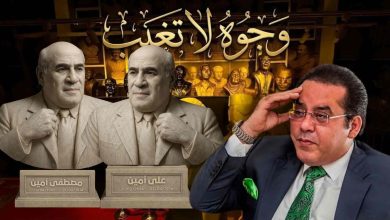هناك ظاهرة سياسية اجتماعية ألاحظها في التعامل مع الكثيرين من النخبة المصرية، حتى بين الوزراء والعاملين في الأجهزة الحاكمة.
هم في الوظيفة شيء، وعندما يتركون الوظيفة شيء آخر.
هنا مدافعين عن النظام، وهنا معارضين.
ما أشير إليه هو ظاهرة الانشطار السلوكي للنخبة داخل السلطة،
أي الانفصال بين الرأي الشخصي والموقف المؤسسي، بين ما يُقال في الجلسات الخاصة، وما يُعلن في العلن، أو يُمارَس في موقع السلطة. وهي ظاهرة ليست مصرية فقط، بل تتكرر في الأنظمة السلطوية، لكن لها خصوصية مقلقة في السياق المصري.
أرى أشخاصًا عاقلين، مثقفين، شبابًا يحملون رؤى نقدية ناضجة في أحاديثهم الخاصة،
بل يشاركونني التحفظات نفسها على أداء الدولة، وعلى شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع، وعلى اختناق الحريات…
لكن هؤلاء أنفسهم، حين يعودون إلى مواقعهم الرسمية، إلى “وظيفتهم”، يتغير سلوكهم تمامًا، وكأنهم يسقطون وعيهم الشخصي على عتبة المكتب، ويتقمصون شخصية أخرى، لا تُبدي رأيًا، بل تنفّذ، وتُبرّر، وتُسكت.
والأكثر غرابة، بل إثارة للحزن، أن هذا الانفصال لا يكون دائمًا خضوعًا قسريًا،
بل أحيانًا استبطانًا طوعيًا لمنطق المؤسسة. كأن هناك عقلاً جمعيًا خفيًا يبتلع الفرد، ويعيد تشكيله، حتى يُصبح “هو” المؤسسة، لا ذاته.
إنني أسميها ظاهرة الانشطار بين “الوظيفة” و”الإنسان”،
حيث يعيش بعض هؤلاء حالة انفصام سلوكي:
في الجلسات الخاصة: ناقدون، مثقفون، متنورون.
في مواقعهم الرسمية: صامتون، مندمجون، مدافعون عن كل ما يُمارس.
- هنا تُطرح أسئلة وجودية:
- هل يخافون؟ ربما.
- هل يحتمون بالمؤسسة؟ بالتأكيد.
- “لا أخطر على الحرية من مواطن مؤمن بحرية الرأي… لكنه يوقّع على قمعها كل يوم.”
أرى مواطنين شباب يؤيدون إجراءات لا يقتنعون بها، أو يهاجمون رموزًا يؤمنون بصدقها،
أو يصمتون أمام ممارسات لا تتفق مع ضمائرهم، ليس لأنهم سيئون، بل لأن المؤسسة، ككيان ضاغط، قادرة على إعادة برمجة العقل، وتحويل القناعة إلى واجب صامت.
هل المشكلة في الأشخاص؟ أم في بنية المؤسسة؟
لا ينبغي أن نُحمّل الأفراد وحدهم هذا العبء. فغالبًا ما تكون المؤسسات الحاكمة والتابعة مُصممة على نحو يُقصي الصوت المستقل، ويكافئ التماهي، ويُقصي الاختلاف.
“العقل الجمعي للمؤسسة أقوى من وعي الفرد حين تغيب الحماية الثقافية والمؤسسية لحرية الرأي.”
نحن لا نتحدث عن عجز أخلاقي بقدر ما نتحدث عن بنية إدارية تُحوّل الكفاءات إلى أدوات،
وتُفرغ البشر من أدوارهم الفكرية ليصبحوا تروسًا في ماكينة القرار.
هذا المقال البحثي يسعى إلى تفكيك هذا الانفصام السلوكي، وتحليل أسبابه النفسية والاجتماعية والسياسية، وتأثيره على الدولة الحديثة في مصر، من خلال دراسة نموذج النخبة الرسمية ذات الوعي المزدوج.
ما الذي يفسّر هذا التناقض الظاهري بين وعي الأفراد العاملين داخل المؤسسات المصرية الحاكمة وسلوكهم الرسمي؟
وكيف تساهم بنية المؤسسة وآلياتها في إعادة تشكيل وعي النخبة داخلها؟
وهل يُمكن تفكيك هذه الظاهرة لإعادة بناء علاقة أكثر صحة بين الفرد والدولة؟
لا يمكن لأي مؤسسة أن تتجدد ذاتيًا إذا كانت تحتجز عقول أفرادها،
والخطر على مصداقية الدولة هو ظهور هذا الازدواج بين ما يُقال في الخفاء وما يُعلن في العلن، حيث تتآكل ثقة الناس في النخبة.
علميًا، يُعدّ الصراع بين الوعي الفردي والوعي المؤسسي من أعمق الإشكاليات التي تواجه الأنظمة السياسية،
خاصة تلك التي تتسم بالسلطوية أو المركزية الصلبة. فالإنسان، بوصفه كائنًا عاقلًا، يحمل في داخله قدرة أصيلة على التفكير النقدي، وإبداء الرأي، وتقييم ما يدور حوله من قرارات وسلوكيات.
لكن حين يدخل في منظومة مؤسسية ذات هرمية صارمة، يجد نفسه أمام ضغوط خفية ومعلنة تدفعه للتخلي عن ذاته لصالح “النسق الأعلى”.
تشير تجارب ستانلي ميلغرام (Stanley Milgram)
إلى أن الأفراد العاديين مستعدون لتنفيذ أوامر تتعارض مع قناعاتهم الأخلاقية حين تصدر من سلطة تُعطى لها الشرعية الشكلية، حتى لو أدى ذلك لإيذاء آخرين.
ورغم أن تجربة ميلغرام دارت في إطار أكاديمي، فإن دلالاتها تنطبق بقوة على المؤسسات السياسية والأمنية، حيث تُعاد صياغة السلوك الفردي داخل أنظمة الأمر والتنفيذ.
في مصر، يمكن ملاحظة كيف يتحول كثير من المواطنين والمسؤولين إلى أدوات تنفيذية مجردة،
لا يناقشون، ولا يتساءلون، بل أحيانًا لا يفكرون أصلاً في طبيعة ما يُطلب منهم.
يحدث ذلك ليس فقط نتيجة الخوف، بل نتيجة تكيّف تدريجي مع منطق المؤسسة، بحيث يصبح “الامتثال” هو القاعدة، و”التفكير” خروجًا عن النص.
ظاهرة ابتلاع العقل الجمعي للأفراد
يُظهر إميل دوركايم (Émile Durkheim) في تحليله للعقل الجمعي أن المجتمعات تُنتج وعيًا جماعيًا أقوى من وعي الأفراد، ويُعاد إنتاج هذا الوعي من خلال الطقوس، القوانين، والتكرار السلوكي داخل الجماعات.
المؤسسات البيروقراطية، خاصة الأمنية، تخلق مع الوقت نمطًا ذهنيًا خاصًا بها، تُعيد من خلاله تشكيل أفرادها لا وفق كفاءاتهم، بل وفق قدرتهم على التماهي مع النسق، والقبول بما هو قائم.
وفي السياق المصري، تصبح عبارات مثل “ما ينفعش نتكلم في ده هنا” أو “مش وقته” أو “شيل التلفون بعيد” مؤشراً على تجذر هذا الوعي الجمعي،
الذي يُقصي الصوت النقدي، حتى وإن حمل صاحبه أعلى درجات الإخلاص للدولة ذاتها.
يشير ميشيل فوكو (Michel Foucault)
إلى أن السلطة لا تفرض هيمنتها بالقمع المباشر فحسب، بل من خلال إعادة تشكيل الجسد والعقل داخل أنظمة المراقبة والانضباط. وهكذا، يُعاد تشكيل الفرد ليصبح هو نفسه أداة لانضباط الآخرين، وذاته.
داخل هذه النظم يتحوّل المواطن، أحيانًا دون وعي، من إنسان مفكر إلى ما يمكن تسميته “وظيفة ناطقة”،
يتحدث بلسان المؤسسة، لا بضميره؛ يدافع عن السياسات كما هي، لا كما يراها، بل وقد يتبنى موقفًا يرفضه داخليًا، لكنه يُسوّغه كجزء من “الحكمة الأمنية” أو “مقتضيات المرحلة”.
كثير من النخبة لا يفعلون ذلك بدافع النفاق، بل باعتباره “تكتيكًا للبقاء” في نظام لا يتحمل التمايز.
يظهر بذلك ما يمكن تسميته “الهوية المنفصمة”؛ حيث يحتفظ الفرد برأي شخصي في الداخل، بينما يُظهر موقفًا رسميًا في الخارج.
لكن الخطورة أن هذا الانفصام يتحول، مع الزمن، إلى انصهار حقيقي… وتغيب الذات الأصلية تدريجيًا.
من خلال الملاحظة الميدانية والقراءة السوسيولوجية للسلوك العام للنخبة المصرية العاملة داخل أجهزة الدولة،
يتضح أن ظاهرة الانفصام السلوكي بين ما يُقال في الخفاء وما يُمارس في العلن، ليست مجرد مسألة فردية، بل بنية مستقرة في العقل المؤسسي المصري.
بنية تفرض على الأفراد أن يقدّموا النظام الحاكم لا باعتباره كيانًا سياسيًا قابلًا للنقد والتطوير، بل باعتباره حقيقة نهائية فوق المراجعة.
يُمكن تفسير ذلك بما يسميه بعض الباحثين الذوبان الهوياتي،
حيث لا يعود المواطن يرى نفسه ككيان له حق التفكير والمساءلة، بل كأداة دفاع مطلقة عن النظام، مهما تكن أخطاؤه.
وهنا تظهر معادلة خطيرة:
“كلما ازداد الشعور بالضعف أمام السلطة، كلما ازدادت الحاجة إلى تمجيدها دفاعًا عن الذات.”
هكذا يُعاد إنتاج نخبة مخلصة شكليًا، لكنها معطلة فكريًا. نخبة قادرة على الدفاع عن السياسات، لكنها…