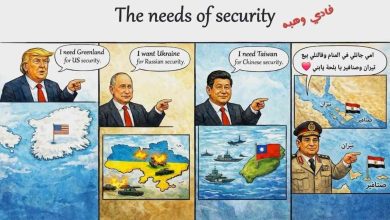في ذاكرة الوطن صفحاتٌ منسية، وصفحاتٌ لا تُمحى.
ومن بين هذه الصفحات، تقف تجربة الحياة النيابية في مصر شاهداً على تحول جذري في مفهوم المشاركة السياسية، تحول يمكن رصده بوضوح عند مقارنة انتخابات مجلس الأمة قبل ثورة 1952 بما تلاها من استحقاقات.
قبل الثورة العصر الذهبي للبرلمان الذي “كاد” أن يكون
قبل عام 1952، وعلى الرغم من كل سلبياتها، شهدت مصر تجربة برلمانية حقيقية.
لم تكن مثالية، فالصورة لم تخلُ من تأثيرات القصر والإنجليز، وكانت “العراقيل الإدارية” أحياناً وسيلة لإقصاء الخصوم.
ولكن، وبحسب شهادات تاريخية ووثائق، كانت هناك استحقاقات نزيهة إلى حد كبير، تحكمها قوانين انتخابية متطورة، وتحت رقابة قضائية حقيقية.
في تلك الفترة، كانت المنافسة محتدمة بين حزب “الوفد” العريق ذي القاعدة الشعبية الواسعة، والأحزاب الأخرى مثل “السعديين” و”الدستوريين”.
كانت الحملات الانتخابية تعج بالخطباء في المقاهي والأندية، وتناقش البرامج، وتتصارع الأفكار.
وكان الفوز أو الخسارة يتحددان، في كثير من الحالات، بقدرة المرشح على إقناع الناخبين، وليس بإرادة جهة أمنية واحدة.
لا يمكن إنكار أن الفترة الليبرالية، خاصة في انتخابات 1924 و1936 وحتى 1950، شهدت منافسة سياسية حقيقية.
كان البرلمان منبراً حياً للصراع، حيث كان النواب يستجوبون الوزراء، ويرفضون السياسات، ويشكلون حكومات ويسقطونها.
كانت هناك سلطة تشريعية فاعلة، وإن لم تكن مطلقة، أمام سلطة تنفيذية يهيمن عليها القصر والقوى الاستعمارية”.
كانت صناديق الاقتراع في ذلك العهد، وإن لم تكن معبرة عن إرادة كل الشعب في ظل نظام طبقى محدود الناخبين، إلا أنها كانت تُغلق على صوت الناخب الحقيقي، لتبعث برسالة سياسية واضحة إلى القصر وإلى الاحتلال.
مع بزوغ فجر ثورة 23 يوليو 1952، تغيرت المعادلة جذرياً
ومنها صار الصندوق “شكلاً بلا روح” .
جاءت الثورة بفكر جديد، رأى في “الفوضى” الحزبية و”فساد” النظام القديم تبريراً لإلغاء الحياة الحزبية وتعطيل العمل البرلماني لسنوات.
وعندما عادت المجالس النيابية تحت مسميات مختلفة كـ”مجلس الأمة” ثم “مجلس الشعب”، كانت قد فقدت روحها.
تحولت الانتخابات بعد الثورة إلى طقس شكلي، تُخطط له وتديره أجهزة الدولة الأمنية والسياسية.
أصبح “التزوير” و”التوجيه” سيدا الموقف.
لم يعد الهدف هو تمثيل إرادة الشعب، بل تأكيد شرعية النظام السياسي الجديد وإرادته.
فقد تم تأسيس ما يُعرف بـ’الاتحاد الاشتراكي’ ليكون الحزب الوحيد، فاختفت المعارضة الحقيقية.
كانت الانتخابات تجرى لاختيار المرشح ‘المقبول’ من قبل النظام.
التزوير لم يكن مجرد تزوير أوراق، بل كان ‘تزويراً للإرادة’ عبر ترهيب الناخبين، والترويج لمرشحي السلطة، وتزوير النتائج علناً لضمان أغلبية ساحقة ومطلقة للحزب الحاكم”.
من انتخابات “الاتحاد الاشتراكي” في الستينات، إلى “استفتاءات” التأييد التي كانت نتائجها تُعلن بنسب تقترب من 99.9%، إلى انتخابات الحزب الوطني الديمقراطي لاحقاً، ظلت القاعدة واحدة فأصبح البرلمان أداة لتجميل وجه النظام، وليس لمراقبته أو محاسبته.
أصبح الصندوق مغلقاً على إرادة السلطة، لا على اختيار الشعب.
ويأتي عهد السيسي وهو الأسوا في الحياة السياسيه والبرلمانية.
تبقى المقارنة بين العهدين ليست مجرد استعادة للماضي، بل هي تأكيد على أن قيمة أي مؤسسة تمثيلية تكمن في استقلاليتها ونزاهة اختيارها.
مجلس الأمة قبل 1952، بكل نقاط ضعفه، كان جزءاً من مشروع ديمقراطي متعثر لكنه حقيقي.
أما المجالس التي جاءت بعد الثورة، فحولت العملية الانتخابية إلى استعراض للقوة، مجردة من مضمونها الديمقراطي، لتُكرس ثقافة السياسة الأحادية التي يصعب كسر حلقاتها حتى اليوم.
في النهاية، تذكرنا هذه الرحلة أن صناديق الاقتراع لا تملك قدسيتها من خشبها أو حديدها، بل من الإرادة الحرة التي توضع بداخلها، والأمانة التي تُحصى بها.