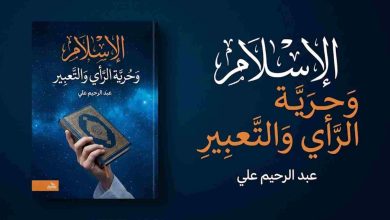زمنُ الغزواتِ مضى.. والرفاقُ ذهبوا.. ورجعنا يتامى.
سلامٌ إذن على الفتى الذي كان، يُقرضُ الشعرَ ويكتبُ القصة، ويُوقِعُ بفتياتِ المدينةِ الصغيرةِ في غرامِه من أوّلِ نظرة..
تلك كانت أسطورتَه!
يُردِّدُ دائمًا مقولةَ العمِّ صلاح عيسى: «نحنُ أبناءُ الفقراءِ نُدعى»، لكن عِزّةَ نفسِه لا تُفارِقُه لحظة، وكبرياؤه غيرُ قابلٍ للمساومة، وكرامتُه ليست للبيع..
جُملٌ حفظها عن ظهرِ قلبٍ من فمِ الشيخ «علي» الأب، حين كان يتفوّه بها في سكونِ الليل، والفتى يُنصت.
حكاياتٌ من زمنِ الهزيمةِ والصمودِ والانتصار، كان يحكيها الشيخُ بشغف، ويتجرّعها الابنُ كأنّها صنبورٌ من مياهٍ عذبة، تغسلُ روحَه فيهيمُ عشقًا بها.
تلك الظلالُ التي رسمت نقوشًا على روحِه، عندما جاء الأبُ حزينًا مكسورًا في الخامسِ من يونيو عام 1967، ليمكثَ في حجرته وحيدًا، يرفضُ الاختلاطَ بأحد.
كان الصبيُّ في الرابعةِ من عمرِه، لكنه أدركَ كلَّ شيء.
بعدها بأيامٍ، يرحلُ الأبُ إلى الجبهة، بعدما ودّع الأمَّ وأوصى بالصبي.
ستةُ أعوامٍ، هي مدةُ غيابِ الأب بعيدًا، حيث حقولُ الصبرِ والقنصِ ومواجهةُ الظلام..
ستةُ أعوامٍ تقصُّ الأمُّ على الطفل حكاياتِ أدهم الشرقاوي وأبي زيد الهلاللي، وتسهرُ إلى جواره، والعينُ يحرسها الليل؛ حيث خشخشةُ النخل، واهتزازُ الباب، وصفيرُ الريح، في غيابِ الأب، يُوحِّدهما.
ستةُ أعوامٍ يحاولُ فيها الأبُ إثباتَ أنّه جديرٌ بالحبِّ الذي منحَه إيّاه الصبيُّ والمرأة، حتى نالَه في أكتوبر 1973.
يومها حضنَ الأبُ زوجتَه وابنَه حضنًا لم يعتادوه منه من قبل، حيث سقطت دموعُه الساخنةُ على وجهَيهما، غيرَ مستوعبَين كيف لأسدٍ كذاك أن يبكي، وهو الذي طالما ردّد أمام الصبيّ ذلك التعبيرَ الذي ظلّ الفتى يذكُره بينه وبين نفسه، كلّما ألمّت به الملمّات: الرجالُ لا يبكون..
هل تلك كانت أسطورةَ الشيخ التي سقطت في بحرِ الحنين؟
أم أنّه ألمُ تلك السنواتِ الستّ التي حاول فيها الشيخُ أن ينتزعَ النصرَ ليُقدّمه للصبي، تنفيذًا لوعده الذي وعده إيّاه في لحظاتِ الصمتِ البعيدة، ليستعيدَ الأبُ هيبتَه، ويستعيدَ الابنُ مكانتَه بين أقرانِه؟
وعندما كبر الصبي، وراح يمزجُ محمود درويش بالطيب صالح، وأدونيس برشيد بوجدرة، وأمل دنقل بحنّا مينا، وشوقي بزيع بعبد الرحمن منيف، وصلاح عبد الصبور بنجيب محفوظ، وعبد الرحمن الأبنودي بيوسف إدريس، وصلاح جاهين ببهاء طاهر، ومالك حدّاد بجبرا..
الشعرَ بالرواية..
لم يدرِ بخلده يومًا أنّه سيفارقُ تلك الأسطورةَ التي سكنته طوالَ سنواتِ صباه: أن يكون شاعرًا، ويمضي إلى حيث كان الشيخُ يرغب، فيروي عطشَ الأمِّ إلى صعودِ المُنتهى.
لكنّه الآن يُدرك أنّ النهاياتِ باتت قريبة، وأنّه أبعدُ ما يكون عن خطواتِه الأولى على أرصفةِ مدينتِه الجميلة، حيث كلُّ شيءٍ طازجٌ رطبٌ بطعمِ النيل، وبريءٌ كوجهِها.
كانت عذوبةُ النهر، وما تبقّى من وجوهِ الرفاقِ القدامى، وقصصُ تشيخوف، وأشعارُ نيرودا، وأغاني فيروز في المساء، هي كلُّ ما يملك من ذكرياتٍ عن مدينتِه العتيقة..
مدينة نفرتيتي.
هو العمرُ قد طال به إذن، ولا شيء يذكّره بتلك الليالي البعيدة، سوى الشمسِ التي اتّحدت بوجهِ شاهندة كي تُضيء، والطيبةِ في عيونِ داليا، وغادة وهي تُورِقُ في ربيعِ العمر، رفيقةَ دربه الحنون، ووجهَ أمّه، وخالد حين يرحلُ كلُّ الأصدقاء، ونور حين ينطفئُ في شوارعِ مدينتِه القديمة النهار.
وما زال الفتى يتبعُ خطى قلبِه، يعرفُ أنّها تسكنُه منذ كان طفلًا.
كان ذلك من بعيد.. خمسين عامًا أو يزيد…
حين تنطفئُ المرايا، كانت هي النورَ الذي يأتيه من ألفِ فجٍّ عميق…
(تم الحفاظ على المقطع الشعري كما هو دون أي تعديل)
فيدركُ الفتى، الذي كان، أنّ الخطرَ قد زال، فيُسلِّمُ راحتَه بين يديك، ثم ينام.
بروكسل: الخامسةُ مساءً بتوقيتِ القاهرة