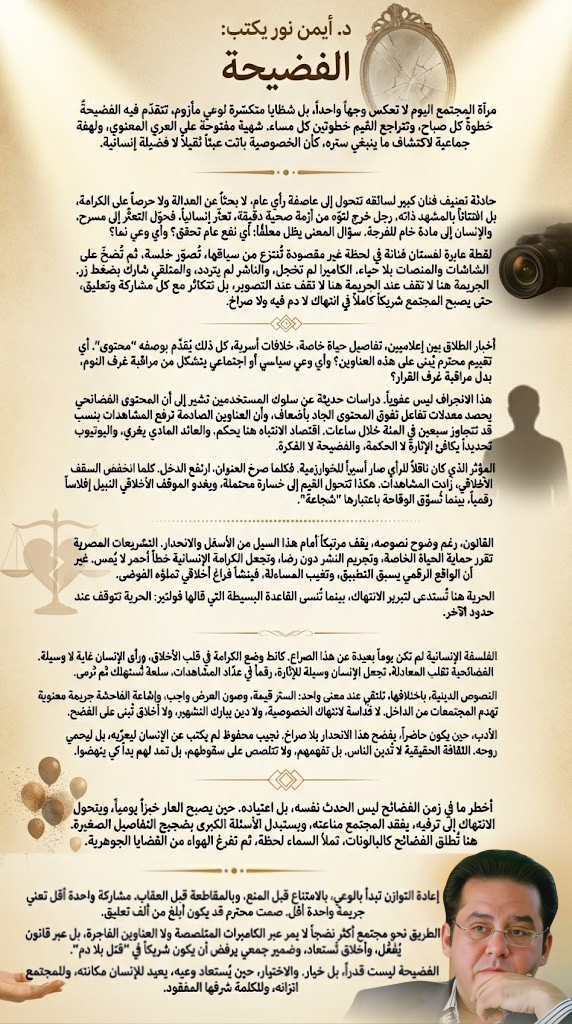مرآة المجتمع اليوم لا تعكس وجهاً واحداً، بل شظايا متكسّرة لوعيٍ مأزوم، تتقدّم فيه الفضيحة خطوةً كل صباح، وتتراجع القيم خطوتين كل مساء. شهية مفتوحة على العري المعنوي، ولهفة جماعية لاكتشاف ما ينبغي ستره، كأن الخصوصية باتت عبئاً ثقيلاً لا فضيلة إنسانية.
• حادثة تعنيف فنان كبير لسائقه تتحول إلى عاصفة رأي عام، لا بحثاً عن العدالة ولا حرصاً على الكرامة، بل افتتاناً بالمشهد ذاته. رجل خرج لتوّه من أزمة صحية دقيقة، تعثّر إنسانياً، فحُوِّل التعثّر إلى مسرح، والإنسان إلى مادة خام للفرجة. سؤال المعنى يظل معلقاً: أي نفع عام تحقق؟ وأي وعي نما؟
• لقطة عابرة لفستان فنانة في لحظة غير مقصودة تُنتزع من سياقها، تُصوَّر خلسة، ثم تُضخّ على الشاشات والمنصات بلا حياء. الكاميرا لم تخجل، والناشر لم يتردد، والمتلقي شارك بضغط زر. الجريمة هنا لا تقف عند التصوير، بل تتكاثر مع كل مشاركة وتعليق، حتى يصبح المجتمع شريكاً كاملاً في انتهاك لا دم فيه ولا صراخ.
• أخبار الطلاق بين إعلاميين، تفاصيل حياة خاصة، خلافات أسرية، كل ذلك يُقدَّم بوصفه “محتوى”. أي تقييم محترم يُبنى على هذه العناوين؟
وأي وعي سياسي أو اجتماعي يتشكل من مراقبة غرف النوم ،
بدل مراقبة غرف القرار؟
• هذا الانجراف ليس عفوياً. دراسات حديثة عن سلوك المستخدمين تشير إلى أن المحتوى الفضائحي يحصد معدلات تفاعل تفوق المحتوى الجاد بأضعاف، وأن العناوين الصادمة ترفع المشاهدات بنسب قد تتجاوز سبعين في المئة خلال ساعات. اقتصاد الانتباه هنا يحكم، والعائد المادي يغري، واليوتيوب تحديداً يكافئ الإثارة لا الحكمة، والفضيحة لا الفكرة.
• المؤثر الذي كان ناقلاً للرأي صار أسيراً للخوارزمية.
فكلما صرخ العنوان، ارتفع الدخل. كلما انخفض السقف الأخلاقي، زادت المشاهدات.
هكذا تتحول القيم إلى خسارة محتملة، ويغدو الموقف الاخلاقي النبيل إفلاساً رقمياً، بينما تُسوَّق الوقاحة باعتبارها “شجاعة”.
• القانون، رغم وضوح نصوصه، يقف مرتبكاً أمام هذا السيل من الاسفل والانحدار.
التشريعات المصرية تقرر حماية الحياة الخاصة، وتجريم النشر دون رضا، وتجعل الكرامة الإنسانية خطاً أحمر لا يُمس.
غير أن الواقع الرقمي يسبق التطبيق، وتغيب المساءلة، فينشأ فراغ أخلاقي تملؤه الفوضى.
الحرية هنا تُستدعى لتبرير الانتهاك، بينما تُنسى القاعدة البسيطة التي قالها فولتير: الحرية تتوقف عند حدود الآخر.
• الفلسفة الإنسانية لم تكن يوماً بعيدة عن هذا الصراع. كانط وضع الكرامة في قلب الأخلاق، ورأى الإنسان غاية لا وسيلة. الفضائحية تقلب المعادلة، تجعل الإنسان وسيلة للإثارة، رقماً في عدّاد المشاهدات، سلعة تُستهلك ثم تُرمى.
• النصوص الدينية، باختلافها، تلتقي عند معنى واحد: الستر قيمة، وصون العرض واجب، وإشاعة الفاحشة جريمة معنوية تهدم المجتمعات من الداخل. لا قداسة لانتهاك الخصوصية، ولا دين يبارك التشهير، ولا أخلاق تُبنى على الفضح.
• الأدب، حين يكون حاضراً، يفضح هذا الانحدار بلا صراخ.
نجيب محفوظ لم يكتب عن الإنسان ليعرّيه، بل ليحمي روحه.
الثقافة الحقيقية لا تُدين الناس، بل تفهمهم، ولا تتلصص على سقوطهم، بل تمد لهم يداً كي ينهضوا.
• أخطر ما في زمن الفضائح ليس الحدث نفسه، بل اعتياده. حين يصبح العار خبزاً يومياً، ويتحول الانتهاك إلى ترفيه، يفقد المجتمع مناعته، ويستبدل الأسئلة الكبرى بضجيج التفاصيل الصغيرة. هنا تُطلق الفضائح كالبالونات، تملأ السماء لحظة، ثم تفرغ الهواء من القضايا الجوهرية.
• إعادة التوازن تبدأ بالوعي، بالامتناع قبل المنع، وبالمقاطعة قبل العقاب. مشاركة واحدة أقل تعني جريمة واحدة أقل. صمت محترم قد يكون أبلغ من ألف تعليق.
• الطريق نحو مجتمع أكثر نضجاً لا يمر عبر الكاميرات المتلصصة ولا العناوين الفاجرة، بل عبر قانون يُفعَّل، وأخلاق تُستعاد، وضمير جمعي يرفض أن يكون شريكاً في “قتل بلا دم”.
• الفضيحة ليست قدراً، بل خيار. والاختيار، حين يُستعاد وعيه، يعيد للإنسان مكانته، وللمجتمع اتزانه، وللكلمة شرفها المفقود.