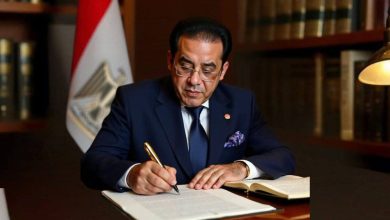المدينةُ:
هل كنتَ أنتَ الذي عشِقَتك المدينة، أم أنّه أحدٌ سواك؟!
تمشي على طرقاتها وحيدًا في الليل، تتذكّر شمسَ أبيب (يوليو)، وباحةَ البيتِ القديم، والنهرَ، وترعةَ الإبراهيمية، والرفاق.. تنوءُ بلحظةِ الشوق، وتنتظرُ الوداعَ الأخير.
يطلُّ الشيخُ بلحيتِه البيضاء عبر درجِ البيت يبكي.. لقد ماتت الجدة. كانت إذا جئتُ، تُجلِسُني على ساقيها، وتفتلُ لي من دقيقِ القمحِ والعسلِ ما يُشبِعُ نهمي إلى الحلوى، وتحكي لي عنه وعن حصانِه في الليل.. تلك العلاقةُ التي ظلّت تُداعبُ مخيّلتي.
كنتُ أتساءلُ دائمًا: لماذا لا يمتطي أبي الحصانَ مثل جدّي؟!
أسئلةُ البراءةِ الأولى التي تلاشت عندما أجهشَ جدّي بالبكاء. كان أبي واقفًا، تتدلّى يداه، وأنا ممسكٌ بها، أُركّزُ عينيّ على مشهدِ الرجالِ يحملون نعشَ جدّتي، وأهرولُ نحو حجرتِها باكيًا.
خمسةٌ وخمسون عامًا أو يزيد.. كنتُ في السادسةِ من عمري، وكان أبي في الواحدةِ والأربعين. جلسنا ثلاثتُنا في الليل، بعد انصرافِ الجمع، يُغلّفُنا صمتُ الوجع، وفي المساء ارتميتُ في حضنِ أمّي وغفوت.
النَّهْرُ:
على حافةِ السين، باريسُ تفتحُ لي ذراعيها كلَّ مساء؛ تستقبلني ضاحكةً كعادتها، وتسأل:
أين كنتَ أيها الغريب؟!
كنتُ أَجلِسُ على مقهى «السَّلام» La Paix، يا سيِّدَتي،
حيثُ مجلسُ الكِبار؛ فيكتور هوغو، ومارسيل بروست، وإميل زولا.
أمَا زِلتَ تَرتادُ المَقاهي بعدَ هذا العُمر؟!
بعد رحيلِ الأصدقاء، لم يبقَ لي سوى المقهى، والحمقى، والمطرِ المتساقطِ من فجواتِ الغيم يا سيدتي!
تضحكُ، ثم تمضي شاخصةً.
أبحثُ عنك في كلِّ التصاوير التي تتراءى أمامي: في الحوانيت، في المقاهي، أسافرُ خلفك…
أدخُلُ كلَّ المطاراتِ، وأسألُ كلَّ الفنادقِ؛ فقد يتصادفُ أنَّكِ فيها، فكيف أقاتل خمسين عاما على جبهتين؟ وكيف أبُعثر لحمي على قارتين؟ وأظلّ أُحدِّقُ في التواريخ البعيدة، ولا أرى أحدًا سواكِ.
في مساءِ باريس تكثرُ الأمنيات، كما يكثرُ الحزن.
ينتابني غضبٌ شديد؛ فالأجواءُ مُلهِمة، وأنا عاجزٌ عن الكتابة. لا شيء يقهرني سوى عجزي عن الكتابة حين تكون الأبوابُ مشرعة، والأجواءُ مواتية، والخريفُ يُمزّقُ الآفاق.
تلك ابنتي الصغرى تهتفُ من بعيد: اكتبْ عن طفولتِنا معك، عن شراءِ اللعب، وسماعِ الأغنيات، والسفرِ عبر البحار.
ويهمسُ النهرُ لي: لماذا لا تستبيحُ المسافاتِ بين الفصول، وتكتبُ عن انهمارِ المطر، وانبلاجِ النهار، وصمتِ الحقول، ووشوشةِ العنب؟
قال لها الأعرابيُّ يومًا: صبّي، ففي كلِّ عامٍ ينضجُ العنب!
الطرقاتُ مزدحمةٌ بالمارة في الشانزليزيه، كلُّ النظراتِ مسرعة، لا أحد يحدّقُ في أحد، في هذه المدينة، سواي.
ربَّما كنتُ أُفتِّشُ عن نَغَمٍ ضاعَ مِنِّي.
فمِن أيِّ بحرٍ عَصِيَّ الرِّيحِ يَجيء؟
ربَّما كنتُ أبحثُ عن نَهارٍ على ضِفَّةِ السِّينِ، خاصَمَتْهُ الشَّموسُ!
في مساءاتِ باريس كلُّ شيءٍ واضح.
الطرقات، والمحلّات، والأزياء، والورود، والناي، كلُّ شيءٍ واضح، كالنهار.
يأتي “إدوارد” عازفُ الناي إليّ مبتسمًا، ينفخُ قطعةً أخرى لسيدة الغناء العربي..
أنا وإنتَ ظلمنا الحُبّ بإيدينا، وجينا عليه وجرحناه لحدّ ما داب حوالينا.. محدّش فينا كان عايز يكون أرحم من التاني، ولا يضحّي عن التاني.
لا شيء يبقى من ذكرياتِ السنينِ الطويلة سواه، يقول لي، ويُشيرُ إلى الناي، ويستمرُّ في العزف.
يتساءلُ بدهشةٍ مصنوعة: أين ذهب الكبار؟!
لا ألتفتُ لسؤاله. يُباغتني بذكرِ أسماء: صباح، ووردة، وعبد الحليم، ووديع الصافي، ثم يُردِف: كانوا هنا يُضيئون مساءات باريس، وكنتُ معهم أعزفُ أجملَ الألحان.. ثم يمضي.
هنالك أدركُ أنّ المسافاتِ قد ذبلت، وأنّ المدينةَ لم تعد تحتملُ حزني، وأنّه لا بدَّ من فراق.
الحَيَاةُ :
على هذه الأرضِ ما يستحقُّ الحياة: دعواتُ أمّي، عظامُ أبي في تربتِه، صرخاتُ أمهاتِ الشهداء وهنّ يطالبن بالثأر، عشقُ البناتِ الجميلات لكابِ الجنود، ترنيمةُ عشقٍ في أوبرا إسماعيل باشا، كورنيشُ الإسكندرية، زفّةُ زارٍ قديمة على أعتابِ آل البيت، حنينُ المجذوبين، دموعُ العجائز في جنائزِ الأحباب، شوارعُ قريتنا الضيّقة، وسطُ البلد، مقهى ريش، نادي السيارات، الجريون، مكتبةُ مدبولي، ودارُ ميريت.
جوارِ السَّيِّدِ البدوي، وسيدي إبراهيم الدسوقي، والإمام أبي الحسن الشاذلي، عتبات آل البيت، وصلاةُ الفجر في سيدنا الحسين، والعشاء بمقام السيدة نفيسة، وقراءةُ الورد عند رئيسة الديوان،..
الكنيسةُ المرقسية، والجامعُ الأزهر، ورقُ البردي، والأهرامات، ورأسُ أبو الهول الصامد منذ آلافِ السنين، تراتيلُ مصطفى إسماعيل، وعبد الباسط عبد الصمد، والمنشاوي، ومحمد رفعت، السيرةُ العطرة للبابا كيرلس، والشيخ عبد الغني النابلسي، ومحمد عبده، والإمام عبد الحليم محمود.
أديرةٌ ومساجدُ غرِقَتْ في دموعِنا وحنينِنا وفرحِنا وحُزنِنا لأربعةِ عقودٍ؛ ديرُ العذراءِ مريم، وديرُ المُحرَّق، وسانت كاترين؛ شوارعُ ومدن؛ عشقُنا لرمالِها، وخضرتِها، وريحتِها، وهوائِها، ومائِها، قراها واحيائها، تلك الحقيقةُ الأبديةُ الساكنةُ في الحروفِ الثلاثة: «مصر»، وثلاثيةُ المدينةِ والنهرِ والحياة.
باريس: الخامسةُ مساءً بتوقيتِ القاهرة