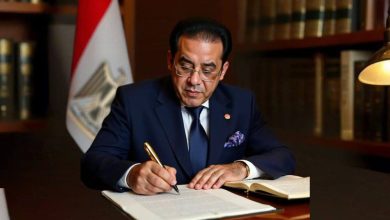لم تكن ثورة يناير حدثًا مصريًا خالصًا، ولا انفجارًا اجتماعيًا محصورًا في حدود الدولة الوطنية، بل كانت – في عمقها – لحظة إنسانية كبرى تلاقت فيها تجارب القهر المحلية مع ذاكرة عالمية ممتدة من الظلم، والاستعمار، والهيمنة، وازدواجية المعايير. في ميدان التحرير، لم يكن الغضب موجهًا فقط إلى نظام حكم بعينه، بل إلى منظومة أوسع رأى الناس آثارها تتكرر: استبداد في الداخل، وتواطؤ في الخارج، وصمت دولي حين تُنتهك الكرامة، ثم مواعظ أخلاقية حين تطالب الشعوب بحريتها.
في شهادتي، أؤكد أن وعي يناير لم يتشكل فجأة، ولم يولد في لحظة دعوة على “فيسبوك”، بل كان حصيلة تراكم طويل من المشاهدة، والمقارنة، والخذلان. نحن جيل عاش وهو يرى العالم يُقسم بوضوح: ضحايا لا يُسمع لهم صوت، وجلادون تُبرَّر جرائمهم باسم المصالح، والاستقرار، ومحاربة الفوضى. هذا الوعي لم يكن نظريًا، بل تشكّل عبر صور حية ظلت تطرق الوجدان المصري والعربي بلا انقطاع.
منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، دخلت فلسطين الوعي المصري بوصفها معيارًا أخلاقيًا قبل أن تكون قضية سياسية. لم تكن فلسطين مجرد ملف خارجي، بل كانت المرآة التي رأى فيها المصريون معنى الظلم الدولي العاري: أرض تُغتصب، شعب يُشرّد، وقرارات دولية تُكتب ثم تُدفن. هذا الإحساس لم يغب يومًا، بل انتقل عبر الأجيال، وتحوّل إلى جزء من تعريف الذات. في ميدان التحرير، لم يكن رفع العلم الفلسطيني تفصيلًا عاطفيًا أو مجاملة رمزية، بل إعلان انتماء واعٍ إلى معسكر المظلومين في هذا العالم. كثيرون كانوا يهتفون لفلسطين لأنهم رأوا فيها صورتهم المؤجلة، ولأنهم أدركوا أن من يُسكت صوته في القاهرة، يُسكت صوته في غزة أيضًا.
ثم جاءت هزيمة يونيو 1967 لتُحدث زلزالًا أخلاقيًا ومعرفيًا. لم تكن الهزيمة عسكرية فقط، بل كانت سقوطًا للرواية الرسمية التي ادعت القوة والإنجاز، ثم انهارت في أيام. الإعلام الذي كذب، والقيادة التي أخفت الحقيقة، والشعب الذي اكتشف أنه كان يعيش داخل سردية مصنوعة، كلها عناصر تركت جرحًا عميقًا في الوعي الجمعي. هذا الجرح لم يندمل، بل تحوّل إلى شك دائم في الخطاب الرسمي، وإلى حساسية مفرطة تجاه الكذب باسم الوطنية. في يناير، كان هذا الدرس حاضرًا بقوة: لا نصدق ما يُقال لنا، ولا نطمئن إلى السلطة حين تحتكر الحقيقة.
حرب أكتوبر 1973 أعادت بعض الاعتبار للكرامة العسكرية، لكنها في الوقت ذاته فتحت مسارًا آخر للاحتكار السياسي. النصر تحوّل تدريجيًا إلى رصيد للسلطة لا للشعب، ثم جاءت كامب ديفيد لتُكمل القطيعة بين الدولة ومحيطها الشعبي والعربي. خروج مصر من الصراع، وتحولها إلى حليف استراتيجي للغرب، لم يُقرأ شعبيًا بوصفه خيار سلام فقط، بل بوصفه إعادة تموضع أخلاقي وسياسي. في وعي قطاعات واسعة، ارتبط السلام بالتبعية، وارتبطت التبعية بالقمع الداخلي. في الميدان، لم يكن الهتاف ضد التبعية شعارًا أيديولوجيًا، بل تعبيرًا عن فهم بسيط: من يرهن قراره في الخارج، لا يتردد في كسر شعبه في الداخل.
الثورة الإيرانية عام 1979، رغم اختلاف السياق الثقافي والمذهبي، لعبت دورًا نفسيًا مهمًا في المخيال العام. لأول مرة يرى الناس نظامًا مدعومًا دوليًا يسقط بفعل الشارع. لم تكن الرسالة سياسية بقدر ما كانت وجودية: الطغيان ليس قدرًا، والأنظمة التي تبدو أبدية يمكن أن تنهار. فكرة “الإمكان” هذه – فكرة أن ما يبدو مستحيلًا قد يحدث – ظلت تتراكم في الوعي العربي، حتى انفجرت في تونس ثم في مصر.
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كان لحظة فاصلة في تشكيل وعي جيل كامل. لم يكن مجرد حرب بعيدة، بل عرضًا حيًا لانهيار القانون الدولي. دولة تُحتل بذريعة كاذبة، جيش يُحل، مؤسسات تُدمَّر، ثم يُطلب من الشعوب أن تصدق خطاب “الديمقراطية” القادم على فوهة الدبابات. صور بغداد، وأبو غريب، وغوانتانامو، لم تُنتج فقط غضبًا، بل شكًا جذريًا في منظومة القيم العالمية التي تتحدث باسم حقوق الإنسان بينما تمارس نقيضها حين تتعارض مع مصالح القوة.
في تلك اللحظة، خرجت شوارع القاهرة في مظاهرات غير مسبوقة منذ عقود. لم تكن تلك المظاهرات انتصارًا سياسيًا، لكنها كانت تدريبًا نفسيًا وجماعيًا. الناس تعلّموا أن الشارع ممكن، وأن الهتاف ليس جريمة، وأن الخوف يمكن كسره. هذه الخبرة ستعود بقوة في يناير. كثيرون ممن نزلوا في 2011 كانوا قد ذاقوا طعم التظاهر لأول مرة وهم يهتفون ضد حرب خارجية، فاكتشفوا أن القبضة الأمنية ليست مطلقة.
الانتفاضات الفلسطينية، ثم الحرب على غزة 2008 – 2009، كانت حاضرة بقوة في الوعي الميداني. غزة لم تكن مجرد جغرافيا محاصرة، بل رمزًا عالميًا للخذلان. في ميدان التحرير، كان الغضب على النظام المصري مرتبطًا مباشرة بدوره في الحصار. كثيرون رأوا – بوعي فطري – أن من يغلق معبر رفح قادر على إغلاق المجال السياسي في الداخل، وأن من يبرر القتل هناك يبرر القمع هنا. هكذا تداخل المحلي والاقليمي والعالمي في وعي واحد لا ينفصل.
الإعلام العابر للحدود لعب دورًا حاسمًا في بناء هذا الوعي. لأول مرة، لم يعد الإعلام الرسمي هو المصدر الوحيد. الناس رأوا الحقيقة بعيون أخرى، وسمعوا روايات مختلفة، وقارنوا بين ما يحدث في العالم وما يُقال لهم في الداخل. هذا كسر احتكار السرد، وحرر الخيال السياسي. حين كُسرت الرواية الرسمية خارجيًا، أصبح كسرها داخليًا مسألة وقت.
ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، لتكشف هشاشة النموذج النيوليبرالي الذي كان يُسوّق في مصر بوصفه قصة نجاح. حين انهارت الأسواق العالمية، بينما كان الفقراء في مصر يزدادون فقرًا، اتضح أن المشكلة ليست محلية فقط، بل بنيوية. النظام الذي يكرر وصفات الخارج دون حماية مجتمعه، لا ينتج إلا غضبًا مؤجلًا. في الميدان، كان الوعي بالعدالة الاجتماعية مرتبطًا مباشرة بهذا السياق العالمي، لا مجرد احتجاج على فساد محلي.
لكن اللحظة الفاصلة جاءت من تونس. الثورة التونسية لم تكن مجرد إلهام، بل كسرًا نفسيًا شاملًا. سقط رئيس عربي بفعل الشارع، لا بانقلاب ولا بتدخل خارجي. فجأة، كل ما قيل لنا إنه مستحيل صار واقعًا. في الميدان، كان اسم تونس يُذكر كما يُذكر اسم مصر، وكأن الثورة انتقلت بلا جواز سفر. هنا، أدرك الناس أن التاريخ يمكن أن يُكتب من الأسفل.
في يناير، كانت كل هذه الوقائع حاضرة. الشعارات لم تكن عشوائية. “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” كانت ترجمة محلية لوعي إنساني عالمي بالظلم. “ارفع راسك فوق أنت مصري” لم تكن نشوة وطنية فقط، بل استعادة كرامة مسلوبة في عالم يحتقر الضعفاء. حتى الهتافات ضد أمريكا وإسرائيل لم تكن انحرافًا عن مسار الثورة، بل جزءًا من تعريفها الأخلاقي: ثورة على منظومة قمع داخلية متحالفة مع نظام دولي جائر.
وما بعد يناير لم يُلغِ هذا الوعي، بل كشف صعوبته. حين تعثرت التجربة، وحين عاد القمع بأشكال أشد، أدرك كثيرون أن المشكلة أعمق من نظام واحد. الدولة العميقة، والتحالفات الدولية، والخوف من الحرية، كلها تداخلت لإجهاض الحلم. لكن هذا لا ينفي أن يناير فتحت نافذة تاريخية نادرة، جعلت جيلًا كاملًا يرى نفسه جزءًا من العالم، لا مجرد تابع له.
في شهادتي، أقول إن يناير لم تكن فقط ثورة على الاستبداد المحلي، بل احتجاجًا أخلاقيًا على نظام عالمي يُكافئ الطغاة ويعاقب الشعوب. ولهذا بقيت حيّة في الذاكرة رغم الهزيمة المؤقتة. فالثورات لا تُقاس فقط بنتائجها المباشرة، بل بما تزرعه في الوعي. ويناير زرعت وعيًا لا يُمحى بسهولة: أن الكرامة لا تتجزأ، وأن الحرية محلية وعالمية في آن واحد.
من هنا، فإن استعادة يناير لا تعني تكرار المشهد، بل استعادة هذا الوعي المركب: وعي بأن معركتنا ليست مع سلطة فقط، بل مع سردية، ومع خوف، ومع نظام عالمي لا يرى فينا إلا هوامش. وحين يعود الميدان يومًا، سيعود وهو يحمل هذه الذاكرة كاملة، لا بوصفها عبئًا، بل بوصفها خبرة.
هكذا، لم تكن يناير حدثًا مصريًا فقط، بل لحظة إنسانية مرّت من القاهرة، وستمر – بصيغ أخرى – من أماكن أخرى. وما شهدناه لم يكن نهاية التاريخ، بل بداية وعي جديد، لم يكتمل بعد، لكنه لم يمت.