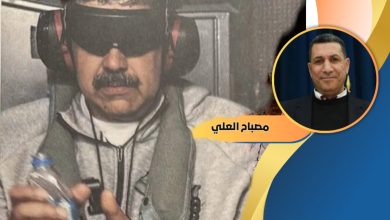حين تنقلب الظروف الإقليمية وتسقط مشاريع الوكالة
ما أبقى نظام بشار الأسد في الحكم لأكثر من عقد بعد اندلاع الثورة السورية لم يكن قوة النظام، ولا شعبيته، ولا تماسكه الداخلي.
فنظام أقلية حكم سوريا بالحديد والنار لما يقارب ستة عقود لم يكن يملك يومًا قاعدة شعبية حقيقية. الذي أبقاه قائمًا هو شبكة معقدة من الظروف الإقليمية وتقاطعات المصالح الدولية، حيث رأت قوى كبرى وإقليمية أن سقوط النظام في ذلك التوقيت يمثل خسارة استراتيجية لها، أو تهديدًا لتوازنات قائمة، فتمت حمايته، ولو بشكل تصادمي وغير مستقر.
هذا المشهد تكرر، ولكن بصورة معكوسة، في عام 2024.
لم يسقط بشار لأن المعارضة امتلكت فجأة سلاحًا خارقًا، ولا لأن قدراتها العسكرية بلغت مستوى استثنائيًا غير مسبوق، رغم تراكم خبراتها وتماسك بعض قياداتها. ما أسقط النظام فعليًا هو انقلاب البيئة الإقليمية ضده.
طوفان الأقصى وما تبعه من ارتدادات عنيفة فجّر تناقضات كامنة، وفتح صدامًا مباشرًا بين إيران وإسرائيل.
وهو الصدام الذي أنهى عمليًا مظلة الحماية غير المعلنة التي كانت توفرها تلك التوازنات للنظام السوري. وعندما تغيرت المصالح، استثمر الفاعلون الجاهزون على الأرض اللحظة، ونسجوا التفاهمات الدولية اللازمة، فتقاطعت للمرة الأولى مصالح دولية مع هدف إسقاط النظام، فسقط.
هذا النموذج يقترب اليوم، وبشكل متسارع، من حالة خليفة حفتر في ليبيا.
حفتر لم يكن ليصمد ساعة واحدة أمام رجالات ليبيا في بداية التمرد، ولم يكن ليستمر عقدًا كاملًا لولا الدعم الإقليمي والدولي الكثيف، والرهان عليه كأداة لضبط ليبيا بالقوة، أو إعادة تشكيلها وفق مشاريع خارجية. بقاؤه لم يكن تعبيرًا عن قوة ذاتية، بل عن ظرف إقليمي خدمه.
لكن جوهر الحديث أن هذه الظروف بدأت تتغير.
بل إن بيئة مشروع حفتر الإقليمية تتعرض اليوم لهزّات عميقة قد لا تنجو منها. حلفاؤه الأساسيون باتوا في حالة تصادم استراتيجي مفتوح: السعودية ومصر، اللتان شكلتا ركيزتين في دعم مشروع حفتر، دخلتا في مسار تصادمي متصاعد مع إسرائيل والإمارات، وهما أيضًا من أعمدة مشروعه.
هذا التصادم لا يمكن أن يمر دون أن يهز مشاريع الوكالة في المنطقة.
وعلى رأسها مشروع حفتر في ليبيا.
السعودية، على نحو خاص، انتقلت من سياسة الاحتواء إلى سياسة كسر المسار.
وتحركت عسكريًا وسياسيًا لوقف نزيف التفتيت في المنطقة، ومنع ولادة كيانات انفصالية جديدة. ويبدو أن مصر، رغم حذرها، بدأت تدرك خطورة اللحظة، ولو بتحرك خجول حتى الآن.
في المقابل، بلغ التصعيد الإماراتي–الإسرائيلي ذروته.
تحريك الجنوب اليمني، تغذية مذابح الفاشر عبر حميدتي، والاعتراف بصومال لاند ككيان انفصالي. في هذا المشهد، يقف حفتر في قلب العاصفة.
ويزداد مأزق حفتر تعقيدًا مع السؤال الروسي المفتوح.
فكيف سيدير علاقته مع موسكو، صاحبة القواعد والفيالق والأجندة المتشابكة في ليبيا والقرن الإفريقي، في لحظة قد تتقاطع فيها المصالح الروسية مع السعودية، أو تنسجم تكتيكيًا مع إسرائيل وفق منطق الصفقات لا التحالفات الثابتة؟
وأين يقف حفتر من تركيا، التي باتت لاعبًا حاسمًا في معادلة الإقليم؟
ولم يعد دورها مقتصرًا على ليبيا، بل يتداخل بشكل مباشر في السودان دعمًا للحكومة الشرعية ضد حميدتي، الحليف الميداني الأهم لحفتر؟
ثم ماذا عن البيت الأبيض نفسه، العالق بين السعودية والإمارات؟
والمقيد أكثر بمزاجيات ترامب المتقلبة وحسابات دائرته الضيقة التي تقدم المنفعة المادية على الاستثمارات السياسية طويلة الأمد؟
في هذا السياق، يصبح سؤال الجدوى مطروحًا بحدة.
هل لا يزال حفتر مشروعًا يستحق المزيد من الاستثمار، أم أنه عبء يتآكل في لحظة إعادة تشكيل كبرى للنظام الإقليمي؟
داخليًا، لا تبدو صورة حفتر أفضل حالًا.
وضعه الصحي غير المستقر، والصراع المتصاعد بين أبنائه على النفوذ والموارد، وحالة التذمر الشعبي المتزايدة في الشرق، والتي تجلت بوضوح في عزوف الناس عن تفويضه، كلها مؤشرات على تآكل القاعدة الداخلية.
مشروع يقوم على القمع، والارتهان الخارجي، وغياب الأفق السياسي، لا ينجو عندما تتغير الرياح الإقليمية.
حفتر اليوم عالق بين وكلاء يتصارعون، ومشاريع تتفكك، وبيئة دولية لم تعد ترى فيه استثمارًا مضمونًا.
تمامًا كما كان بشار في لحظاته الأخيرة، حين اكتشف أن الحماية ليست أبدية، وأن الأنظمة لا تسقط فقط بالسلاح، بل بسقوط الظروف التي تحميها.
يبقى السؤال الأهم: هل تعي طرابلس هذه اللحظة التاريخية؟
وهل تملك القدرة على تقديم بديل وطني جامع لبرقة وفزان، يطمئن الداخل الليبي، ويقنع العالم بأن ليبيا الموحدة ممكنة، ومستقرة، ومن دون حفتر؟
أم أن الفرصة ستضيع مرة أخرى؟
ويُترك الشرق والجنوب رهينة لانهيار مشروع، بدل أن يكونا جزءًا من حل وطني شامل؟
ما هو مؤكد أن لعبة الشطرنج الكبرى دخلت مرحلة كسر العظام.
وحفتر ليس لاعبًا فيها… بل قطعة مرشحة للسحق.