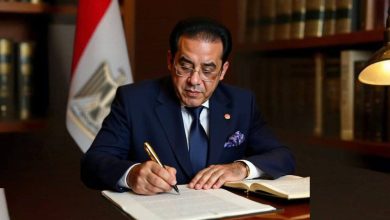غيرُ واحدٍ سألني، بدهشةٍ لا تخلو من حسن نية: لماذا تُولي هذا الاهتمام بالشأن الوفدي، وهو — في نظر البعض — شأنٌ يخص حزبًا ٱخر غادرته منذ ربع قرن؟ لم أتوقف طويلًا عند مثل هذا السؤال، ولا شغلتني الإجابة عليه، إلى أن عثرتُ، بالأمس فقط، على عددٍ نادر من مجلةٍ لا أظن أن كثيرين سمعوا بها من قبل، اسمها: «مسامرات الحبيب».
عددٌ رقيم، بالرقم (٩٠)، وصدر في الثلاثين من مارس عام ١٩٤٧، أي قبل ما يقرب من ثمانين عامًا، يتصدره مقالٌ للصحفي المناضل أبو الخير نجيب، بعنوانٍ: «الوفد يقرر الاكتتاب العام للقضية الفلسطينية ويهدد بالانسحاب من مجلس الشيوخ».
دعوتُ من حولي إلى تكبير صورة المقال، وقراءة ما تيسر منه، خاصة فقرته الأولى، التي قال فيها، منذ السطر الأول، كلماتٍ لو كُتبت اليوم لظنها البعض بيانًا مني أجيب به علي ذلك السؤال فقط. قال المقال:
«الوفد المصري هو ابن الثورة، فهو إذن ملكٌ للمصريين جميعًا، وليس ملكًا لمصطفى النحاس، أو صبري أبو علم، أو نجيب الهلالي، أو فؤاد سراج الدين. فنحن حين نفزع من هول الخطر الذي يحيق بالوفد، فإنما نؤدي واجبًا وطنيًا لا مهرب منه ولا محيص عنه».
أحسب أن هذه الفقرة، وعمرها ثمانون عامًا، تُجيب وحدها عن السؤال، الذي يطرحه — غالبًا بحسن قصد — من لا يعرفون كثيرًا عن الوفد، وربما لا يعرفون من هو أبو الخير نجيب.
أبو الخير نجيب لم يأتِ إلى الصحافة زائرًا، بل دخلها مقيمًا. عرفها ساحة معركة، لا منصة شهرة. كتب وهو يعلم أن الكلمة قد تُكلف صاحبها عمرًا، فدفع عمره كاملًا دون تردد.
لم يسأل يومًا: ماذا سأخسر؟ بل سأل السؤال الأخطر: ماذا سيخسر الوطن إن صمتُّ؟ فاختار الضجيج النبيل للكلمة، وجعل من القلم موقفًا.
في السادس من يناير عام ١٩٤٨، كتب مقاله الأسبوعي الشهير «التيجان الهاوية»، تعليقًا على خبرٍ نشرته الأهرام عن تنازل ملك رومانيا عن العرش. لم يكن المقال سبًّا ولا قذفًا، بل مرآة. والسلطة، في كل العصور، تخاف المرايا أكثر مما تخاف السباب.
وجّه أبو الخير نجيب رسالته مباشرة إلى الملك فاروق، وقال بوضوحٍ لا يعرف الالتواء: إن الملك حين يهبط بنفسه إلى معترك السياسة، ويُقحم ذاته فيما ليس من اختصاصه، يفقد الحصانة، ويصبح رجلًا عاديًا يُحاسَب كما يُحاسَب رجل السياسة ورجل الشارع سواءً بسواء.
اهتزت الجهات المسؤولة، وعلى رأسها القصر. صودرت نسخ جريدة «النداء»، واستُدعي الكاتب، وعُرض على نيابة الصحافة، وسُجن.
أفرج القضاء عنه، لكن السلطة أبقته خلف القضبان، حتى تدخل النقراشي باشا، وهدد وزير العدل بالاستقالة، فخرج أبو الخير… ليعود فورًا إلى قلمه، ويُصدر جريدة «الجمهور المصري».
ثم جاءت يوليو ١٩٥٢، فجاء الامتحان أقسى. واصل هجومه على الفساد، وطالب بحرية الصحافة وسيادة القانون.
وحين انفجرت أزمة مارس بين محمد نجيب والضباط الأحرار، كتب مقاله الأشهر «النسور الهاوية»، مطالبًا بعودة العسكريين إلى ثكناتهم، وترك الحكم للشعب.
كانت الكلمة هذه المرة أغلى من العمر. قُدِّم إلى محكمة عسكرية، واتُّهم بالخيانة. صدر حكم بالإعدام، ثم خُفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والتجريد من شرف المواطنة.
تسعة عشر عامًا كاملة في السجن، لا تُختصر في رقم، بل تُقرأ كسيرة نضال مكتوبة بالصبر. لا يعرف معناها إلا من ذاق مرارات السجون والمنافسة بين الجدران.
لم تتصالح روحه مع الصمت. بقي القلم حاضرًا، حتى وهو غائب. وبقيت الفكرة تمشي وحدها بين القطبان.
بعد ١٩ عامًا خرج بإفراج صحي بأمر من السادات، منهك الجسد، صافي اليقين. لم يبدّل قناعاته، ولم يخفف لغته. كأن السجن علّمه كيف يكتب أشد… وأعمق.
لذا… جاءت النهاية صادمة. حادث سيارة أمام باب نقابة الصحفيين. كأن القدر أراد أن يضع الخاتمة عند عتبة المهنة التي عاش لها، ومات في ظلّها، ليظل دمه هناك شاهدًا على الدور الحقيقي للصحفي الحر.
وهنا أعود إلى أصل الحكاية: لماذا كتب أبو الخير نجيب عن الوفد ما كتب؟ لأن الوفد عنده لم يكن حزبًا، بل وطنًا. معنىً عامًا، وابن الثورة، ولسان الناس، وبيت التعدد. لا الإقصاء.
لم يره «شأنًا داخليًا»، بل فكرة. والفكرة العامة لا تُخصخص، ولا تُدار بلوائح ولا ببطاقات جمعية عمومية.
حذّر من تمزيق الوفد إلى أسماء، وقالها بوضوحٍ جارح: حين ينكسر الوفد، لا ينكسر تنظيم، بل تختل كفة الوطنية المدنية في مصر.
دعا إلى الوحدة لا الصخب، وإلى المجلس الجامع لا المعارك الجانبية. كان يعرف أن التشرذم قوة زائفة، وأن الخصم الحقيقي ينتظر دائمًا لحظة الغياب الأخلاقي.
فلسطين عنده لم تكن بندًا خارجيًا، بل امتحان ضمير. معيارًا صافيًا للموقف. وكان يرى أن الوفد الأصيل ينحاز بلا مواربة لحقٍ واضح، ورايةٍ لا تُطوى.
لذلك بدا الغياب الأخير للوفد في أحداث غزه موجعًا. ليس غياب بيانات، بل غياب صوتٍ أخلاقي كان يجعل من الوفد ضميرًا عامًا للأمة.
كتب أبو الخير نجيب ليقول — قبل ثمانين عامًا — إن من يقبل الظلم بعيدًا سيذوقه قريبًا، ومن يساوم على الحق يفقد حقه في الكلام. جملٌ أهديها اليوم لمن يتسابقون على رئاسة الضمير.
نعيد قراءة مقاله اليوم لا حنينًا، بل استعادة بوصلة. نقرأه لنعرف أن القلم قد يكون وطنًا، وأن الوفد كان فكرة، وأن فلسطين كانت — وما زالت — معيار الضمير.
أبو الخير نجيب وجهٌ لا يغيب. لأن من عاش للكلمة، ودفع عمره ثمنًا لها، ومات عند باب النقابة، لا يغادر الذاكرة… أبدًا.