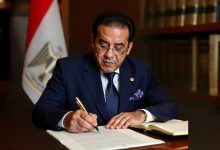في التاريخ السوري السحيق، لم تكن حلب يوماً مدينة هامشية أو تابعًا لدمشق، بل كانت – ولا تزال – عقدة جغرافيا وسياسة، لا تقل أهمية عن العاصمة نفسها. حلب، كما الموصل في العراق، شكّلت الامتداد الطبيعي للواء الإسكندرون، ذلك اللواء الذي تنازلت عنه فرنسا لصالح مصطفى كمال أتاتورك في لحظة إعادة رسم خرائط المنطقة، تحت ضغط توازنات ما بعد الحرب العالمية الأولى. لم يكن ذلك التنازل تفصيلاً إدارياً، بل بتراً جيوسياسياً ما زالت تداعياته حاضرة في الوعي السوري والواقع الإقليمي.
من هنا، لا يبدو تفصيلاً أن تنطلق معركة احتلال رأس السلطة من حلب، ولا أن تبقى المدينة ساحة اختبار لأي مشروع حكم أو إعادة تركيب للسلطة في سوريا. فحلب ليست مجرد مدينة كبرى، بل بوابة الشمال، ومفتاح الأناضول، وميزان القوى بين الداخل السوري والخارج الإقليمي.
في المقلب الآخر من المشهد، تبرز إشكالية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بوصفها فصيلاً عسكرياً نشأ من رحم الحرب، وبلغ ذروة حضوره حين هزم تنظيم «داعش»، ليُسدل الستار عسكرياً على مشروع «الدولة الإسلامية»، ويعيد سوريا – نظرياً – إلى حدودها الطبيعية. غير أن هزيمة «داعش» لم تعنِ ولادة مشروع سياسي متكامل، بل خلّفت فراغاً أكبر مما أُعلن عنه.
قسد، في جوهرها، وُلدت كضرورة عسكرية لا كمشروع دولة. قوة منظمة، ذات انضباط عالٍ، مدعومة أمريكياً، لكنها تفتقر إلى الاعتراف السيادي الكامل، وتعيش تناقضاً بنيوياً بين ما تمثله على الأرض، وما يُسمح لها أن تكونه سياسياً. فهي ليست دولة، ولا قوة عسكرية عابرة، بل كيان متأرجح بين الوظيفية العسكرية والطموح السياسي غير المكتمل.
هذا التعليق البنيوي يضع قسد في مواجهة مفتوحة – وإن مؤجلة – مع السلطة المركزية في دمشق. فالنظام القائم في دمشق حالياً خارج هيكليته، لا يستطيع القبول بوجود قوة مسلحة خارج سلطته، لكنه في الوقت نفسه ليس في وارد خوض مواجهة شاملة معها دون ضوء أخضر دولي. أما قسد، فتدرك أن أقصى ما يمكنها انتزاعه، في أفضل السيناريوهات، هو حكم ذاتي منقوص، لا يرقى إلى كيان مستقل، ولا يحظى بإجماع داخلي أو إقليمي.
بين الطرفين، تبقى مناطق التماس، وعلى رأسها الشيخ مقصود في حلب، بمثابة فم التنين. فهي ليست حياً سكنياً فحسب، بل رمز احتكاك قومي وسياسي: تماس كردي–عربي، قرب مباشر من مركز حضري حساس، وضغط أمني دائم يجعلها قابلة للاشتعال عند أول خطأ أو تبدّل في موازين القوى. أي انفجار في هذه البقعة لن يبقى محلياً، بل سيتدحرج على امتداد الشمال السوري.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد دون التوقف عند الدور التركي، بوصفه العامل الأكثر حساسية. أنقرة لا تنظر إلى قسد كقوة سورية محلية، بل كامتداد مباشر لحزب العمال الكردستاني، وتهديد استراتيجي لأمنها القومي. لذلك، فهي لا ترى في الشمال السوري مسألة حدود فحسب، بل مسألة وجود. ومن هنا، يصعب تصور قبول تركي بأي صيغة استقرار طويل الأمد تمنح قسد شرعية أو استمرارية، حتى لو كان ذلك تحت مسمى «إدارة ذاتية».
في المقابل، يبدو النفوذ الأمريكي أقرب إلى إدارة الأزمة منه إلى حلها. الولايات المتحدة لا تريد عودة «داعش»، ولا ترغب في صدام مباشر مع تركيا، ولا تسعى إلى تمكين دمشق بالكامل، وفي الوقت نفسه لا تبدو مستعدة لتحويل قسد إلى حليف استراتيجي دائم. إنها سياسة الإمساك بالعصا من منتصفها: إبقاء التناقضات حيّة، ومنع انفجارها الكبير، دون الذهاب نحو تسوية نهائية.
في ضوء ذلك كله، يبدو مصير الشمال السوري معلّقاً بين ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأرجح هو استمرار الوضع القائم: قسد كقوة أمر واقع، حكم ذاتي غير معلن، توتر دائم مع دمشق، ضغط تركي مستمر، واستقرار هش قابل للانهيار. السيناريو الأسوأ يتمثل في انسحاب أمريكي مفاجئ يفتح الباب أمام تدخل تركي واسع أو صدام دموي مع النظام، بما قد يؤدي إلى تفكك قسد وانزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة. أما السيناريو الأقل احتمالًا، فيبقى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى اعتراف دستوري محدود بالإدارة الذاتية، ضمن تفاهمات دولية متزامنة، وهي إرادة لا تبدو متوفرة حتى اللحظة.
خلاصة القول إن الشمال السوري لا يسير نحو الحل، بل نحو إدارة الفوضى. قسد ليست قوية بما يكفي لتصبح دولة، ولا ضعيفة بما يكفي لتُكسر سريعاً. وحلب ستبقى، كما كانت عبر التاريخ، الميزان الذي يميل حيث تميل القوى الكبرى. أما السؤال المفتوح، فهو ليس متى تُحل عقدة الشمال، بل إلى متى يبقى معلقًا في منطقة الرماد بين الحرب والسلام.