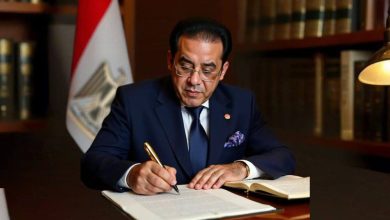لم يكن البرلمان المصري يومًا مجرد قاعة تُرفع فيها الأيادي، ولا منصة لتصفيقٍ مُعدّ سلفًا، بل كان ـ في لحظاته المضيئة ـ ضمير الأمة ولسان حالها، وساحة اشتباك فكري وسياسي حقيقي بين السلطة والمجتمع.
غير أنّ ما نراه اليوم يفرض سؤالًا موجعًا: هل ما نُسميه برلمانًا هو امتداد لتاريخ نيابي عريق، أم مجرد صوبة سياسية تُزرع فيها نباتات مُهجنة لا تعرف التربة ولا المواسم؟
إنّ تشكيل البرلمان الحالي لا يمكن فصله عن آلية اختيارٍ قامت في جوهرها على الوراثة السياسية، والوجاهة العائلية، والانتماء لكيانات مصطنعة صُنعت على عجل، أو على دعمٍ مباشر وغير مباشر من جهات سيادية، لا ترى في النائب ممثلًا للأمة، بل أداةً لضبط الإيقاع وامتصاص الغضب. هكذا لم تُصغ القوائم على أساس الكفاءة أو التاريخ العام أو القدرة على التشريع والرقابة، بل على معيار “الضمان” و”الطاعة” و”السلامة السياسية”.
وحين نعود إلى التاريخ النيابي المصري، ندرك حجم الفجوة. فمنذ دستور 1923، عرفت مصر مجالس نيابية كانت بحق مدارس في السياسة، خرج منها رجال دولة لا موظفون في السياسة، مجالس ناقشت، واشتَبكت، وأسقطت حكومات، وفرضت احترامها على القصر والاحتلال معًا. لم يكن النائب ديكورًا، بل كان موقفًا.
مررنا ببرلمانات عظيمة، وصولًا إلى برلمان 2005، الذي ـ رغم كل ما شابه ـ شهد أصواتًا حقيقية أربكت السلطة، وفرضت نفسها على الشارع والرأي العام.
نواب من طراز علوي حافظ، صاحب الكلمة الصلبة والموقف الذي لا يلين، وممتاز نصار، الذي جعل من البرلمان منبرًا للدفاع عن القانون والحقوق، وغيرهم ممن كانوا يدخلون القاعة وهم يعلمون أن ثمن الكلمة قد يكون الإقصاء أو التضييق، لكنهم قالوها.
اليوم، يكفي لقاء تليفزيوني واحد مع أحد رموز تلك المدرسة القديمة، حتى ينكشف المستور، وتُرفع الستارة عن الفارق بين نائب صُنعته التجربة والمعاناة، ونائب صُنعته القوائم المغلقة وغرف الاختيار، لقاء واحد يُظهر كيف تحوّل البرلمان من ساحة مساءلة إلى مساحة تبرير، ومن مؤسسة رقابية إلى كيان يتلقى التعليمات وينفذها.
نحن أمام برلمان جُرى تصميم تكوينه بعناية ليكون ضعيفًا نسبيًا، بلا أنياب تشريعية حقيقية، وبلا شهية للرقابة، وبرغبة محدودة في الصدام أو حتى السؤال، برلمان يعرف حدوده جيدًا، ويتحرك داخل هوامش مرسومة سلفًا، فلا يُغضب، ولا يُفاجئ، ولا يُقلق.
وهنا تكمن الخطورة؛ فالدولة التي تُضعف برلمانها بيدها، إنما تُضعف نفسها على المدى البعيد، لأن البرلمان ليس عبئًا على السلطة، بل صمام أمانها، وعندما يتحول إلى صوبة سياسية، تُزرع فيها نباتات متشابهة، بلا جذور ولا تنوع، فإن أول عاصفة حقيقية ستُسقطها جميعًا.
إنّ استمرار هذا النموذج لا يُنذر فقط ببرلمان بلا روح، بل بدولة تفقد واحدة من أهم أدوات توازنها، والتاريخ لا يرحم من تجاهل دروسه، فإما أن نعيد للبرلمان معناه، ولفكرة النيابة قدسيتها، أو نُفيق يومًا على فراغٍ سياسي لا تُجدي معه كل أدوات السيطرة.
والتحذير هنا ليس ترفًا فكريًا، بل إنذار أخير:
الدول لا تسقط حين تعلو أصوات المعارضة، بل حين تختفي.. وحين يُصنع برلمان على مقاس الصمت، يكون الخطر أقرب مما نتصور.