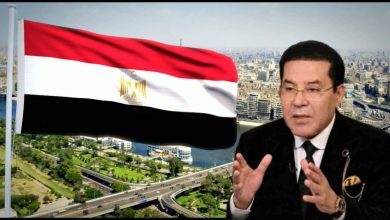لم تكن الكلمات عندها تُكتب لتُقال، بل لتُحاسِب. كانت الجملة تخرج من قلمها كأنها تعرّي الصمت، وتضعه في قفص الاتهام. لم تعرف سيزا نبراوي رفاهية الحياد، لأن الحياد — في زمن الظلم — موقف منحاز سلفًا. كانت ترى أن القلم إذا لم يتحوّل إلى ضمير، صار زينة لغوية لا أكثر.
وُلدت سيزا نبراوي عام 1897 في القاهرة، في لحظةٍ كانت المدينة فيها تتبدّل على مهل. تفتح نوافذ التعليم، لكنها تُبقي أبواب القرار موصدة. نشأت في بيتٍ يعرف قيمة المعرفة، غير أن المعرفة نفسها لم تكن كافية لتمنح المرأة حق السؤال العلني. هناك، تعلّمت سيزا أن الوعي إذا لم يُدافع عنه يتحوّل إلى عبء على صاحبه.
دخلت عالم الصحافة مبكرًا، لا بوصفها هاوية، بل بوصفها صاحبة موقف. لم تكن المقالة عندها مساحة استعراض، بل ساحة مساءلة. كانت ترى أن الصحافة ليست مهنة محايدة، وأن القلم — إن لم يُستخدم لكشف الحقيقة — سيُستخدم يومًا لتزييفها.
انخرطت في الحركة النسائية المصرية، لكن انخراطها لم يكن خطابيًا. لم تحب المنصّات، ولا أغرتها الشعارات. آمنت بالتنظيم، وبالعمل اليومي الصامت، وببناء المؤسسات القادرة على الاستمرار. كانت ترى أن التغيير الذي لا يستند إلى بنية صلبة ينهار عند أول اختبار.
شاركت في تأسيس الاتحاد النسائي، وربطت بين قضية المرأة وقضية الوطن ربطًا لا يقبل الفصل. لم ترَ المرأة ملفًا جانبيًا، بل مكوّنًا أساسيًا في أي مشروع تحرّر. الوطن الذي يُقصي نصفه، في نظرها، وطن يعيش بنصف طاقته، مهما علا صوته.
في كتاباتها، لم تلجأ إلى اللغة الحادة، لكنها لجأت إلى اللغة الدقيقة. الدقة عندها كانت سلاحًا أخطر من الصراخ. كانت تعرف أن العبارة حين تُصاغ بإحكام، تُغلق على الخصم منافذ الهروب، وتتركه أمام الحقيقة عاريًا بلا مبرّرات.
واجهت سيزا نبراوي مقاومة صامتة من المجتمع، ومقاومة صريحة من بعض دوائر السلطة. لم تُحارَب دائمًا بالمنع، بل بالتجاهل، وهو أشدّ أنواع الإقصاء قسوة. كانت ترى مقالاتها تمرّ أحيانًا بلا رد، وتُحاصَر أحيانًا أخرى بالسخرية. ومع ذلك، لم تتراجع، لأن التراجع في نظرها اعتراف ضمني بالهزيمة.
في حياتها الخاصة، دفعت سيزا ثمن الاستقلال كاملًا. لم تكن حياتها محاطة بالتصفيق، ولا ممهّدة بالطمأنينة. المرأة التي تختار طريق العمل العام تُطالَب بأن تكون أقوى من اللازم، وأن تُخفي تعبها كي لا يُحسب ضعفًا على الفكرة التي تحملها. ومع ذلك، لم تتخلَّ عن إنسانيتها، ولم تتقمّص دور الصلابة الزائفة.
سافرت، وشاركت في مؤتمرات دولية، وقدّمت صورة امرأة مصرية تعرف لغتها، وتعرف حدودها. لكنها لا تقبل أن تُحبَس داخلها. لم ترَ تناقضًا بين الانتماء والكونية، ولا بين الخصوصية والحق العام. كانت ترى أن الهوية القوية هي التي تتحاور، لا التي تنغلق.
مع مرور السنوات، تراجع الضوء وبقي الأثر. لم تتحوّل سيزا نبراوي إلى أيقونة شعبية، ولم تُقدَّم كبطلة جاهزة، لكنها تركت بصمة عميقة في بنية العمل النسوي المنظّم، وفي فكرة أن القلم يمكن أن يكون موقفًا أخلاقيًا لا يقل صلابة عن أي فعل سياسي.
رحلت سيزا نبراوي عام 1985، بعد عمرٍ طويل من العمل الصامت. لم ترَ كل ما حلمت به يتحقّق، لكنها رأت الطريق يُستكمَل. تركت خلفها درسًا بالغ الأهمية: أن التغيير الذي يُدار بعقل قد يتأخر، لكنه حين يصل يكون أرسخ وأصعب على الارتداد.
ليست كل البطولات صاخبة، وليست كل المعارك مرئية. بعض النساء يغيّرن العالم لأنهنّ أصررن على أن يكنّ حاضرات حين طُلب منهنّ الغياب، وعلى أن يكتبن حين كان الصمت أسهل وأضمن.
تبقى سيزا نبراوي واحدة من أولئك اللواتي لم يرفعن الصوت عاليًا. لكنهنّ أبقين المعنى قائمًا، وتركْن للقادمات طريقًا أقل وعورة، وإن لم يكن ممهدًا تمامًا. فالضمير — حين يُكتَب — لا يموت، حتى لو غاب صاحبه.