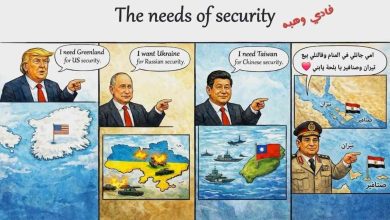قبل أن تبدأ الحكاية، دعني أضع القلم فوق الورق كمن يخطّ على صفحة عمرٍ شهد البرلمانات تتلوّن بألوان مصر وأزمانها. لقد عشتُ واحدًا وستين عامًا، كاتبًا ونائبًا، وكانت تجربتي مع البرلمان كمن يعانق نهرًا متدفقًا عبر العقود. أصغر النواب سنًّا في التسعينيات، ووريثٌ لوالدٍ كان هو الآخر أصغر النواب سنًّا في الخمسينيات. هذا المقعد لم يكن يومًا كرسيًّا جامدًا، بل روحًا تتنفس السياسة وتعكس تقلباتها.
منذ أن وُضع حجر الأساس لمجلس شورى النواب عام 1866، بدأ مقعد الرئيس يروي حكاية الدولة المصرية. تولى محمد شريف باشا الرئاسة (1866–1879)، وفي عهده كان المقعد أشبه بزهرة تنبت في تربة مشبعة بالتاريخ والتطلعات. ثم جاء سعد زغلول (1913–1914) ليحمل شعلة الأمة في الجمعية التشريعية، وتلاه دستور 1923 الذي جعل المقعد ساحة للتعددية مع ويصا واصف ومصطفى النحاس وفتح الله بركات. في تلك الأيام، كان البرلمان مرآة حقيقية لنبض الشعب.
بعد ثورة 1952، تغيّر وجه المقعد. أصبح مع عبد اللطيف البغدادي (1957–1958) وأنور السادات (1960–1968) أداةً لإدارة الإجماع أكثر منه منبرًا للحوار. وفي السبعينيات والثمانينيات مع سيد مرعي ورفعت المحجوب، ثم مع أحمد فتحي سرور (1990–2011)، صار المقعد مزيجًا من فقه القانون وروح السلطة.
والآن نأتي إلى هشام بدوي، الرجل الذي يمثل نموذجًا لمقعد يتنفس بتعليمات السلطة أكثر مما ينبض بروح المجتمع. بدأ هشام بدوي مسيرته في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرّج في المناصب حتى بات اسمه مرادفًا للتحقيقات في قضايا كبرى، من ملفات فساد نظام مبارك إلى قضايا حساسة أمنية وسياسية. كل خطوة في حياته المهنية كانت تضعه أقرب إلى دوائر السلطة. وهكذا، حين اعتلى مقعد رئاسة البرلمان، كان واضحًا أنه يجسّد مرحلة تُدار فيها السياسة من أعلى، لا من نبض الشعب.
في النهاية، يظل مقعد رئيس البرلمان في مصر علامةً لا تتغير: إذا ازدهرت السياسة، ازدهر المقعد، وإذا ضاقت السياسة، ضاق المقعد. مقعد هشام بدوي اليوم هو تفسير للمفسَّر: برلمان يُدار بإيقاع السلطة، لا بوجدان الناس.