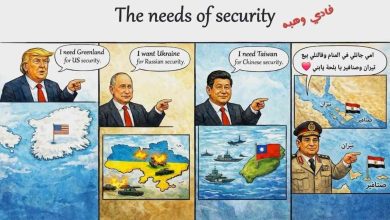كانت الكلمات عندها تمشي على أطراف الأصابع، لا خوفًا، بل احترامًا للعقل الذي تخاطبه. لم تكن تؤمن بأن الصراخ يُقنع، ولا بأن الحِدّة تصنع وعيًا. كانت ترى أن الفكرة — إذا قُدّمت بهدوءٍ صادق — تجد طريقها أبعد مما تفعل الضوضاء. هكذا اختارت أمينة السعيد أن تُغيّر العالم من الداخل، لا من فوق المنصات.
وُلدت أمينة السعيد عام 1914 في القاهرة، في بيتٍ يعرف قيمة التعليم، لكنه يعيش داخل مجتمع لا يمنح المرأة بسهولة حق الرأي العام. منذ طفولتها، كانت الكتب ملاذها، لا للهروب من الواقع، بل لفهمه. القراءة عندها لم تكن ترفًا، بل تدريبًا مبكرًا على ترتيب الأفكار، وعلى رؤية العالم بعيونٍ أقل انفعالًا وأكثر وعيًا.
حين دخلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت المساحة هناك مختلفة. النقاش مسموح، والسؤال غير مُدان، والاختلاف جزء من العملية التعليمية. في هذا المناخ، تشكّل وعي أمينة السعيد، وخرج عقلها من دائرة الإجابات الجاهزة إلى دائرة التفكير النقدي. تعلّمت أن الحقيقة ليست صلبة كما تبدو، وأن الوصول إليها يحتاج صبرًا لا يقل عن الشجاعة.
دخلت الصحافة لا بحثًا عن شهرة، بل إيمانًا بأن الكلمة يمكن أن تكون أداة إصلاح إذا أُحسن استخدامها. لم تكن المقالة عندها ساحة اشتباك، بل مساحة إقناع. كانت ترى أن القارئ ليس خصمًا، بل شريكًا، وأن احترام عقله هو الشرط الأول لأي تغيير مستدام.
ارتبط اسمها بدار الهلال، حيث تعلّمت أن الصحافة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنة. هناك، وسط أسماء كبيرة وتجارب طويلة، صقلت أسلوبها، ورفضت أن تتحوّل المقالة إلى منبر استعراض. كانت تُفضّل الجملة المتوازنة، والفكرة التي تُبنى حجرًا فوق حجر، على العبارة الصادمة التي تحرق نفسها سريعًا.
لم تكن أمينة السعيد بعيدة عن قضية المرأة، لكنها رفضت أن تُختزل فيها. كانت ترى أن المرأة إذا دخلت المجال العام بعقلٍ منضبط، تغيّر شكل المجال نفسه. كتبت عن التعليم، والعمل، والأسرة، والكرامة اليومية، دون أن تُخاصم المجتمع أو تُدين القيم، بل تحاول تحريرها من سوء الاستخدام.
في حياتها الخاصة، اختارت أمينة طريق الاستقلال. لم تتزوّج، ولم تُخفِ هذا الاختيار، ولم تُقدّمه بوصفه بطولة ولا تضحية. كانت ترى أن الزواج خيار، لا معيارًا للأخلاق ولا مقياسًا للنجاح. دفعت ثمن هذا الاختيار أسئلةً ونظراتٍ ووحدةً صامتة، لكنها لم تُساوم على حقها في أن تعيش حياتها كما تراها مناسبة.
الوحدة عند أمينة لم تكن انسحابًا، بل مساحة تفكير. كانت تعود إلى بيتها محمّلة بالأسئلة، وتكتب، وتعيد ترتيب الأفكار، وتستعد ليومٍ جديد من العمل الهادئ. لم تكن تطلب تصفيقًا، بل نتيجة، ولم تكن تُجيد لعب دور “الرمز”، لأنها كانت ترى أن الرمز قد يُريح الآخرين من واجبهم.
حين تولّت رئاسة تحرير مجلة «حواء»، لم تحوّل المنصب إلى منصة شخصية، بل إلى مساحة نقاش واسعة. فتحت المجلة لقضايا شائكة، وقدّمتها بلغة عقلانية، تعرف أن الصدام السريع قد يُغلق الأبواب، بينما الحوار المتدرّج يفتحها على مهل.
اتُّهمت أحيانًا بالهدوء الزائد، وبأنها تُهادن. لكنها كانت تعرف أن الهدوء ليس تنازلًا، بل اختيار. وأن العقل — حين يُحسن التوقيت — قد يهزم الصراخ. كانت ترى أن التغيير الحقيقي لا يُقاس بحدة الخطاب، بل بعمق الأثر الذي يتركه في الوعي.
مع مرور السنوات، تراجع الضوء وبقي المعنى. لم تتحوّل أمينة السعيد إلى أيقونة جماهيرية، لكنها بقيت مرجعًا مهنيًا وفكريًا. تركت أثرًا في فكرة أن الصحافة يمكن أن تكون ساحة إصلاح لا ساحة صراع، وأن المرأة قادرة على قيادة هذا الإصلاح دون أن تفقد توازنها.
رحلت أمينة السعيد عام 1995، بعد عمرٍ طويل من الكتابة والعمل الهادئ. لم ترَ كل ما حلمت به يتحقق، لكنها رأت مساحات تتسع، وحوارًا ينضج، ووجودًا نسائيًا في المجال العام صار أقل غرابة مما كان.
ليست كل الانتصارات سريعة، وليست كل المعارك صاخبة. بعض النساء يغيّرن العالم لأنهنّ اخترن أن يُفكّرن بصوتٍ منخفض، وأن يثقن بأن العقل — حين يصبر — يصل.
هكذا بقيت أمينة السعيد وجهًا لا يغيب، لا لأنها رفعت الصوت، بل لأنها رفعت مستوى الحوار، وتركته أعلى مما كان عليه.