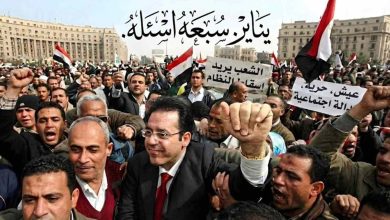كانت الكتابة عندها تشبه الوقوف في مهبّ الريح؛ لا ترفع راية، ولا تختبئ خلف جدار، لكنها تعرف أن الصمت في لحظة القهر مشاركة غير معلنة. لم تكن لطيفة الزيات تبحث عن بطولة، لكنها وجدت نفسها في قلب معركةٍ لم تخترها، معركةٍ بين العقل والسلطة، وبين الإنسان والخوف، وبين الكلمة وما يُراد لها أن تكونه.
وُلدت لطيفة الزيات عام 1923 في القاهرة، في مدينةٍ كانت السياسة فيها تُتعلَّم في الشوارع قبل أن تُدرَّس في الكتب. نشأت في بيتٍ يعرف قيمة التعليم، لكن الواقع من حولها كان يُحمّل المرأة دائمًا عبئًا إضافيًا: أن تكون واعية دون أن تُربك، ومثقفة دون أن تُزعج.
منذ سنواتها الأولى، أدركت لطيفة أن المعرفة ليست محايدة، وأن القراءة قد تكون بداية طريقٍ شائك. كانت ترى الاحتلال حاضرًا في تفاصيل الحياة، وتسمع أحاديث الاستقلال، وتلاحظ أن السياسة لا تسكن البرلمان فقط، بل تسكن البيوت، والقلوب، والخوف اليومي. هذا الوعي المبكر جعلها تنظر إلى الأدب لا بوصفه ترفًا، بل بوصفه أداة فهم ومساءلة.
حين دخلت الجامعة، لم تكن قاعات الدرس معزولة عن الشارع. الحركة الطلابية كانت مشتعلة، والأسئلة الكبرى تُطرح بلا إذن. هناك، انخرطت لطيفة في العمل العام، وانحازت إلى فكرة العدالة الاجتماعية، لا من باب الرومانسية الثورية، بل من باب الإحساس بأن الظلم إذا لم يُسمَّ باسمه تمدّد حتى صار طبيعيًا.
كان هذا الاختيار مكلفًا. في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، لم يكن النشاط السياسي طريقًا آمنًا، خصوصًا لامرأة. تعرّضت لطيفة الزيات للاعتقال، وعرفت السجن لا بوصفه حدثًا عابرًا، بل تجربة تُعيد تشكيل الإنسان من الداخل. السجن لم يكسرها، لكنه أزال عنها أي وهم بأن الطريق سهل، أو أن النضال بلا ثمن.
خرجت من السجن وهي أكثر صمتًا، وأكثر عمقًا. لم تعد ترى السياسة في الشعارات وحدها، بل في التفاصيل اليومية، في قدرة الإنسان على أن يحافظ على كرامته وسط القهر. هنا، بدأ الأدب يأخذ موقعه المركزي في حياتها، لا كملاذٍ هروبي، بل كساحة أخرى للمواجهة.
كانت ترى أن اللافتة السياسية تُحرّك اللحظة، لكن الرواية تُحرّك الذاكرة. وأن الأدب — إذا صيغ بصدق — قد يصل إلى أماكن لا تصلها الخطب. بهذا الفهم، كتبت لطيفة الزيات أعمالها، لا لتُرضي أيديولوجيا، بل لتُمسك بتجربة إنسانية معقّدة، مليئة بالتردّد والخسارة والأسئلة.
في عام 1960، نشرت روايتها الأشهر «الباب المفتوح»، التي لم تكن مجرد عمل أدبي، بل شهادة جيلٍ كامل. بطلتها لم تكن امرأة مثالية، بل امرأة تبحث عن ذاتها وسط عالمٍ يضع لها أبوابًا كثيرة، ثم يطلب منها أن تختار بسرعة. في هذا التردّد، وفي هذا القلق، رأى كثيرون أنفسهم.
لم تكتب لطيفة الزيات عن التحرّر بوصفه قفزة واحدة، بل بوصفه سلسلة محاولات، بعضها ينجح، وبعضها ينكسر. كانت تعرف أن الحرية لا تأتي دفعة واحدة، وأن الأبواب المفتوحة قد تُغلق فجأة إذا لم يُحسن العابرون العبور.
في حياتها الشخصية، عاشت لطيفة تناقضًا دائمًا بين الالتزام العام والحاجة الإنسانية للسكينة. تزوّجت، وجرّبت الحياة الزوجية، لكنها لم تجد فيها دائمًا الملاذ الذي يبحث عنه الإنسان. لم ترَ في الزواج خلاصًا ولا قيدًا مطلقًا، بل علاقة تُقاس بميزان العدالة والاحترام، لا بالمسميات.
عملت في التدريس والنقد، وأسهمت في صياغة خطاب أدبي يرى في النص فعلًا اجتماعيًا. رفضت فكرة “الفن للفن”، كما رفضت تحويل الأدب إلى منشور سياسي مباشر. كانت تؤمن بالمنطقة الصعبة بين الاثنين، حيث يكون النص جميلًا، لكنه مسكون بالواقع.
جاءت هزيمة 1967 فكانت صدمة وجودية لجيلها كله. أعادت لطيفة النظر في كثير من القناعات، وكتبت بجرأة عن الأوهام التي سقطت، وعن الحاجة إلى مراجعة الذات قبل مراجعة الخصم. لم تكن الهزيمة عندها نهاية، بل لحظة كشفٍ مؤلمة، لا بد من المرور بها.
في كتاباتها اللاحقة، واجهت نفسها بلا تجميل. كتبت عن السجن، وعن الخسارات، وعن التعب الذي لا يظهر في الصور. لم تدّعِ البطولة، ولم تتبرأ من أخطائها. كانت ترى أن الصدق مع الذات شرطٌ لأي كتابة حقيقية.
رحلت لطيفة الزيات عام 1996، بعد عمرٍ طويل من التجربة والكتابة والمراجعة. لم تُقدَّم كأيقونة سياسية، ولا كرمزٍ نسويٍّ جاهز، لكنها تركت أثرًا أعمق من الرموز: تركت نصوصًا تُذكّرنا بأن المقاومة ليست دائمًا في الشارع، وأن الأدب قد يكون ساحة نضال لا تقل قسوة.
ليست كل المعارك صاخبة، وليست كل الانتصارات مرئية. بعض النساء يغيّرن التاريخ لأنهنّ كتبن بصدق، وتركْن للأدب أن يقول ما عجزت السياسة عن قوله.
هكذا بقيت لطيفة الزيات وجهًا لا يغيب، لا لأنها رفعت راية، بل لأنها فتحت بابًا، وتركت لمن يأتي بعدها أن يختار: هل يعبر، أم يظلّ واقفًا أمامه.