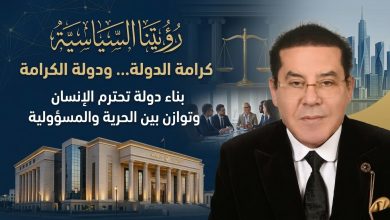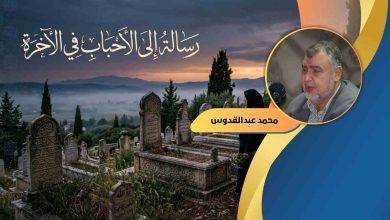المراقب للمشهد السياسي الراهن لا يحتاج إلى عدسة مكبرة ليرى إلى أي مدى تسير الأمور في مسار دائري ممل، يعيد إنتاج الإخفاقات، ويغلفها بشعارات جديدة لا تخدع إلا من يريد أن يُخدع.
نحن لا نعيش لحظة استثنائية، بل نعيش تكرارًا مريرًا لوقائع أليمة، تمت إعادة إخراجها بإضاءة مختلفة، لكنها تحمل نفس العقدة ونفس النهايات، إن لم تكن أكثر عبثية وسخرية.
السلطة التنفيذية تهيمن بشكل مطلق، وما يُسمى بالحياة الحزبية ما هو إلا ديكور هش، يتحرك بأوامر ويصمت بإشارة.
السياق العام لا يوحي بأي نية للتغيير الحقيقي، بل يعكس رغبة محمومة في تثبيت الواقع كما هو، وفرضه على الناس باعتباره “الطبيعي” و”القدر المحتوم”.
ما يحدث اليوم من استعدادات انتخابية ليس بشارة لمستقبل أفضل، بل علامة استفهام حادة حول نوايا تُخاض في الخفاء.
كأننا أمام مشهد تم ترتيبه بدقة، بحيث يبدو ظاهريًا تعدديًا، لكنه في العمق لا يسمح إلا بصوت واحد، ونهج واحد، وتفكير أحادي لا يعترف إلا بالموالاة، ويضع من يخرج عليه في خانة العدم.
كل ذلك يعيد إلى الذاكرة أزمنة كان يُظن أنها انتهت، لكنها عادت بأدوات أكثر تطورًا، وإن بقيت الفكرة ثابتة: إقصاء كل من يملك قدرة حقيقية على التأثير، ومحاصرة أي تيار مستقل يمكن أن يشكل تهديدًا لمعادلة الحكم.
واليوم، تُدار العملية السياسية كما تدار شركة مساهمة، حيث يتم توزيع المناصب والمقاعد وفقًا لمعايير الولاء والصفقات وليس الكفاءة أو الشعبية.
إن القوى السياسية، بأغلبها، أصبحت عاجزة عن المقاومة، لا لضعف إرادتها فقط، ولكن لاهتراء بنيتها، وفقر تمويلها، وتآكل حضورها المجتمعي.
لم تعد تمتلك ما يجعلها رقمًا صعبًا في المعادلة، بل أصبحت مجرد أداة تُستخدم لإعطاء المشهد مسحة من الشرعية الشكلية. لا قواعد جماهيرية حقيقية، لا طرح سياسي قادر على إلهام الناس، ولا مشروع وطني جامع يُقاوِم الاستقطاب أو الاحتكار.
وبدلًا من التفكير في قلب هذا الواقع، نراها تنجرف نحو مساومات صغيرة، تُلبَّى فيها بعض الطموحات الشخصية مقابل الصمت على جملة من الانتهاكات الواضحة للمبادئ السياسية.
يتم الدفع بها نحو المشاركة في استحقاقات لا جدوى منها، يعلم الجميع أن نتائجها محسومة، ومخرجاتها محددة سلفًا.
وبينما تتكرر هذه الحلقة، يبقى السؤال الأهم معلقًا: لماذا يصر الجميع على الدخول إلى نفس المتاهة، رغم معرفة أن لا مخرج فيها؟ لماذا لا يتفق العقلاء على أن الانسحاب من مشهد عبثي قد يكون أبلغ من المشاركة فيه؟
إن الدعوة لوقفة جادة بين من تبقى من الشرفاء في الحياة السياسية لم تعد ترفًا، بل ضرورة وطنية. دعوة تُعلن بوضوح رفض المشاركة في عملية تُدار من فوق، ولا تُنتج سوى مزيد من الإحباط والعزوف الشعبي.
لا بد من بيان صريح، يحمل توقيع من لم تتلوث يده، يضع حدًا لهذه الدوامة، ويُعلن أن الكرامة السياسية لا تُشترى، وأن الشرعية لا تُمنح بل تُنتزع عبر أدوات حقيقية.
لكن، هل نملك من يملك الشجاعة لذلك؟ هل لا يزال بيننا من يؤمن أن الانسحاب من باطلٍ أكرم من المشاركة فيه؟ للأسف، الأمل يتضاءل. المواقف تتبخر. الرجال الحقيقيون يندرون. لا نرى إلا وجوهًا باهتة، صامتة، خائفة، “وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ”.
اليوم، المشهد يتكرر، والفاعل هو ذاته، لم يتغيّر سوى وجه القناع، “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية” يعيدان تدوير نفس السيناريو القاتم، ولكن بشكل أكثر فجاجة. أدوات السيطرة أضحت أكثر تعقيدًا، لكنها أكثر فشلاً أيضًا.
ما يحدث الآن ليس دعوة إلى انتخابات حقيقية، بل إغراء سياسي ملوث يُساق للقوى الحزبية، فتتلقفه كما يتلقف الغريق قشة، رغم علمه أنها لن تنقذه.
هؤلاء يعلمون أن كل الأحزاب مفككة، من الداخل قبل الخارج، وأنها تفتقر إلى التنظيم، وتفتقر إلى الرؤية، وتفتقر –وهنا الكارثة– إلى الظهير الشعبي.
هم يعرفون جيدًا أن هذه الأحزاب تُدار من فوق، بلا قواعد حقيقية، بلا كوادر فاعلة، بلا تمويل مستقل، بلا مشروع وطني أصيل.
يعرفون أن هذه الكيانات خاوية من الداخل، وأن صوتها أعلى من فعلها، وأن قادتها مشغولون بتأمين مكاسب ضئيلة لا تتجاوز مقعدًا هنا أو منصبًا هناك. لذلك تُعرض عليهم الفتات، لأنهم في الأصل لا يملكون من أمرهم شيئًا.
إذن، ما الذي يُراد لنا أن نصدقه؟ أن نخوض انتخابات بقانون مفصل كما تُفصل بذلة لمهرج في سيرك؟ أن نشارك في مسرحية يعرف كاتبها ومخرجها وممولها نهايتها مسبقًا؟ أي عبث هذا؟
أي استخفاف بالعقل الجمعي للمجتمع؟ أي صفاقة في طرح مشروع لا يقود إلا إلى صفر جديد يُضاف إلى أصفار المشهد السياسي المصري؟
الحقيقة المؤلمة أن من ينتظر من هذه الأحزاب أن تصنع تغييرًا، هو واهم. ومن يراهن على نجاحها في دوائر الفردي، رغم علمه بضعفها وهزالها، هو شريك في تضليل الناس.
حتى لو خاضت، حتى لو فازت ببضعة مقاعد، فستكون النتيجة النهائية: صفر كبير، بلا صوت، بلا قدرة على التأثير، بلا معنى.
فما هو الحل؟ هل نكتفي بالبكاء على الديمقراطية المسروقة؟ هل نقف متفرجين على حفل دفن المشاركة السياسية؟ لا، رغم أن الأوان قد فات – أو يكاد – إلا أن خيارًا واحدًا ما زال بإمكانه قلب الطاولة.
إن القُوى السياسية، بكل هشاشتها، وبكل خلافاتها، إن أرادت أن تترك بصمة حقيقية، فلتجتمع، ولتتفق، ولتخرج على الناس ببيان موحد: لن نشارك.
إن المأساة اليوم لا تكمن فقط في التراجع، بل في أن هذا التراجع يُقدم كإنجاز. يتم تزييف الوعي، ويتم الترويج للرداءة كأنها استقرار، وللركود كأنه نضج سياسي. كل ذلك فيما المواطن يدفع الثمن: من قوته، من حريته، من صوته.
لا خلاص بدون صدمة. ولا أمل في التغيير بدون قطيعة مع هذا النمط الممجوج. على من تبقى له قلب ينبض بوطنية حقيقية أن يتخذ الموقف الذي يُسجّل للتاريخ لا للصفقات.
فالهروب من لحظة القرار ليس إلا تمديدًا لمعاناة وطن بأكمله، وتأجيلًا لانفجار قادم إن لم يتم تداركه بالعقل والشجاعة.
التاريخ لا يرحم المساومين، ولا يكتب المجد للمترددين.