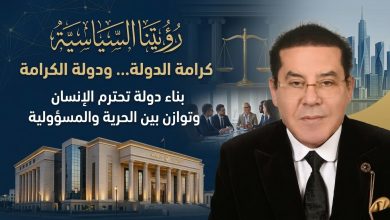شهد الصراع مع المشروع الصهيوني جولات متعدّدة، تراوحت بين المواجهات المسلّحة ومحاولات التسوية السلمية. وتعتبر المواجهة المسلّحة الحالية، التي بدأت منذ انطلاق “طوفان الأقصى” والمستمرّةً، أطول هذه الجولات، وربّما تصبح الأكثر تأثيراً في مسار هذا الصراع في المستقبل. ولكي ندرك عمق التحوّلات الجيوستراتيجية الناجمة عنها، يتعيّن وضعها في سياقها التاريخي الأوسع.
عندما أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل (14/5/1948)، استند آنذاك إلى مشروع التقسيم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمن إقامة دولة يهودية في 56% من فلسطين التاريخية، غير أنه لم يعترف مطلقاً بأن حدود هذه الدولة الوليدة هي النهائية للمشروع الصهيوني، فقد كان بن غوريون يدرك جيّداً أن الحدود النهائية لهذا المشروع لن ترسمها قرارات أممية، وإنما آثار الأقدام فوق كلّ أرض يستطيع الجنود الإسرائيليون أن يصلوا إليها.
وقد تجلّت هذه الحقيقة في أوضح ما تكون في أعقاب كلّ حرب خاضتها إسرائيل منذ نشأتها. ففي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (1984 – 1949)، احتلّت إسرائيل مساحةً جديدةً تعادل تقريباً نصف المساحة المخصّصة لها في مشروع التقسيم، ومن ثمّ أصبحت تسيطر على 78% من مساحة فلسطين التاريخية اعتباراً من 1949، وطردت نحو 700 ألف فلسطيني، تحوّل معظمهم لاجئين في الدول العربية المجاورة.
وفي حرب السويس (1965)، احتلّت سيناء، وحاولت ضمّها، لكنّها تراجعت بسبب ضغوط أميركية مورست عليها لأسباب تتعلّق بموازين القوى في النظام الدولي ثنائي القطبية وبصعود التيّار القومي العربي آنذاك، ما أجبرها على العودة (مرغمةً) إلى حدود 1948، لكنّها استخلصت العبر ممّا حدث، عازمةً على ألا يتكرّر مرّة أخرى أبداً. ومن ثمّ سعت إلى تقوية اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة إلى أقصى درجة ممكنة. لذا، حين تمكّنت في حرب 1967 من احتلال ما بقي من فلسطين التاريخية وهضبة الجولان السورية، وسيناء المصرية، قرّرت ألا تعود أبداً إلى حدود 1949، بعد أن أحكمت سيطرتها على آليات اتخاذ القرار في الولايات المتحدة.
لم تكن إسرائيل راغبةً في التوصّل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين أو مع الدول العربية المجاورة في أيّ مرحلة، فقادتها لم يروا في إقامتها مجرّد حلّ للمسألة اليهودية، أي مكاناً يجنّب اليهود تكرار مآسي الاضطهاد الذي تعرّضوا له في أنحاء متفرّقة من العالم، بصرف النظر عما ينطوي عليه هذا الحلّ من ظلم للفلسطينيين الذين لا ذنب لهم في هذه المآسي، وإنما أرادوها منذ البداية دولةً توسّعيةً قادرةً على التحكّم بمقادير المنطقة.
فلو كانت راغبة حقّاً في التوصّل إلى مثل هذه التسوية، لتحقّق لها ذلك عقب الحرب العربية الإسرائيلية مباشرةً، أي منذ 1949. إذ تثبت وثائق تاريخية عديدة أن الدول العربية كانت جاهزةً آنذاك لتسوية نهائية على أساس قرار التقسيم، مع إدخال تعديلات طفيفة في الحدود على نحو يتيح التواصل الجغرافي المباشر بين مشرق العالم العربي ومغربه.
بل وتثبت أيضاً أن عبد الناصر نفسه كان مستعدّاً للمضي في هذا الطريق، وهو ما بدا واضحاً إبان جهود الوساطة الأميركية في الفترة 1953- 1955. غير أن إسرائيل رفضت بشكل قاطع تسويةً دائمةً تستند إلى خطوط التقسم، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا لشيء، إلا لأنها كانت تتطلّع لالتهام مزيد من الأراضي العربية، وهو ما أتيح لها في حرب 1967. وقد استغلّت إسرائيل الشعارات الديماغوجية التي رفعتها الأنظمة العربية خلال الخمسينيّات والستينيّات، للتظاهر بأنها دولة صغيرة مسالمة محاطة بدول عربية معادية لا همّ لها سوى تدميرها.
قد لا يتوقّف الصراع نهائياً إلا حين تفرض إسرائيل شروطها للتسوية أو تصفّي القضية الفلسطينية
حين قرّر أنور السادات، رئيس أكبر دولة عربية (مصر)، تغيير وجهة السياسة المتعلّقة بإدارة الصراع مع إسرائيل في أعقاب حرب 1973، وصل في محاولاته المستميتة إلى إثبات حسن نيّته إلى حدّ الإقدام على زيارة القدس المحتلة عام 1977، ولاحت فرصة أكبر للتوصّل إلى تسوية نهائية هذه المرّة، خصوصاً أن السادات لم يشترط في ذلك الوقت أن يكون قرار تقسيم فلسطين هو أساس التسوية، وإنما العودة إلى حدود 1967، ما يعني القبول بقيام دولة فلسطينية على 22% فقط من فلسطين التاريخية، بدلاً من 44%، وفق ما يقضي قرار التقسيم.
غير أن إسرائيل رفضت هذا الطرح أيضاً، بل واعتبرته دليل ضعف يعكس خللاً في موازين القوة لصالحها، وليس دليلاً على صدق التوجّه نحو السلام، وبالتالي نجحت في استدراج السادات نحو تسوية منفردة تتيح لمصر استعادة سيناء مؤقتاً، ومنزوعة السلاح أيضاً، إلى أن تتمكّن من فرض تسوية بشروطها على بقية العالم العربي. وتدل مؤشّرات عديدة على أن إسرائيل كانت (ولا تزال) تخطّط لإعادة احتلال سيناء للضغط على مصر وإجبارها على القبول بتهجير فلسطينيي غزّة إليها، وهو الهدف الذي لم تعد تخفيه الآن وتتحدّث عنه علانيةً.
وللتدليل على صيرورة النيات التوسّعية الإسرائيلية، يكفي أن نذكّر هنا بالخريطة التي عرضها نتنياهو أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر/ أيلول 2023، لنكتشف أن حدود إسرائيل اتّسعت لتشمل كلّ الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، وأن هذا السلوك المستفزّ، والمتحدّي، أمام العالم أجمع، حدث قبل أسبوعين فقط من انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.
في سياق ما تقدّم، ليس من المبالغة القول إن عملية طوفان الأقصى بدت حتميةً، وجاءت ردّاً على الاستفزازات الإسرائيلية، التي بدا أنها تغلق أبواب الأمل كلّها أمام الفلسطينيين، وتصرّ على تصفية قضيتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلّة، ولم يدر بخلد أحد في ذلك الوقت أن هذه العملية ستكون بدايةً لجولة صراع مسلّحة جديدة، هي الأطول في تاريخ الصراع، والأكثر تأثيراً في مساره.
مقاومة شعبية أسطورية يمارسها شعب أعزل، ومقاومة مسلّحة تصل إلى حدّ الإعجاز، تمارسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما
تختلف جولة الصراع المسلّح الراهنة عن كلّ الجولات السابقة، ليس لأنها الأطول في تاريخ الصراع فحسب (بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023)، ولكن أيضاً (وخصوصاً) لأن جميع الدول العربية أحجمت عن الانخراط فيها، وأطلقت سلسلة من الديناميكيات التفاعلية التي أفضت في النهاية إلى إقدام إسرائيل على إعلان حرب شاملة على إيران.
فالشرارة الأولى لهذه الجولة انطلقت من قطاع غزّة، حين قرّرت حركة حماس، ومعها بقية الفصائل الفلسطينية المسلّحة، شنّ هجوم مباغت على إسرائيل عبر الحدود مع قطاع غزّة، لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بها، والإمساك بأكبر عدد ممكن من الرهائن، لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبعد أيام قليلة، دخل حزب الله خطّ المواجهة المسلّحة لمساندة الشعب الفلسطيني الذي بدأ يتعرّض لحرب إبادة جماعية، ثمّ دخلت تباعاً فصائل عراقية، تلتها جماعة الحوثي اليمنية.
وحين فرغت إسرائيل من تدمير قطاع غزّة، ومن إسكات حزب الله والفصائل العراقية، وساهمت عملياتها العسكرية المتكرّرة في سورية في إسقاط نظام بشّار الأسد، اعتقدت أن الطريق بات ممهّداً لتوجيه ضربة قاصمة لإيران، التي رأت فيها “رأس الأفعى” التي حان قطعها، والقائد الفعلي لمحور المقاومة الذي حان وقت القضاء عليه بعد النجاح في تفكيكه. ومع ذلك، يلاحظ أنها لم تجرؤ على شنّ الحرب عليها إلا بعد أن ضمنت مشاركة ترامب، الذي يبدو أنه وعد بإنجاز ما لا تستطيع إسرائيل إنجازه.
بعد الحرب على إيران، سيتحوّل الصراع من صراع عربي – صهيوني إلى عربي إسلامي – صهيوني أميركي
صحيح أن الحرب على إيران توقّفت بعد 12 يوماً فقط، لكن حرب التجويع والإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة مستمرّة في ظلّ مقاومة شعبية أسطورية يمارسها شعب أعزل، ومقاومة مسلّحة تصل إلى حدّ الإعجاز، تمارسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من فصائل فلسطينية، ولا تزال جماعة الحوثي قادرةً على إطلاق الصواريخ، ومصمّمة على الاستمرار إلى أن تتوقّف الحرب على القطاع. وصحيح أيضاً أننا قد نشهد هدنة مدّتها 60 يوماً (لم تُعلن حتى لحظة كتابة هذه السطور)، بل ليس من المستبعد تحوّلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما يعني أن عملية إطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن سوف تتوقّف أيضاً في هذه الحالة.
غير أن الصراع سيتواصل، وقد لا يتوقّف نهائياً إلا بتحقّق واحد من احتمالين: الأول أن تتمكّن إسرائيل من فرض شروطها الكاملة والمطلقة للتسوية، وهو ما لن يتم، خصوصاً إذا استمرّت حكومتها الحالية، إلا بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، وبضمّ الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها، ما يعني تصفيةً تامّةً للقضية الفلسطينية، وهو احتمال غير مرجّح، لأنه يتجاوز قدرات إسرائيل الحالية. رغم كلّ ما حقّقته من منجزات عسكرية تكتيكية. الثاني أن رضوخ إسرائيل لمطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة في حدود 4 يونيو (1967)، وهو احتمال غير مرجّح أيضاً، لأنه ليس بمقدور القوى الإقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة، فرضه.
يعتقد ترامب (يبدو أن حلم حصوله على جائزة نوبل للسلام ما زال يراوده) أنه يستطيع إنجاز تسوية تتضمّن؛ وضع غزّة تحت وصاية عربية ودولية لبعض الوقت، بعد نزع سلاح “حماس” وترحيل قياداتها؛ السماح لإسرائيل بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تشمل جميع المستوطنات اليهودية القائمة حالياً، بالإضافة إلى غور الأردن على الأقلّ؛ ووعوداً غامضةً حول إقامة دولة فلسطينية خلال خمس أو عشر سنوات، في كلّ من قطاع غزّة وما تبقّى من الضفة، ولكن بعد إخلائهما من جزء كبير من السكّان.
ولأن حلولاً من هذا النوع يصعب تسويقها عربياً، ويستحيل تسويقها فلسطينياً، فمن الطبيعي أن تؤدّي محاولات فرضها عنوةً، سواء عبر القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية، إلى إثارة مشكلات قد تفضي إلى عدم استقرار المنطقة. لذا فالأرجح ألا تكون جولة القتال الحالية هي آخر الجولات. فالحرب التي شنّتها كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة على إيران ستحوّل الصراع في المنطقة، إن آجلاً أو عاجلاً، من صراع عربي – صهيوني إلى صراع عربي إسلامي – صهيوني أميركي شامل، وهو (إن حدث) سيكون التحوّل الأكثر أهميةً تاريخياً في مسار الصراع.