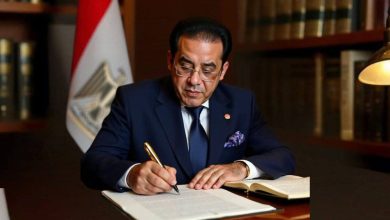لحظة فاصلة… وغضبٌ يبحث عن مخرج
ما نشهده في مصر اليوم ليس أزمة اقتصادية فقط، ولا اضطرابًا سياسيًا عابرًا، بل هو تراكم ممتد لأخطاء منهجية أنتجت حالة وطنية مشحونة، بلغ فيها الاحتقان حدودًا خطرة.
حالةٌ تدفعنا إلى السؤال الأهم:
هل تقترب مصر من لحظة الإفاقة؟ أم أننا نقترب من ساعة الانفجار؟
هذا السؤال لم يأتِ من فراغ، بل من مؤشرات متكاثرة: غضب يتصاعد في الشارع، احتجاجات غاضبة في الخارج، انسداد سياسي، ضيق اقتصادي، وتراجع ثقة غير مسبوق بين الدولة والمجتمع.
وما يزيد من خطورة اللحظة أن أصواتًا من داخل بنية النظام السابق – مثل الدكتور حسام بدراوي – خرجت لتحذر من تكرار نفس الأخطاء التي سبقت انفجار يناير، في رسالة واضحة مفادها:
الطريق ذاته يؤدي إلى النتيجة ذاتها، وربما بأسوأ العواقب.
حين تصبح الدولة غرفة مغلقة
أخطر ما يميز هذه المرحلة أن الدولة لم تعد “مؤسسة جامعة”، بل تتحول تدريجيًا إلى غرفة قرارات مغلقة، لا يدخلها النقد، ولا يخرج منها ضوء.
• المعارضة مُحاصرة،
• الإعلام موجّه أو مُقصى،
• والمجال العام تحوّل إلى فراغ.
أما الشعب، فيُطلب منه الصبر بلا شراكة، والتحمّل بلا أفق، والتصفيق بلا اقتناع.
لكن التجربة تقول: حين يُغلق المجال بالكامل، لا يتبقى سوى الغضب.
والغضب لا يُدار بالإنكار… بل بالاحتواء، وهو ما لم يحدث.
المعصرة… اختراق في جدار الصمت
قبل أيام، اهتزّت الساحة الداخلية على وقع حادثة غير مسبوقة، حين أعلن عدد من الشبان عن اقتحام مكتب أمني داخل قسم شرطة المعاصرة واحتلاله لساعات، في تعبيرٍ غاضب على استمرار غلق معبر رفح وتواطؤ الدولة في حصار غزة.
ورغم النفي الرسمي، فإن تطورات لاحقة – من بينها تغيير مفاجئ في قيادة أحد أهم الأجهزة الأمنية – حملت دلالة لا تخفى:
ما جرى لم يكن مجرد شائعة، بل حدثًا أربك الدولة في العمق، ودفعها إلى إعادة تموضع عاجل.
لا يهم إن كان الاقتحام دقيقًا في تفاصيله أو لا، فالمغزى السياسي أكبر:
أن الغضب الشعبي تجاوز حاجز الخوف، وتسرّب إلى عصب الأجهزة ذاتها.
وهذا مؤشر بالغ الخطورة على تراجع هيبة السلطة في أعين الناس، بل وربما في داخل مؤسساتها.
من الخارج… رسائل لا تقل قوة
ما جرى أمام السفارات المصرية في برلين وطرابلس ولاهاي ليس استعراضًا هامشيًا، بل رسالة عميقة المعنى:
أن الغضب لم يعد محصورًا في الداخل، بل امتد إلى الخارج حيث يتحرر الناس من القيد.
إغلاق السفارات بسلاسل حديدية، أو تقييد بواباتها بأجساد النشطاء، مشاهد تعبّر عن فقدان الثقة التام في تمثيل الدولة، ورفض صريح لسياساتها تجاه غزة.
حين يشعر المصري في الخارج أن سفارته أصبحت بوابة للتواطؤ بدلًا من أن تكون ملاذًا للكرامة، فإن ذلك يعكس فجوة أخلاقية لا يمكن تجميلها بالبيانات.
النظام وتجريف السياسة… الغضب بلا مخرج
المشكلة الأخطر ليست في حجم الغضب، بل في غياب القنوات السياسية التي تستوعبه أو توجّهه.
فالنظام الحالي لم يكتفِ بتجاهل المعارضة، بل قوّض الحياة السياسية من جذورها:
• أحزاب أُفرغت من مضمونها،
• شخصيات وطنية أُقصيت أو سُجنت،
• مجتمع مدني أُخضع بالكامل.
والنتيجة: ساحة خاوية من البدائل، ممتلئة فقط بالاحتقان.
ربما لن يكون الانفجار القادم شبيهًا بيوم 25 يناير، لا لأن الوعي الشعبي تراجع، بل لأن النظام قطع الطريق على التنظيم والتمثيل والتفاوض.
والفوضى حين لا تجد قيادة، لا تصنع التغيير… بل قد تفتح أبواب المجهول.
النداء الأخير… لا لأجل النظام، بل لأجل الدولة
هذا المقال لا يوجّه نداءه لسلطة بعينها، بل يرفع الصوت من أجل الدولة ذاتها.
ما يزال هناك متّسع للتراجع، لكن ليس كثيرًا.
فأعراض الانفجار أصبحت مرئية للجميع، من مراكز الأبحاث إلى المقاهي، من أجهزة الأمن إلى العواصم الأجنبية.
الخيار ليس بين البقاء أو الرحيل، بل بين الاستمرار في المكابرة أو اختيار لحظة مصارحة وطنية تنقذ ما يمكن إنقاذه.
يناير… الذاكرة التي لا تموت
ثورة 25 يناير لم تكن خطأ، بل تعبير عن عمق الأزمة حينها، ومحاولة نبيلة لاستعادة الكرامة والعدالة.
وكل من يسير اليوم في الاتجاه المعاكس، يعيد خلق الشروط نفسها، لكن في سياق أشد قسوة، وأقل قابلية للضبط.
ليس الخطر في أن تكرّر الشعوب ثوراتها، بل في أن تكرّر الأنظمة أخطاءها.
الخاتمة: من يملك القرار… هل يسمع صوت البلاد؟
التاريخ لا يرحم من تجاهله.
والدولة التي لا تسمع دقات التحذير، قد تسمع دويّ الارتطام.
هذا نداء لا استجداء فيه، ولا تحريض، بل توصيف عقلاني للحظة شديدة الهشاشة.
والقرار ما يزال بأيدي أصحاب القرار.
لكن…
هل يختارون البناء قبل الانفجار؟ أم يتركون البلاد للمصير…؟