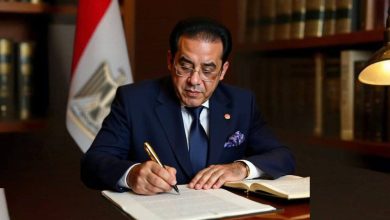تُعلّمنا الحكمة أن ظلم من ظلمك لا يمنعك من العدل والإنصاف والبعد عن الإجحاف بالأحكام المسبقه فالاستعجال بابٌ للزلل، وأن الحقّ حين يُحمَل على الناس دفعةً واحدة قد يتحوّل – بغير قصد – إلى فتنةٍ تدفعهم دفعةً واحدة.
هكذا قال عمر بن عبد العزيز لابنه يوم استعجله في محاربة المنكرات: “لا تعجل يا بُني، فإن الله ذمّ الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملةً فيدفعوه جملة.”
تسكن هذه الكلمات قلبي كلما حاولت أن أفهم علاقة الحكم بالإصلاح، وأن أقرأ طبيعة اللحظات التي تقف فيها الدولة أمام مرآتها، بين شهوة القوة وخوف السقوط، بين رغبة الهيمنة وضرورة التصحيح.
المعارضة الحقيقية لا تُقاس بارتفاع الصوت، بل بقدرتها على أن تقول “نعم” حين تكون “نعم” في مصلحة الوطن، وأن تقول “لا” حين تصبح “لا” واجبًا وطنيًا. ب
ين الحقيقة والأمل، بين الغضب والإنصاف، يمشي المعارض الليبرالي على حافةٍ دقيقة؛ يرفض أن يكون شاهد زور، ويرفض بالقدر ذاته أن يتحوّل إلى قاضٍ يعميه الانتقام عن رؤية ومضة ضوء ولو كانت في آخر النفق.
ذاكرة المصريين تحتفظ بصورة برلمانٍ وُلد سفّاحًا سنة ٢٠١٠، أرادته مجموعة الحكم إعلانًا رسميًا لمشروع التوريث، لا ممثلًا للإرادة العامة.
تتكدس المقاعد تحت راية الحزب الوطني حتى كادت تكتمل، وتتساقط المعارضة من داخل المجلس إلى خارجه، ويعلو صوتٌ واحد يتحدث باسم الجميع.
تبدو الأرقام انتصارًا، بينما كانت أكبر هزيمة أخلاقية لسياسة قررت أن تكسر الصندوق بدلًا من احترام حكمه.
رواية تلك الأيام تقول إن صراعًا صامتًا دار داخل البيت الحاكم: مدرسة الأب ورجال الدولة التقليديون بقيادة اللواء عمر سليمان، ومدرسة الابن التي حمل لواءها تنظيمٌ حزبيّ جديد تقوده عقلية أحمد عز ويباركه طموح جمال وتدفعه رؤية سيدةٍ أولى رسّخت معادلة: التراجع هزيمة، ولو كان في صالح الوطن.
يسقط البرلمان في حضن مشروع التوريث، ويصعد من تحت الرماد سؤالٌ خافت: هل يمكن إصلاح الخطأ قبل أن يتحول إلى كارثة؟
التاريخ غير المكتوب يروي أنّ عمر سليمان قال لمبارك إن البرلمان خطرٌ على النظام قبل أن يكون خطرًا على خصومه، وإن إعادة الانتخابات احترامٌ لمشاعر الناس وحمايةٌ لمستقبل الدولة.
مال مبارك إلى رأيه، ثم تراجع أمام ضغط الأسرة والجناح الجديد. ذهب إلى البرلمان المزوّر ليلقي خطابه الأخير تحت قبته، ثم جاءت يناير كعاصفة أطاحت بالبرلمان وبالنظام معًا.
الدرس يعود اليوم بثوب جديد
بيان رئيس الجمهورية حول ما جرى في دوائر الانتخابات البرلمانية الحالية لا يمكن قراءته خارج هذا الدرس.
اعتراف بأنّ ما حدث يستحق الفحص، وتوجيه لهيئة مستقلة – يفترض أنها كذلك – كي لا تتردد في إلغاء مرحلة أو أكثر إذا استحال الوصول إلى إرادة الناخبين.
من جديد يقف الحكم أمام المرآة، والسؤال معلّق: هل نحن أمام محاولة لتجميل الصورة، أم أمام بداية اعتراف بأن الطريق القديم لم يعد صالحًا للسير؟
الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن صدور البيان خطوةٌ في الاتجاه الصحيح
خطوة تقول إن عبارة “كل شيء تمام” لم تعد قابلة للتسويق، وإن الحديث عن مخالفات لم يعد حكرًا على المعارضة.
والمعارضة لا تشمت حين يعترف خصمها بخطئه؛ ترى في ذلك بابًا يمكن البناء عليه. لذا يحق لنا وصف الخطوة بأنها “صحيحة”، والسكوت عنها نوع من جحود الحقيقة باسم الخصومة.
في الوقت ذاته، الحذر واجبٌ من أن تتحول الخطوة إلى مجرد بيان.
الورقة التي تحمل الاعتراف بالخلل قد تكون شهادة ميلاد لمسار إصلاحي، وقد تكون ورقةً تُطوى في ملفات الدعاية.
الخطر في أن يُعاد إنتاج البرلمان ذاته بوجوه مختلفة وألوان مختلفة، دون أن يمسّ أحد القانون، أو تقسيم الدوائر، أو القواعد التي جرى تفصيلها قبل كل انتخابات على مقاس السلطة.
إصلاح السياسة يبدأ بالاعتراف، لكنه لا ينتهي عنده
الصندوق لا يصبح نزيهًا لأن من في القمة قال “فتشوا عن الأخطاء”، بل لأن القانون يضمن تكافؤ الفرص، ولأن الهيئة المشرفة مستقلة استقلالًا حقيقيًا، ولأن الدوائر رُسمت بمعايير العدل لا بمعايير الحسابات.
الدولة التي تحترم نفسها لا تخاف من قانون انتخاب عادل، ولا من قائمة نسبية تفسح مكانًا لصوت آخر، ولا من طعن قضائي، ولا من منبر إعلامي يقول إن ما جرى لا يطمئن.
الدستور، رغم ما اعتراه من جرح في التطبيق، ما زال ينص على أن المشاركة حق وواجب
حين يصبح القانون أداة للمنع لا للتنظيم، يتحول الصندوق من رمز للسيادة الشعبية إلى صندوق مغلق تُدار نتائجه بعيدًا عن الناس.
للحظة تمتلك خصوصية نادرة. العالم الذي كان يتباهي بحقوق الإنسان فقد مصداقيته على أبواب غزة. الإصلاح اليوم – إذا حدث – لن يُباع على أنه استجابة لضغط خارجي، بل قرارٌ سيادي خالص.
هذه مفارقة تمنح الحكم فرصة نادرة: أن يقول إنه أصلح البيت لأن ضميره الوطني أمره، لا لأن الخارج أزعجه.
من موقع المعارض الليبرالي، لا أُجامِل ولا أُقصي الإنصاف. الخطوة تُحسب لصاحبها إذا تحولت إلى مسار واضح: قانون انتخاب جديد، دوائر عادلة، طعن قضائي مفتوح، وقائمة مطلقة تُطوى إلى الأبد.
وتتحول إلى عبء عليه إذا توقفت عند حدود “قلنا ما علينا” وتركت التفاصيل لآليات اعتادت إعادة إنتاج المشهد نفسه.
التاريخ لا ينسى أن تجاهل نصيحة إعادة انتخابات ٢٠١٠ لم ينقذ النظام، بل عجّل بسقوطه
اليوم نواجه مفترقًا مشابهًا. إمّا أن يكون بيان ٢٠٢٥ تصحيحًا متأخرًا، أو يكون صفحة جديدة في كتاب إنكار صندوقٍ طال اختناقه.
لا أكتب دفاعًا عن شخص ولا هجومًا على آخر، بل دفاعًا عن فكرة: أن يستعيد المصريون حقهم في الاختيار، وأن يُحترم اختيارهم، وأن يصبح البرلمان بيتهم لا بيتًا مُستعارًا.
عندما تتصالح السلطة مع الصندوق، وتدرك أن المعارضة الوطنية صمّام أمان لا مؤامرة، يبدأ الإصلاح الحقيقي.
لعلّ هذا البيان يكون بداية حوار جديد بين الحكم والصندوق، بين الرئاسة والشارع. لعلّه يكون لحظة تراجعٍ عن طريق أثبتت الوقائع أنّ نهايته مجهولة. لعلّه يكون – إن شاء الله – عكس انتخابات ٢٠١٠: خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، بدلًا من خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ. فالأمل ليس ترفًا، بل وقود كل محاولة إصلاحية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يستيقظ التاريخ على صدمة أخرى كان يمكن تفاديها.